التّضامرُ من حيثُ الإجمال
قد تبدأ الومضة الأولى للتفلسف من الدّهشة -كما قال أرسطو- أو من الشّك -كما ذهب ديكارت-؛ ولكنّها قد تنطلق من التساؤل المنبعث من الظّمأ الشّديد للمعرفةِ أو حتّى القلق المعرفي -كما يرى غير واحد من الفلاسفة-. في بعض الأحيان قد ينبعث التّساؤل من دافع خفيّ في الذّات، ربّما يكون مجهول المصدر والغاية، وأيًّا كان الدّافع وراء التّساؤل، ففي كثيرٍ من الحالات يسير بالمرء نحو النّظر إلى إمكانيّة وجود رابطة غير معلنة أو مضمرة بين طائفةٍ مُعّينة من الظّواهر، ثمّ يتدرّج الفعل التفلسفي تصاعديًّا في أثناء محاولات الوقوف على اكتشاف تلك الرّابطة وتفحّص معالم صفاتها، أو خواصها، أو كلّ ما يتعلق بها.
الرّابطة المضمرة الّتي شدّت انتباهي كانت تتعلّق بشيء ما في مسارات التّفكير الإنساني، إذ لاحظتُ أنّه في سياق محاولات الإنسان الوصول إلى الأجوبة عن كلّ ما يُفكّر فيه أو يحتاج إلى معرفته، سواء أفلسفيّة كانت تلك المُحاولات أم دينيّة أم علميّة؛ توجد حالة مُعيّنة يُمكن رصد تكرارها بسهولة إذا ما لفتت الانتباه إليها، وهذه الحالة هي حالة اللااستقرار على النّظرة الّتي يطرحها كلّ نمط من أنماط التّفكير بالاعتماد على نظريّاته أو آرائه أو وجهات نظره أو حتّى معتقداته؛ إذ لا نكاد نجد نمطًا تفكيريًّا لم ينتج أو يكتشف آراء أو نظريّات أو وجهات نظر أو معتقدات أخرى تُخالف أو تباين أو تعارض وربّما تُناقض آراءه أو نظريّاته الّتي سبق أن قالها، وكأنّ التّفكير الإنساني وفي مجالاته أو أنماطه المختلفة لا يتوقّف عن حراك دينامي ينزع نحو الشّيء الآخر دائمًا، سواء أفيزيائيًّا كان ذلك الشّيء أم ميتافيزيائيًّا أم ميتافيزيقيًّا أم غيبيًّا ([1])، فمن البيّن أنّ ما يُكتَشفُ بالفعل يُعاد النّظر إليه مرّة أُخرى، بل –وربّما- مرّات مُتتالية، وكأن المعرفة تتحرّك أُفقيًّا لاكتشاف كلّ جديد، وعموديًّا بتكرار فهم جميع ما اكتُشِفَ بالفعل، وفي كلّ عمليّة إعادة للفهم يحدثُ أن تتزلزل النّظرة الأحاديّة الّتي تعلّقت بالفهم القديم، إذ يصحبها نظائر قد تكون قريبة منها أو بعيدة عنها، فكُلّ الاحتمالات واردة حين يُعاد اكتشاف مستويات أخرى للنّظرة السّابقة.
ولنأخذ علم الهندسة على سبيل المثال، فقد كان الاعتقاد السّائد لعشرين قرنًا خلت وأكثر، أنّ الهندسة الإقليديّة هي: المنطق الرّياضي الوحيد الثّابت والمعبّر عن الكون بكُلّ ما فيه، حتّى ظهرت الهندسة اللاإقليديّة ممثلة بالهندسة الإهليليجيّة وهندسة القطوع النّاقصة في القرن التّاسع عشر ([2])؛ لتغيّر نظرة العلماء والفلاسفة عن علم الهندسة تغييرًا كليًّا، ومن بعد ذلك تتالى ظهور هندسات أُخرى: كالهندسة المطلقة، والهندسة المتقطّعة، والهندسة التّحليليّة، والهندسة الحاسوبيّة، والهندسة التفاضليّة، وغيرها ([3]).
ما يُمكن مُلاحظته هنا، أنّ الهندسات تكتشف أو توضع مع تقدّم الزّمن تبعًا للحاجة المحفّزة على ذلك الاكتشاف أو الوضع، والتساؤل الّذي يحضر في هذا الموضع هو: إذا لم يستطع النّاس أن يتوقّعوا وجود هندسات لا تماثل الهندسة الإقليديّة طوال عشرين قرنًا من الزّمن لأسبابٍ ربّما تكون موضوعيّة، ومنها: أنّ الهندسة الإقليديّة كانت متّسقة مع المستوى المعرفي الّذي كان سائدًا، فضلًا عن بعض المعتقدات الأسطوريّة حولها، أقول: إذا كان ذلك كذلك، وتبيّن لاحقًا أنّ الواقع أعقد ممّا كانوا يظنّون، وأنّ توسّع المعرفة يقتضي الإقرار بأنّ الهندسة الإقليديّة مجرد خطوة في طريق هندسي متعدّد المستويات ومتباين في الاتّجاهات، فهل هناك ما يمنع أن نتوقّع أنّ ما بين أيدينا من هندسات ربّما تُصبح بدائيّة مقارنة بما قد يكون عليه الحال بعد عشرين أو ثلاثين أو أربعين قرنًا من الآن؟
حين أتأمّل هذا التّساؤل أميلُ إلى القول بعدم وجود ما يمنع حدوث مثل هذا الافتراض مستقبلًا، وهنا لا أجد مناصًا من أن أطرح التّساؤل الآتي: فهل تلك الهندسات الّتي ستُكتشف في المستقبل موجودة الآن ولكنّنا لا نستطيع الإحاطة بها علمًا لقصور موضوعي في أدواتنا واحتياجاتنا، وأنّ من سيأتون في المستقبل سيكونون قادرين على اكتشافها أو وضعها كاستجابة طبيعيّة لمبدأ السّنخيّة ([4]) أم أنّها أصلًا غير موجودة؟
عند محاولة الإجابة عن هذا التّساؤل، تتبدّى لي أول ما تتبدّى إشكاليّة الاختلاف في الإجابات أو عدم تماثلها؛ إذ ممّا لا شكّ فيه أنّ بعضهم سيرى أنّ تلك الهندسات المتوقّع اكتشافها موجودة بالفعل سلفًا، ومنهم من سيقول: إنّها ليست موجودة بل ستحدث في حينها إن استحدثت أصلًا، وقد يقول ثالث غير ذلك أو حتّى رابع، في الحقيقة نحن نتوقّع أن نشهد مثل هذا الاختلاف لأنّنا بالفعل نتعايش مع نماذج لا تحصر من مثل ذلك؛ ما يجعل الاختلاف في وجهات النّظر هو لبّ أو جوهر قضيّتنا الّتي نبحثُ في حقيقتها، وهي السّبب العميق الكامن وراء التقلّبات الدّائمة في الآراء ووجهات النّظر.
إنّ ما يترتّب على الاختلاف اللّامنقطع، أوّلًا: تعدّد الإجابات عن السّؤال الّذي يطرح كائنًا ما كان ذلك السّؤال، وثانيًا: عدم القدرة على الجزم أو القطع بإجابة وحيدة على حساب البقيّة إذ لا معيار خارجي مجمع عليه إجماعًا كليًّا أو شاملًا للنّاس جميعًا من أوّلهم وحتّى يومنا هذا، كما لا يتصوّر أن يُخالفه أحد ما بقي أحد من النّاس على قيد الحياة، يرجح ترجيحًا قاطعًا إجابة على أخرى، بل تزخر نماذج المعرفة جميعًا بمعايير متعدّدة، إلّا نسبانويًّا أو اتّفاقات مقترنة بدلالاتٍ محدّدة، وأيّ نسبانويّة أو تحديد يفقد يهبط بمرتبة الإطلاق أو التّعميم درجة، ما يدع الباب مواربًا أمام الاختلاف، وإزاء هذا أراني منساقًا للقول: أيًّا ما كانت الإجابة سواء أنّ الهندسات المستقبليّة موجودة الآن أم ستُبتكر في المستقبل؛ فإنّ ذلك يعني أنّ هناك من الهندسات ما هو مضمر لنا كما كانت الهندسات الّتي نعرفها الآن مضمرة لمن سبقنا.
في مثال آخر، ليس ببعيدٍ عن سابقه؛ قاد (برتراند راسل) ([5]) و(الفريد نورث وايتهد) ([6]) عمليّة تحويل الرّياضيّات إلى منطق، واستخدما في ذلك نظريّة المجموعات ([7])، وبعد جهد متواصل استمرّ أكثر من عشرين عامًا، نجدهما في كتابهما «مبادئ الرّياضيّات»، ينتهيان بعد(362) صفحة من القوانين والنّظريات المنطقيّة المعقّدة إلى إثبات أنّ: (1+1=2)، ولقد كان هذا العمل الجبّار يرمي إلى بناء صرح واحد من الرّياضيّات يُمكن من طريقه الوصول لكلّ الحقائق والنّظريّات الرّياضيّة؛ وبذلك يُمكن الاستغناء عن باقي فروع الرّياضيّات؛ ولكن بعد هذا الجهد وعلى غير المتوقع اكتشف (برتراند راسل) وجود تعارض منطقي، هذا التّعارض ناتج من تعريف المجموعة الّتي تحتوي على نفسها كعنصر من عناصرها، فمثلًا هناك مجموعة تتكوّن من الحروف الأبجديّة (أ،ب،ت، … ي)، الحرف (ب) هو أحد عناصرها، فإذا أضفنا إلى هذه المجموعة عنصرًا جديدًا هو مجموعة الحروف الأبجديّة نفسها؛ أصبحت المجموعة تحتوي على نفسها كعنصر، وهكذا عُدّ استخدام المنطق ونظريّة المجموعات كأساس للرّياضياتِ عملًا غير موثوق به لأنّه يقود إلى تعارض، فظهرت أزمة شكّ في وجود أساس ثابت وصلب للعلوم الرّياضيّة، وقد باءت جميع المحاولات لتعديل نظريّة المجموعات أو لإعادة تعريفها بغية التغلّب على التّعارض المنطقي بالفشل، حتّى كتب (برتراند راسل) يقول: «إنّني أريد الحقيقة المجرّدة الّتي لا تقبل الشّك بالطريقة نفسها الّتي يطلب بها النّاس الإيمان، لقد اعتقدتُ أنّ الحقيقة المجرّدة سوف أجدها في علوم الرّياضيّات؛ ولكنّني اكتشفتُ أنّ الرّياضيّات مليئة بالقصور. فإذا كانت الحقيقة يُمكن اكتشافها من طريق الرّياضيّات؛ فإنّ ذلك سوف يكون بواسطة نوع جديد من الرّياضيّات يُبنى على أساس صلب، وعلى حين العمل نحو هذا الهدف على أشدّه كنت دائمًا أتذكّر قصّة الفيل والسّلحفاة، لقد صنعت فيلًا تستطيع أن تعتمد عليه كلّ الرّياضيّات؛ ولكنّني وجدتُ أنّ هذا الفيل يتأرجح؛ لذلك سندته بسلحفاة حتّى لا يسقط؛ ولكن السّلحفاة نفسها غير مستقرّة مثل الفيل، وبعد أكثر من عشرين عامًا من الجهد الشّاق وصلتُ إلى النّتيجة المرّة، وهي: أنّني لا أستطيع أن أفعل شيئًا يجعل الرّياضيّات حقائق لا يقربها الشّك» ([8])، ولم تسلم الرّياضيّات الكلاسيكيّة (الّتي تعتمد على الأعداد، 1 2 3 …) من التّشكيك، فعلى الرّغم من بداهة إدراكها وكونها لا تحتاج إلى براهين؛ إلّا أنّ عالم الطوبولوجيا ([9]) (بروير) هاجمها بعد أن اكتشف أنّ فيها نظريّات رياضيّة كثيرة غير صحيحة، فمثلًا الأعداد الحقيقيّة إمّا أن تكون موجبة وإمّا سالبة وإمّا صفرًا؛ ولكن (بروير) أثبت وجود عدد حقيقيٍّ، ليس موجبًا أو سالبًا أو صفرًا، وانتهى في العام(1353هـ/1934م) إلى القول: «النظرية الّتي يثبت صحّتها بالتجربة، يُمكن القول إنّها صالحة حاليًّا ولا يعنى هذا أنّها حقيقة مؤكدة»، الأمر الّذي أحدث ثورة في فلسفة العلوم.
إنّ هذه التصدّعات في صرح الرّياضيّات وإن كانت خافية على عموم المتعلّمين أو المشتغلين بالعلم؛ إلّا أنّها موجودة بالفعل، بصرف النّظر عن تجاهلها أو السّكوت عنها، وما نقرأه فيها هو أنّها تُنبّئ بقصورها الحالي وبوجود مضمر أتمّ وأكمل ينبغي السّعي إلى اكتشافه، والنّقطة الجوهريّة الّتي نُشدّد عليها هنا هي أنّ هذا القصور ينُبّئنا أنّ الأتمّ أو الأكمل الّذي قد يُكتشف مستقبلًا؛ سوف لن يكون بعيدًا عن القصور الّذي وجدناه في سابقه، وبتعبيرٍ آخر: لا يوجد ما يطمئننا أنّ رياضيّات المستقبل سوف تكون مطلقة اليقين وبلا ثغراتٍ بنسبة مئة بالمئة، وعلى ماذا يدلّ هذا التوقّع؟ يدلُ على أنّ كلّ ما يُكتشف يُنبّئ بوجود مُضمر أفضل أو أسوأ، وهكذا دواليك.
بالمثل حين نلاحظ –مثلًا- التّبدل في الأفكار في علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا)، حيثُ كانت النّظرة العلميّة للعقل في القرن التّاسع عشر تتمحور حول ماديّة التّفكير والأفكار، بمعنى أنّ الأفكار -كما يَذكر عالم الأحياء هكسلي([10])– الّتي يعّبر عنها بالنّطق «هي عبارة عن تغيرات جزيئيّة»([11])، أي أنّ العقل منبثق من المادّة، وهذا يعني من جملة ما يعنيه أنّ الإنسان معدوم الإرادة، إذ أنَّ إرادته عبارة عن تغيرات ماديّة في الدّماغ، وقد عبّر (و. ك. كليفورد) أحد علماء الرّياضيّات عن هذه الفكرة بإيجاز فقال: «إذا قال أحد إنّ الإرادة تؤثّر في المادّة فقوله ليس كاذبًا فحسب، وإنّما هو هراء»([12])، فكانت النّظرة ماديّة بحتة، ولما جاء القرن العشرون وتوسّعت الاكتشافات خلص مؤسّس فيسيولوجيا الأعصاب الحديثة السير (تشارلز شرنغتون) ([13]) إلى أنّ هناك فرقًا جذريًّا بين الحياة والعقل: «فالحياة هي مسألة كيمياء وفيزياء، أمّا العقل فهو يستعصي على الكيمياء والفيزياء»([14]). ويعني بالحياة الإشارة إلى التّغذيّة الذّاتيّة واستقلاب الخلايا (الأيض) والنّمو، وهذه ظواهر تتمّ بواسطة قوانين الفيزياء والكيمياء، أمّا أنشطة العقل فهي خارج إطار هذين العلمين. من هنا تبيّن للعلماء أنّ النّظرة الماديّة وحدها لا تستطيع أن تُفسّر الإدراك الحسيّ، لأنّ الإدراك الحسّي بحسب النّظرة الجديدة حقيقة لا ماديّة ولا من خواصها ([15]). فإن تساؤلانا يتواصل مع سابقه ليستحضر ذات الإجابات.
تتكرّر الفكرة في الفلك، فقد تغيّرت نظرة الإنسان إلى الكون المحيط به تغيّرًا جذريًّا بظهور الثّورة الكوبرنيكيّة ([16]) في أوروبا الّتي بيَّنت أنّ الأرض لم تعد هي المركز كما كان يَعتقد العلماء من قبل، بل هي كوكب صغير يدور حول نفسه وفي الوقتِ نفسه حول الشّمس ([17]).
وفي الفيزياء، كان كثير من العلماء اللّامعين مثل (تومسون) ([18]) قد آمنوا إيمانًا أعمى بالسّمة المطلقة لميكانيك نيوتن الّذي دافع عنها حتّى يوم وفاته([19])؛ ولكن تكشَّف فيما بعد أنّ ميكانيك نيوتن هي في الجوهر علم نسبانوي([20])، الأمر الّذي قَلب فكرة تقديم الفيزياء على أنّها علم ثابت لا يتغيّر رأسًا على عقب، إذ وبالضّد من بعض العلماء رأى أينشتاين أنّ الفيزياء علم دينامي وتاريخي، وكتب في هذا السياق: «إنّ ملاحظاتنا للواقع الفيزيائي لا يُمكن أن تكون نهائيّة أبدًا، يجب أنْ نكون مستعدين دائمًا لتغيير هذه الملاحظات-أو ما نسميها بالقاعدة البديهيّة للفيزياء- في سبيل الوصول إلى الحقائق بأفضل الطرائق المنطقيّة، والواقع أن نظرة سريعة على تطوّر الفيزياء تُظهر لنا حدوث تغيرات عديدة وواسعة مع مرور الزّمن»([21]).
وفي الفلسفة نجد أنّ المذاهبَ الفكريّة تتخالف تخالفًا لافتًا، ومن ذلك على سبيل المثال: المذهبين الكلاسيكيين اليونانيين المادي الحسّي والمثالي العقلاني، فقد انقسم فلاسفة اليونان قبل أرسطو إلى فريقين: الفريق المادّي الحسّي بدأ من طاليس (وهو من أوائل الفلاسفة الطبيعيّين) واستمرّ حتّى السّفسطائيين. والفريق المثالي العقلاني بدأ من فيثاغورس (الفيلسوف وعالم الرّياضيّات الشّهير) وحتّى سقراط وأفلاطون، والتّاريخ الفلسفي يسطر لنا تخاصم الفريقين على طول الخط، الماديون الحسيون كانوا يرفضون أيّ حديث حول ما وراء هذا العالم الطّبيعي ويحاولون فقط تفسير العالم من داخل العالم الطبيعي المادّي عن طريق الحواس الّتي عدّوها هي الأصلح لجميع المعلومات عن هذا العالم، أمّا المثاليون فقد شكّكوا في حقيقة هذا العالم المحسوس وعدّوه على أحسن الفروض –كما عند أفلاطون- مجرّد ظل لعالم مفارق هو العالم المعقول (عالم المثال)؛ وعلى هذا شكّكوا في أهمية الحواس ورفضوا أن تكون أداة صالحة للوصول إلى الحقيقة واعتمدوا اعتمادًا كليًّا على العقل([22]).
ورغم اختلاف الرّأي بين أنصار الاتّجاهين بل وبين أنصار كلّ اتجاه منها؛ إلّا أنّ القاسم المشترك الّذي جمع فلاسفة ذلك العصر هو اعتزازهم الشّديد بقيمة العقل، وذات الاعتزاز نجده حاضرا وبقوّة بين اتّجاهين فلسفيّين كبيرين في القرنين السّابع عشر والثّامن عشر وهما: الاتّجاه التجريبي الّذي أقرّ الاستقراء التجريبي كمنهج للعلوم الطّبيعيّة، وقد دُعم هذا الاتجاه الّذي بدأه (بيكون) في فلسفات كلّ من (توماس هوبز) و (جون لوك) و (ديفيد هيوم) وغيرهم من الفلاسفة الإنجليز، والاتّجاه العقلي الّذي أرسي دعائمه ديكارت وتطوّر على يد الكثيرين من تلامذته والمعجبين بفلسفته أمثال: مالبرانش، واسبينوزا، وليبنتز، وغيرهم.
أقول: إنّ كان الجميع لا يُجادل في أهميّة العقل؛ إلّا ربّما في التّقديم أو التّأخير، بل إنّ بعضهم غالى في الإعلاء من قدره، حتّى تصوّروا أنّه بإمكان العقل الإنساني أن يصل بمعارفه اليقينيّة إلى ما لا نهاية، وأنَّ بإمكانه تجاوز هذا العالم المحسوس ليصل إلى معارف ما وراء هذا العالم، ومن جهة ثانية نظروا إلى العالم الطّبيعي على أنّه عالم التّغير والمادّة المحسوسة فقط، ولا يشتمل على الكلّي أو الضّروري، وهما الصّفتان اللّتان تميّزان المعرفة العقليّة، فإنّ الفيلسوف الشّهير كانط جاء في كتابه «نقد العقل الخاص» ما يُبيّن تهافت هذين الأمرين، فذهب إلى أنّ للعقل الإنساني حدودًا ينبغي إلّا يتجاوزها وإلّا غاب اليقين وضاعت الحقيقة، وبشأن القضية الأخرى فقد أكّد لنا أنّ العالم الطّبيعي ليس كما يتصوّر غالبيّة الفلاسفة العقليّين خاليًا من القوانين العقليّة الضّرورية والكليّة، بل أنّه مليء بهذه القوانين الّتي يقع على العقل مهمة اكتشافها ([23]).
هكذا نجد ذات الأمر من التقلّبات بين القول والنّقد؛ فالإتيان بالمختلف الّذي يتمثّل في كثيرٍ من الحالات بالمناقض أو المعاكس تتكرّر في العلوم الطّبيعيّة أو الاجتماعيّة أو السّياسيّة أو الاقتصاديّة، وبالتأكيد في التّفكير الدّيني والأدبي والفنّي وسائر المجالات الّتي يبرع فيها التّفكير الإنساني.
من هنا لاح لي أنّ تلك التقلّبات في التّفكير الإنساني هي أشبه ما تكون بظاهرة مشتركة في جميع الأنماط التفكيريّة، ومعنى وصفها بالظّاهرة، هو إمكانيّة مراقبتها ورصدها بعد ملاحظتها كما يحصل في الظّواهر الطّبيعيّة الّتي يدرسها العلم ([24])؛ ولكنّها تتعلّق هنا بمعنى خاص قريب ممّا ذهب إليه (كانط) ([25]) وهو العلاقات الّتي تحدّدها المقولات أو الأفكار العقليّة ([26]).
إنّ ظهور آراء متعدّدة لاحقة تختلف عن السّابقة وفي أيّ مجال من مجالات التّفكير، وعدم الاستقرار على قرار، شاء العلماء والفلاسفة والمفكرون ذلك أم أبوا، أثار في ذهني زوبعة من التّساؤلات عن سبب ذلك، أيّ لماذا كلّما قال فريق بمبدأ أو نظريّة أو قانون وتمسّكوا به، أتى غيرهم بما يخالفه أو يناقضه أو يباينه أو ما شابه ذلك، سواء في العصر نفسه أم فيما يليه من عصور؟ ولو أنّنا تتبّعنا الإجابات عن سبب الاختلاف لسوف نجد أنّها بدورها مختلفة. يبدو من هذا أنّه يصعب الوقوف أو الوصول إلى حدّ محدّد بهذا الشّأن، وممّا نخلص إليه ممّا تقدّم هو: أنَّ الاختلاف وبما تتضمّنه هذه الكلمة معنى واسع ومتّسع في المستويين المعرفي (الأبستمولوجيا) والوجودي (الأنطولوجي).
كان عليّ أن أرتّب المعطيات الّتي توصلت لها بالوجهِ المُبيّن –اختصارا- في الآتي:
(1) ما طبيعة علاقة الاختلاف في الأفكار والنّظريّات والآراء …إلخ، هل التّعاكس أم التّناقض أم التباين أم التّشابه أم التّناظر أم التّعارض … أم ماذا؟
قرأتُ كلّ واحدة من هذه العلاقات على حدة، فوجدتُ أنّ كلّ واحدة منها قاصرة عن أن تكون مُعبرة أو مُلّمة بالصّورة الشّاملة في حالتيها المجملة والمفصّلة، أو المجزأة والكليّة، أو المتفرّقة والمجتمعة. فعلى سبيل المثال لو افترضنا أنّ الاختلاف ينتج بسبب تضمن كلّ شيء لحالة التّعاكس، فهل تستطيع هذه العلاقة أن تُغطّي جميع مظاهر الاختلاف الّتي نعرفها؟ في الحقيقة نحن نعلم أنّ الاختلاف لا يشترط أن يكون ناتجًا عن التّعاكس، فقد يكون متّجه اليمين (→) عكس متّجه اليسار (←)؛ ولكنّه ليس عكس متّجه الشّمال (↑) أو متّجه الجنوب (↓) بل يُمكن القول إنّ متّجه اليمين لا يعكس متّجه الشّمال أو الجنوب أو أيّ متّجه آخر سوى اليسار، ما يعني: أنّ علاقة التّعاكس لا تُعبّر عن جميع الاحتمالات الممكنة، وكمثال في الفيزياء، فإنّ نظريّة النّسبيّة لا تُعاكس نظريّة نيوتن بل تختلف عنها. وفي مجال العواطف الإنسانيّة فإنّ الحب إذا كان عكس الكره فإنّه لا يُعاكس المودّة أو حتّى اللّاحب أو اللّاكراه وهي الحالة الحيادية الّتي لا نكنّ فيها مشاعر اتّجاه من لا نعرفهم من النّاس، وفي العقائد إذا كان التّوحيد (الإيمان بإله واحد) عكس الشّرك (الإيمان بآلهة متعدّدة)؛ فإنّه ليس عكس الكفر؛ لأنّ الكافر قد يكون مؤمنًا باله واحدٍ ولكنّه لا يُؤمن بالنّبي الجديد أو بشيءٍ ممّا جاء به. وإذا كان التّنافر عكس التّجاذب فإنّه ليس عكس حالة انعدام الجاذبيّة الّتي تطفو فيها الأشياء … وهكذا. يُمكن ملاحظة شواهد لا تحصر جميعها تعطينا تصوّرًا واضحًا بأنّ علاقة التّعاكس علاقة جزئيّة أو علاقة تنجح في حيّز محدود أو ضمن مجال معيّن أو عندما تقترن بما أسمّيها: (دلالة محدّدة).
ماذا لو افترضنا أنّ التّناقض هو العلاقة العامة الشّاملة؟ سنجد أنّ علاقة التّجاذب أو الحبّ أو التّكامل أو حتّى علاقة التّعاكس تخالفها، والأمر ينطبق على جميع العلاقات الأخرى، إذ ما إن تمسك واحدة حتّى تجدها مخصّصة في حيّز محدّد، وهناك الأحياز الأخرى الّتي لا تُماثلها، هذا سوى ما فيها من تداخل أو تخارج أو تكامل، فعلى سبيل المثال: الإنسان يُشبه الإنسان بدلالة الشّكل العام مثلً؛ ولكنّه قد يختلف عنه في التّفاصيل كالطّول أو اللّون أو الوزن أو ما لا يحصر من ذلك من الاختلافات، وقد يتشابهان في الفكر لكن قد يختلفان في الرّأي، وقد يتباين الذّكر عن الأنثى في الجنس ولكن قد لا يتباينان في العناصر البيولوجيّة. على هذه الشّاكلة يُمكن أن نجد جميع الاحتمالات الممكنة موجودة فيما بين هذه العلاقات.
في تلك القراءة كنت ألتمسُ الطّريق للقبض على وصفٍ يمكنه أن يستوعبَ جميع هذه العلاقات استيعاب مفهوم اللّغة لكلماتها؛ إذ عندما نأخذ أيّ كلمة على حدة، أو نأخذ مجموعة كلمات أو كلّ الكلمات؛ فإنّ جميع تلك الاحتمالات تكون مستوعبة في لفظ اللّغة استيعابًا كليًّا. فسؤالي كان، ما ذلك الوصف الّذي يُمكن بواسطته أن نعامل جميع أنواع العلاقات كاحتمالاتٍ ممكنة مستوعبة فيه؟
بعد التّفكير، تقرّر لديّ أن وصف (اللاتماثل) سيكون مناسبًا لهذا الغرض، فحين أقول مثلًا: متّجه اليمين لا يُماثل كلّ من اليسار والشّمال والجنوب والشّمال الشّرقي والجنوب والغربي وغيرها، فإنّ هذا التّوصيف يستوعب أو يتضمّن التّعاكس والتّخالف والتّناظر وغيرها. وحين أقول: إنّ منظور النّسبيّة لقوانين الطّبيعة بطريقة لا يُماثل منظور ميكانيكا الكوانتم لها؛ فإنّ ذلك لا يشتمل على مفهوم التّناقض لمن يقرأ العلاقة بينهما وَفْقَ دلالاتٍ معيّنة على أنّها تناقض، إضافةً إلى أنّه يشتمل بالقوّة ذاتها على التّباين لمن يريد قراءة العلاقة بينهما وَفْقَ دلالاتٍ أخرى، وحين أقول: إنّ عقيدة التّوحيد لا تماثل عقيدة اللّاتوحيد، فهذا يتضمّن الشّرك والكفر والإلحاد واللّادين، وبوجهٍ عامة: رأيتُ أنّ المفهوم الأعم القادر على لملمة المتفرّقات، والاشتمال على توصيف متكوثر للصّورة الكبيرة هو مصطلح (اللاتماثل) بوصفه معبرًا عن جميع الاحتمالات الممكنة، فتقرّر لديّ كمعطى أساسي من المعطيات الّتي يجب أن أعتمدها.
(2) القضيّة الأخرى الّتي لاحظتها، هي أنّه -وفي مُستوى المعرفة الإنسانيّة أو كما تُسمّى فلسفيًّا نظريّة المعرفة أو الأبستمولوجيا- لا يوجد رأي معزول عزلًا مُطلقًا -أي من جميع الجهات- عن الاقتران برأي أو أكثر من الآراء المقابلة الّتي لا تماثله. فإن قيل: هناك خير، فهذا يعني أنّ هناك شرًّا، وهناك ما هو لا خير ولا شر أيضًا. وإن قيل: الأرض مركز الكون، فهذا يعني أنّ هناك رأيًا لا يُماثله يقول بلا مركزيّة الأرض للكون، ورأي آخر بنسبويّة مركزيّة الأرض بحسب مرجع الإسناد الفلكي، فقد تكون مركزًا وقد لا تكون. وإن قيل: الحقيقة لا تُغادر المادّة الملاحظة أو آثارها القابلة للقياس، فإنّ هناك رأيًا آخر يقول: بل إنّ المادّة أحد وجهين للحقيقة، والثّاني هو الجانب الرّوحي، ويأتي رأى ثالث ليقول: الحقيقة أنّ المادّة والرّوح وكلّ شيء مجرّد أوهام لا حقيقة لها. وإن قيل: (أنا أفكّر إذن أنا موجود)، يأتي من يقول لا مثيل ذلك كأن يقال: (أنا أفكر إذن أنا غير موجود) ([27]). وهكذا، حين نتتبّع أيّ ما يُمكن أن يُفهم أو يُقال أو يتصوّر، فإنّنا سنجد هناك الفهم أو القول أو التصوّر الّذي لا يُماثله.
هذا الأمر جعلني أذهب إلى إثبات اللّاتعازل بين اللّامثيل ولا مثيله إثباتًا تلازميًّا، بمعنى أنّه وبمجرّد أن أتلقّى معرفة بشيء، فإنّ تلك المعرفة -كما تخبر بوجودها بوجهٍ مُعلن – تنبئ بوجود لا مثيلها وجودًا واقعيًّا أو افتراضيًّا أو متوقّعًا بوجهٍ مستتر أو مضمر. وقد رأيت أن أُطلق على المثيل أو المعرفة المُعلنة مصطلح (المُظهر) على حين أطلقتُ على ما يستحضره ذلك المظهر من احتمالاتٍ ممكنة لا تماثله مصطلح (المضمر) ([28])، وعلى جُملة عمليّة الفهم هذه مصطلح (التّضامر).
(3) وَفْقَ ما تقدّم، يُمكنني القول: إنّ الفكرة العامّة للتّضامر يُمكن صياغتها بالوجه الآتي:
وجود أيّ شيء أو فكرة أو نظريّة أو رأي أو وجهة نظر أو اعتقاد ولنرمز له بالحرف (أ) يُضمر الدّلالة على وجود عدد مفتوح من الاحتمالاتِ الممكنة (ب + 1)، وتلك الاحتمالات بمنزلة قوّة المتّصل من الكيانات ([29])، وجميعها لا تماثل (أ) أي (لا أ).
ويُمكن التّعبير عن ذلك بالرّموز كالآتي:
(أ) يضمر (لا أ)، أي (أ) يضمر جميع الاحتمالات الممكنة الّتي لا تماثله.
ولمّا كان (لا أ) = (ب + 1) حيثُ إنّ (+1) يرمز إلى بقاء باب الاحتمالات الممكنة مفتوحًا إزاء التوقّعات أو التّخمينات؛ فإنّ صيغة العلاقة تُصبح:
(أ) يضمر (ب + 1)
وهنا احتجتُ إلى رمز ليعوّض عن كلمة (يضمر) في العلاقة الرّمزيّة، ولمّا لم أجد؛ ابتكرتُ رمزًا له دلالته الموضوعيّة الّتي تتناسب مع مضمون التّضامر وأبعاده وهو الرّمز (ı|) ([30])، لتكتب العلاقة بالصّورة:
أı| لا أ = أı| (ب + 1)
(4) سؤال: وَفْقَ منظور التّضامر كيف يُمكن قراءة العلاقة بين ثلاثيّة العلم والدّين والفلسفة؟
الجواب: يُمكن صياغة العلاقات بالصّورة الآتية:
العلم ı| لا العلم
أي العلم يضمر لا مثيله بدلالة نظريّة المعرفة.
ولما كان (لا العلم) يحتمل الدّين والفلسفة؛ لأنّ كلًّا من الدّين والفلسفة لا يماثل العلم؛ فإنّ العلم يضمر الدّين والفلسفة.
بالمثل يُمكن استنتاج أن:
الدّين يضمر العلم والفلسفة.
الفلسفة تضمر العلم والدّين.
النتيجة أنّ العلاقة بين العلم والدّين والفلسفة هي علاقة تضامر، ولما كان التّضامر يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة، فهذا يعني أنّ كلّ ما يُمكن تصوّره من علاقاتٍ معروفة كالتّناقض واللّاتناقض والتّعاكس واللّاتعاكس والّتباين واللّاتباين والّتعازل واللّاتعازل والّتكامل واللّاتكامل والتّضاد واللّاتضاد والّتعارض واللّاتعارض وما إلى ذلك من العلاقات، جميعها ممكنة وقائمة بالفعل بين هذه النّماذج المعرفيّة الثلاث وفي الوقتِ نفسه.
(5) عطفًا على النّتيجة السابقة، لنا أن نتساءل: كيف يُمكن أن تكون جميع الاحتمالات الممكنة بين العلم والدّين والفلسفة قائمة في الوقتِ نفسه، إلّا يستدعي ذلك التّناقض؟
لمّا كنتُ أعلم أنّ قوانين المنطق الأرسطي ([31]) تمنع القبول بإمكانيّة أن تجتمع جميع تلك الاحتمالات في الوقتِ نفسه؛ فإنّي لاحظتُ أنّ حقيقة ذلك المنع مشروطة بأن يكون اجتماع تلك الاحتمالات مقترنة بوجهٍ محدّد بعينه، فإن انتفى هذا الشّرط انتفى المنع بدوره. ومَثل ذلك كمثل إمكانيّة أن أتصوّر أنّني أب وابن وجد وأخ وعم خال وابن عم وابن خال وصديق وزوج وغيرها من العلاقات الاجتماعيّة في الوقتِ نفسه، ولكن قطعًا ليس من وجهٍ وحيد، بل كلّ واحدة من هذه العلاقات مقترنة بوجهها الخاص بها، أو كما أسمّيها مقترنة بـ (دلالة محدّدة). فأنا أب بدلالة ابني، وابن بدلالة أبي، وجد بدلالة حفيدي، وأخ بدلالة إخواني… وهكذا. هذا ممكن تصوّره ولكن ما لا يُمكن تصوّره أن أكون أبًا وابنًا بدلالة ابني حصرًا مثلًا، فأنا أب له فقط، أما بُنوتي فمرتبطة بدلالٍة محدّدة أخرى وهي: أبي.
الدّين مثلا يُمكن أن يكون متناقضًا مع العلم بدلالة الميتافيزيقيا أيضًا؛ ولكنّه لا يتناقض معه في قضيّة التّصديق بالوجود المادّي مثلًا، وقد يتناقض مع الفلسفة بدلالة الاقتصار على العقل كأداةٍ للمعرفةِ، ولكنّه لا يتناقض معها بدلالة الوجود لذلك العقل، فالتناقض لا هو مطلق ولا هو غير مطلق، بل تتحدّد قيمته من حيثُ الوجود واللّاوجود بحدود الدّلالة المحدّدة. وهكذا تُقرأ جميع الاحتمالات الممكنة الأخرى من تعاكس أو تعارض أو تعاضد أو تكامل أو ما شابه ذلك.
ما نستنتجه من ذلك أنّ العلاقات بين اللّامتماثلات- ولكونها تتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة- يشترط بها أن تكون مقترنة بالدّلالة المحدّدة دائمًا، وقد وضعتُ هذا الرّمز (← د) ليعبّر عنها؛ ما يعني أنّ علاقة التّضامر تصبح بالصّيغة:
أı| لا أ ← د أو أı| (ب + 1) ← د
وفيما يلي تلخيص لطريقة كتابة علاقة التّضامر وقراءتها بالرّمز والنّص:
| أ ı| لا أ | العلم ı| لا العلم | العلم يضمر اللاعلم |
| أ ı| (ب + 1) | العلم ı| الدّين + الفلسفة +1 | العلم يضمر الدّين والفلسفة |
| أ ı| (ب + 1) ← د | العلم ı| (الدّين + الفلسفة +1) ←الميتافيزيقيا | العلم يضمر الدّين والفلسفة بدلالة الميتافيزيقيا |
(6) استدعت الدّلالة المحدّدة استحضار مفهوم (النّسبانويّة) وهو مقابل منحوت من مصطلح النّسبيّة؛ ولكنّه يتميّز عنه بخصائص مفهوميّة، ومنها: أنّه لا يقتصر على الذّاتيّة وَفْقَ المبدأ السّفسطائي القائل: إنّ (الإنسان مقياس كلّ شيء) ([32]) فما هو خير لك قد يكون شرًّا لي، بل إنّ النّسبانويّة مرتّبة بدلالة يُمكن وصفها بأنّها (ذاتموضوعيّة)، حيثُ يتم اختيار الدّلالة من الذّات ابتداء ثمّ يجري اعتمادها كواقع موضوعي يحتكم الجميع إليه وَفْقَ مبدأ (الحسّ المشترك).
مثلًا، عندما نُريد أن نعرف فيما إذا كان العلم والدّين متناقضين، فإنّه يجبُ علينا استحضار دلالة محدّدة (أو مجموعة دلالات)، نقرأ وَفقًا لها حقيقة هذا الأمر. فإذا اخترنا مثلًا الميتافيزيقيا كدلالة، فهذا الاختيار هو ابتداء اختيار ذاتي؛ لأنّ الذّات أرادت أن تعرف الحقيقة وَفقًا له؛ ولكن ما اُختير ليس ذاتيًّا، أي: ليس نابعًا من الذّات كشعورٍ وجداني خاص، بل هو أمر موضوعي مشترك يتناقش حوله كلّ من العلم والدّين إثباتًا أو نفيًا. بعد الاختيار يأتي التّحليل والمقارنة والنّقاش وَفقًا له، فلا نقول إنّ العلم والدّين متناقضان أو العكس لأنّنا نعتقد بذلك أو لأنّ ذلك وجهة نظرنا؛ بل لأنّ القراءة وَفْقَ الدّلالة تقتضي أن نثبت التّناقض أو ننفيه، فإذا ما ثبتت لدينا قيمة الدّلالة المحدّدة وكونها وسطًا (ذاتموضوعيًّا) في القضيّة موضع الدّراسة، فإنّ الخطوة اللّاحقة تقتضي القيام بما يشبه عمليّة الضّرب (×) في الرّياضيّات، بأن نُسقط تلك الدّلالة على جانبي النّفي والإثبات؛ وذلك لكي يكتسب كلّ من الطّرفين وضعًا نسبانويًّا، وكما موضّح في الآتي:
الدّين (يتناقض لا يتناقض – نسبانويًّا) مع العلم بدلالة محدّدة.
فلو افترضنا أنّ الدّلالة المحدّدة هي: القول بالوجود المادّي فهما لا يتناقضان، ولو افترضنا أنّ الدّلالة المحدّدة قضيّة وجود الرّوح -مثلًا- فإنّهما يتناقضان؛ لأنّ العلم لا يقول بها، فالعلاقة بينهما من حيثُ التّناقض تعتمد نسبانويّتها على الدّلالات المحدّدة.
(7) في ظلّ هذه الرّؤية، ما الكيفيّة الّتي نرى بها المسافة المعرفيّة بين الثّلاثي: الدّين والفلسفة والعلم؟ عندما يتحدّث العلم عن كشوفاته وتجاربه فلا يكون للنّص الدّيني إلّا الموافقة، وعندما يتحّدث الدّين عن الغيبيّات فلا ينبغي للعلم إلّا الّصمت، وعندما تتحدّث الفلسفة عن قيمة الجمال مثلًا، فلا ينبغي للعلم أو الدّين الاعتراض؛ ولكن ما الّذي يعنيه ذلك؟
يعني أنّ هناك مسافةً معرفيّةً بين هذه الثّلاثة يجب إلّا نتجاهلها، وهذا المسافة لا تمتدّ في الطّول أو العرض أو العمق بل في البُعد، إذ الوحي بُعد غيبي مفارق، والتّجربة بُعد حسّي مُدرك، والوعي بُعد عقلي متصوّر؛ ولأنّ هذه النّماذج المعرفيّة الثّلاثة تمثّل أبعادًا بينيّة؛ فإنّ حضور أحدها يستلزم بطبيعته غياب النّموذجين الآخرين، فإن دخل العالم إلى المختبر لإجراء تجربة فلا دين ولا فلسفة، وإن قرأ المؤمن آية فلا علم ولا فلسفة، وإن استعان المفكّر بأدوات المنطق العقلي، فلا دين ولا علم. ما يحصل في هذه الحالات هو التمثّل لحالة استقلال كلّ واحد منها عن الآخرين؛ ولكنّه ليس استقلالًا مطلقًا، بل نسبانويًّا؛ لأنّها -وكما ذكرنا- ليست بمتعازلة تعازلاً كليًّا، بل الأصح القول متتامة تتامًّا مطلقًا نسبانويًّا، وما نعنيه بالتتام هنا هو: المبدأ الّذي صاغه (نيلز بور) في الفيزياء.
(7-1) في ربيع عام 1927م، تقدّم الفيزيائي (نيلز بور) بـ (مبدأ التّتام complementarity) كحلًّ لإشكاليّة التّناقض في البنية الذّريّة بين الجسيميّة والموجيّة، فقد انتهى إلى عدّ الصّورة الجسيميّة والصّورة الموجيّة كمظهرين متتامين لواقع واحد، أي: أنّ أيًّا من هذين المظهرين ليس سوى جزءٍ غير كامل من الحقيقة، وأنّه يوجد –بالضّرورة- حدود لاستخدام المفهوم الجسيمي تبدأ عندها حدود استخدام المفهوم الموجي، وأنّ التّغاضي عن هذه الحدود يقودُ إلى تناقضات لا خلاص منها ([33]). في خريف ذلك العام تم الاعتراف علميًّا بهذا التّفسير أو التّأويل، واشتهر باسم: تفسير أو تأويل كوبنهاغن.
إنّ مفاد التّتام -كما ذهب إليه بور- هو: أنّ معرفة جوانب منظومة ما تحول دون معرفة جوانب أخرى من هذه المنظومة، وقد يعمّم هذا المبدأ فيكون كلّ شيء خاضعاً لهذه المثنوية بما في ذلك نحن البشر، كالّذي حاول تعميمه (بور) على عددٍ من الدّراسات غير الفيزيائية، ومنها تطبيقه على الكائن الحي في علم الحياة (البيولوجيا)، فهو يعني في هذا التّطبيق: أنّ معرفة الكائن الحي بكليته لا بدّ من أن تحجب عنّا معرفة أجزائه الخلويّة، والعكس صحيح أيضًا[34]. يُمكن التّعبير عن هذا المبدأ بالصّيغة: (إذا كان (أ، ب) مظهرين لواقع واحد هو (د) على التّتالي فإنّهما متتامان).
على هذا وبحسب هذا المبدأ يتحتّم القصور في معرفتنا بأيّ شيء، فنحنُ أشبه ما نكون إزاء ما يسمّى بصور الخداع البصري الّتي تعطي أكثر من صورة في حالاتٍ مختلفة، وكلّما ركّزنا على صورة محدّدة اختفت عنّا الصّورة الأخرى، والعكس صحيح أيضًا. وبهذا فإنّ هناك وجهين مختلفين لحقيقة ما عليه الواقع والوجود، أو يُمكن القول: إنّ الحقيقة الكونيّة متعدّدة ولكنها لا تُظهر هذا التعدّد، بل تُظهر شيئًا وتُخفي شيئًا آخر، ومن المحال أن تتمظهر بكمالها كليّة، وهو يذكّر بمقالات بعض العارفين. من ذلك ما اعتقد ابن عربي من أنّ النّاس يُشاهدون العالم ويؤمنون بالله غيبًا، خلافًا للعارفين الّذين يشهدون الله ويؤمنون بالعالم غيبًا ([35]). فكلّ منهما يمتثّل صورة غير الأخرى، أو أن كلًّا منهما يتعامل مع إحدى الصّورتين كظاهر، ومع الأخرى كمختبئ ([36]).
الحقّ أن ابتعاد العلماء عن النّص الدّيني وابتعاد رجال الدّين عن النّص الفلسفي، وابتعاد الفلاسفة عن التّجارب العلميّة والنّصوص الدّينيّة، يكشف بجلاء عن هذه الطّبيعة التتامية فيما بين النّماذج الثّلاثة، وهذه الطّبيعة تدلّ على أمرين جوهريين:
الأوّل: أنّ الحقيقة لا يُمكن مصادرتها من قبل نموذج وحيد على حساب النّموذجين الآخرين. بل لا بدّ من أخذ التّتام في الاعتبار، والشّأن في هذا كالشأن في الطّبيعة الذّريّة، إذ لا يُمكن فهمها على أنّها جسيميّة فقط أو موجية فحسب، بل لا بدّ من أخذ الوجهين معًا لتكتمل الصّورة ([37])، والشّأن في معرفة الكلّ والأجزاء في البيولوجيا، ومعرفة العالم والله في التصوّف أيضًا.
الثّاني: أنّ الحقيقة جامعة في ذاتها للوحدة والكثرة، للفرق والجمع، للتعدّد والتوحّد، للتّمايز والتّشارك، للفصل والوصل، للمظهر والمضمر، وعلى الجملة للحالة ولا مثيلها.
(7-1-1) كانت هناك عادة جرت في جامعة موسكو، يطلب فيها من الفيزيائيّين حين يزوروها أن يكتبوا على لوح أسود توصية للأجيال القادمة، ولما زارها نيلزبور كتب: «إنّ المتعارضات ليست متناقضات، بل متتامات» ([38])، ملخصًّا بذلك مبدأه القائل بـالتتامية.
(7-1-2) حين نتمعن في مفهوم التّتام نجد بينه وبين التّضامر عدد من التوازيات، وهي:
ثنائيّة (جسيم – موجة) في البنية الذّريّة // ثنائيّة (مظهر -مضمر) في التّضامر.
الجسيم والموجة لا متماثلين // المظهر والمضمر لا متماثلين.
الحالة الجسمية تعكس وجود الحالة الموجيّة // المظهر يعكس وجود المضمر.
(8) الحقل المتضامر أو الواقع الثّالث أوالأبستطولوجيا، هو البُعد أو الحالة الّتي نعبّر فيها عن مرتبة تلك الحقيقة المتضامرة في ذاتها، وهي تأتي لتحيط بالوجود الفيزيائي والميتافيزيائي الّذي يقول به العلم، والوجود الرّوحي والغيبي الّذي يقول به الدّين، والوجود المفاهيمي والميتافيزيقي الّذي تقول به الفلسفة إحاطة شاملة أو كليّة أو مطلقة، ولقد كانت الإشارة إلى هذا الواقع حاضرة في مختلف أدبيّات النّماذج المعرفيّة، إمّا بالتصريح وإمّا بالتّلويح، وكلّ من تحدّث عنه أو أشار إليه، عرّضتهُ أفكاره إلى جملة من خصائصه وصفاته بحسب الدّلالة المحدّدة الّتي استخدمها في منظوره ذاك، ومنها على سبيل المثال:
(8-1) كان أفلاطون يرى العالم عالمين، عالم لا حسي مفارق هو عالم المثل، وهو الّذي توجد فيه حقائق أي مُثُل كلّ ما في العالم المحسوس، وعالم مادّي هو عالمنا الأرضي الّذي عدّهُ أفلاطون مجرد ظلّ للعالم المفارق، والفرق بينهما أنّ المفارق موجود في الخارج ولكن يُمكن إدراكه بالعقل لا بالحواس؛ ولذا يطلق عليه عالم المعقولات أيضًا. إنّ المثال هو: تلك الحالة الكليّة لكلّ نوع من الأشياء في العالم المحسوس سواء أماديًّا كان أم معنويًّا، فمثال الإنسان -مثلًا- هو تلك الحقيقة الكليّة الّتي تجمع الصّفات المشتركة بين جميع البشر في هذا العالم. ولما كانت هذه الفكرة ذاتها (فكرة الإنسان) غير موجودة في هذا العالم المحسوس بل الموجودة فقط في أنا وأنت من الأفراد، فقد افترض أفلاطون أّن هذا المثال وغيره من المُثُل إنّما توجد في ذلك العالم المفارق ([39]).
لو عرضنا هذا المنظور على التّضامر، لرأينا وكأنّما أفلاطون يقول: إنّ الحقيقة الأبستطولوجيّة عبارة عن واقعين: واقع مُظهر ملموس نتعايش معه بحواسنا، وواقع مضمر لا حسّي نتعقّل وجوده بأفكارنا، وفي هذه الحالة فإنّ النّماذج المعرفيّة والموجودات الكونيّة هي نسخ لا محدودة العدد، يُعاني كلّ منها القصور الذّاتي عن الحالة المثلى المضمرة، وما يُمكن أن يُستنتج من هذا بأنّ المضمر هو أشمل وأعم من المُظهر، الّذي يصفه أفلاطون بالظّلّ عن الأصل، ومن جانب آخر فإنّ الواقع الثّالث لدينا هو مجموع العالمين في حالة تتام، والنّسبانويّة المعرفيّة تتبدّى حين يركّز فريق على العالم المحسوس دون المعقول كما في النّظرة الماديّة، أو المعقول دون المحسوس كما في النّظرة المثاليّة، والّذي سنجد أثر له في فلسفة أرسطو.
(8-2) لما جاء أرسطو حاول أن يُفسّر العالم بواسطة المادّة والمثال معًا؛ ولذلك ابتدع في فلسفته مصطلحين مُهمّين هما: «الوجود بالقوّة» و«الوجود بالفعل» أو المادّة والصّورة، وكان ذلك بمنزلة ردّ فعلٍ على تركيز الماديّين قبله على العناصر الأربعة وما يطرأ عليها داخل العالم من تغيير مُستمرّ، نافين أن ثمّة جوهرًا ثابتًا لكلّ شيء لا يطرأ عليه أيّ تغيير؛ على حين ركّز المثاليّون على إدراك ذلك الجوهر الثّابت في كلّ الأشياء وردّه إلى جوهر واحد أعمّ وأشمل وهو الإله الّذي أدرك وجوده كلّ من سقراط وأفلاطون وأنّه مفارق ومبدع لكلّ ما في العالم؛ فذهب أرسطو مذهبًا توفيقيًّا بأنْ شدّد على أنّ حقيقة الشّيء جامعة لهما، فلا تنفصل المادّة عن الصّورة أي لا تنفصل العناصر الماديّة الّتي يتكوّن منها الشّيء عن ماهيّته الثّابتة الّتي لا تتغيّر مهما طرأ على مادّته من تغيرات. سقراط –مثلًا- هو سقراط سواء أدركناه في طفولته وحجمه الصّغير أم عرفناه شيخًا كبيرًا، والكرسي هو الكرسي حيثُ إنّ ماهيّته ثابتة مع أنّه يُمكن أن يكون مصنوعًا من الخشب أو الحديد أو من أيّ مادّة أخرى؛ ما يعني أنّ كلّ شيء يجمع بين الثّابت وهي الماهيّة (الصّورة) والمتغيّر وهي المادّة (علّة تكوينه)، وقد عبّر أرسطو عن هذين الأمرين بمستويين من الوجود للشّيء وهما: وجود الشّيء بالقوّة، أي: وجوده كمادّة فقط، وقبل أن تتّخذ هذه المادّة صورة معيّنة، ووجود الشّيء بالفعل، أي: بعد أن تتحوّل هذه المادّة فتأخذ صورة معيّنة نعرف بها الشّكل النّهائي لهذا الشّيء. الخشب –مثلًا- مادّة تُمثّل مجرّد استعداد وإمكانيّة (أي تمثّل وجود بالقوّة) لأشياء عديدة مثل الكرسي والمنضدة والسّرير … إلخ، وبمجرّد أن يتدخّل الصّانع ليصنع من هذا الخشب كرسيًّا مُعيّنًا فإنّ هذه المادّة تتحوّل من مجرّد استعداد وإمكانيّة (أي وجود بالقوّة) إلى شيء محدّد فعلًا (أي وجود بالفعل) وهو وجود الكرسي، فكلّ ما في العالم إنّما هو مادّة وصورة؛ ولكن إلّا توجد مادّة بلا صورة أو صورة بلا مادّة؟ نعم، توجد في نظر أرسطو مادّة بلا صورة؛ ولكنّها المادّة القديمة الّتي يُسمّيها باصطلاحه «الهيولى الأولى» وهي: مادّة نستطيع أن نستدلّ على وجودها فقط، من دون أن نراها. يوجد صورة بلا مادّة أيضًا، وهي لا بدّ من أن تكون صورة أعلى مفارقة لهذا العالم الطّبيعي تمامًا؛ لأنّها الصّورة الّتي بلا مادّة، ولا بدّ من أن تكون صورة الصّور أو ماهيّة الماهيّات أي مبدعة الماهيّات، ولا شكّ في أنّ تلك الصّورة الخالصة من أي مادّة إنّما هي: صورة الإله ([40]).
حين نُقابل بين هذا المنظور الأرسطي وبين المنظور التّضامري بإمكاننا استنتاج ما يأتي:
- أنّ وجود الشّيء بالفعل يُقابل المظهر، ووجود الشّيء بالقوّة يُقابل المضمر.
- حين نأخذ الشّيء في حالة وجوده بالقوّة كالخشب مثلًا، وكون ذلك الوجود هو استعداد وإمكانيّة لعدد غير منته من الصّور الّتي يُمكن تركيبها من ذلك الوجود؛ فإنّ هذا يُعطينا تصوّرًا بأنّ المضمر هو عدد غير محدّدٍ من الاحتمالات الممكنة، شريطة أن نعلم أنّ إطلاق الاحتمالات الممكنة هو إطلاق نسبانوي، مقترن بدلالة الإمكانيّة الّتي يستطيع الخشب إنتاجها فحسب؛ إذ إنّ توقّع أن ينتج من الخشب كرسي من الحديد مثلًا، هذا يُعدّ احتمالًا غير ممكن وَفْقَ الدّلالة الأرسطيّة لأنّه يُخالف مبدأ السنخيّة الفلسفي. ولما كان مثل هذا الاحتمال ممكنًا وَفْقَ المنظور الدّيني ضمن مبدأ المعجزة، فإنّ مفهوم الوجود بالقوّة عند أرسطو يُعاني من قصور ذاتي، يُمكن تجاوزه في التّضامر حين تتوسّع دائرة الإمكانيّة إلى تلك الحالة الّتي يحتمل فيها أنّ أيّ شيء يُمكن أن ينتج أيّ شيء آخر. وما يحدّد ما يُمكن أن ينتقل من الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل هو الدّلالة المحدّدة، أيّ: بدلالة النّموذج الفلسفي أو النّموذج الدّيني.
- عندما يتحوّل الشّيء من الوجود بالقوّة إلى الوجود بالفعل، كأن يتحوّل الخشب إلى كرسي مثلًا؛ فإنّ جميع الإمكانات الأخرى تنهار وتتلاشى في خشب ذلك الكرسي، فقد أخذ الصّورة الحسّيّة، وهو يذكّرنا بانهيار الاحتمالات الكموميّة حينما تُقاس سرعة الإلكترون أو موضعه، إذ قبل القياس جميع الاحتمالات للسّرعة والتّموضع ممكنة، وما إن يتمّ القياس حتّى يتحدّد شيء بذاته وتنتفي البقيّة الباقية؛ ولكن لما كان التّضامر يفترض أن أيّ فكرة يُمكن أن تضمر لا مثيلها، فإنّ احتماليّة اللاانهيار ستبقى قائمة نسبانويًّا.
- غطّت نظريّة أرسطو الاحتمالات الآتية: صورة بلا مادّة، ومادّة بلا صورة، ومادّة فقط، وصورة فقط، فإن كانت الحالة الثّالثة تعبر عن الأنطولوجيا والأبستمولوجيا في حالة التّراكب؛ فإنّ الحالتين الأولى والثّانية مضافًا إليها الثّالثة تعبّر جميعها عن طبيعة الواقع الثّالث الأبستطولوجي الّذي يُمكن أن تتماهى فيه الأبستمولوجيا في الأنطولوجيا، فلا يعود بالإمكان تمييز إحداهما عن الأخرى إلّا من حيثُ التّتام.
(8-3) على أنّنا نعتقد أنّ الرّؤية الأقرب إلى توصيف الخصائص الأبستطولوجيّة للواقع الثّالث، يُمكن أن نجدها في مفهوم البَرْزَخ وَفْقَ المنظور المبهر للعارف الصّوفي الكبير ابن عربي؛ إذ أخذ ابن عربي هذا المصطلح بالمعنى الدّيني المعروف في الحقل الإسلامي وذهب به بعيدًا.
معنى البَرْزَخ في الفهم الإسلامي العام هو: العالم المتوسّط بين الدّنيا والآخرة، وما فعله ابن عربي أنّه ذهب إلى تعميم هذا المعنى بحيث أصبح دالًّا على حقيقة أو مرتبة جامعة فاصلة في الوقتِ نفسه بين عالمين أو حالين أو مرتبتين أو صِفتين … هما في الواقع متناقضتان، وقد استفاد ابن عربي صفته (الفاصلة) من المعنى اللّغوي للكلمة، وأضاف صفته (الجامعة) الإيجابيّة الّتي انفرد بها، فالبرزخ عنده يُقابل الطّرفين المتناقضين بذاته، يجمع في ذاته حقيقتهما ويقابلهما بوجهيه دون أن ينقسم بل يبقى في وحدته. يقول ابن عربي: «بين كلّ موطنين من ظهور وخفاء يقع تجلي برزخي … ليحفظ هذا البرزخ وجود الطّرفين، فلا يرى كلّ طرف منها حكم الطّرف الآخر، والبرزخ له الحكم في الطّرفين… فالعالم بين الأبد والأزل: برزخ به انفصل الأبد من الأزل، لولاه ما ظهر لهما حكم ولكان الأمر واحدًا لا يتميّز» ([41]).
لن نستطيع أن نُعدّد البرازخ عند ابن عربي -كما ترى الدّكتورة سعاد الحكيم- فهذا ما لا يُمكن أبدًا؛ لأنّ البَرْزَخ عند ابن عربي هو كلّ جامع فاصل بين مطلق أمرين: فعالم المثال برزخ بين عالم الأرواح المجرّدة وعالم الأجساد، وعالم النّبات برزخ بين الحيوان والمعدن، والنّفس برزخ بين حكمي الفجور والتّقوى وهكذا؛ ولكن لعلّ (حقيقة الإنسان) هي من أهمّ أنواع البرازخ الّتي يقول بها ابن عربي؛ وذلك لأنّه يرى أنّ هذه الحقيقة جمعت بذاتها الصّورتين: الحقيّة والخلقية، فكانت نسختين ذواتي نسبتين، نسبة تدخل بها إلى الحضرة الإلهيّة، ونسبة تدخل بها إلى الحضرة الكونيّة، فهي مرتبة الإنسان الكامل، لكونها برزخًا بين العالم والحقّ، أي: أنّ البرزخيّة هنا وظيفة الإنسان الكامل، الحدّ الجامع الفاصل بين الظّاهر والباطن، بين الحقّ والخلق ([42]). يقول ابن عربي: «إنّ الحضرة الإلهيّة على ثلاث مراتب: باطن وظاهر ووسط، وهو ما يتميّز به الظّاهر عن الباطن وينفصل عنه، وهو البرزخ، فله وجه إلى الباطن ووجه إلى الظّاهر، بل هو الوجه عينه فإنّه لا ينقسم، وهو الإنسان الكامل أقامه الحقّ برزخًا بين الحقّ والعالم فيظهر بالأسماء الإلهيّة فيكون حقًّا، ويظهر بحقيقة الإمكان فيكون خلقًا» ([43]). والمقصود بالكمال هنا، هو التفوّق الحاصل في الإنسان نسبة لباقي الكائنات.
إلى ذلك، فإنّ النّقطة الّتي تهمّنا كثيرًا في أطروحة ابن عربي حول البرزخ هي خصائص ذلك البرزخ وصفاته، وهي كما مبينة أدناه:
الأولى: متوحّد الذّات
يرى ابن عربي أنّ البرزخ غير متكثر في ذاته، «فالبرزخ الحقيقي الّذي عرّفنا إيّاه الحقّ تعالى في قوله: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيَانِ} ([44]) هو الّذي يلتقي ما بينهما بذاته، فإن اِلتقى الواحد منهما بوجهٍ غير الوجه الّذي يلقى به الآخر فلا بدّ من أن يكون بين الوجهين في نفسه برزخ يفرق بين الوجهين حتّى لا يلتقيان فإذًا ليس ببرزخ، فإذا كان عين الوجه الّذي يلتقي به أحد الأمرين الّذي هو بينهما عين الوجه الّذي يلتقي به الآخر فذلك هو البرزخ الحقيقي فيكون بذاته عين كلّ ما يلتقي به فيظهر الفصل بين الأشياء والفاصل واحد العين، وإذا علمت هذا علمت البرزخ ([45]) ما هو» ([46]). وهذا يعني أنّ البرزخ الحقيقي كما يصفه ابن عربي هو الّذي يكون متوحّد الذّات يقابل بها الطّرفين، وعمليّة توسّطه بين المتقابلات أو المتناقضات لا تعني أبدًا مواجهة لكلّ منهما بوجه يختلف عن الآخر. فلو قابل البرزخ الطّرفين بوجهين مختلفين لتطلّب ذلك وجود وسيط رابط بين وجهي البرزخ، أي برزخًا بينهما، وهذا البرزخ بدوره يحتاج إلى برزخ بداخله إلى ما لا نهاية له، وهو أمر بخلاف ما عليه الواقع، فطبيعة البرزخ كما يفهمها ابن عربي تقتضي أن يكون حقيقة معقولة واحدة في ذاتها تجمع خصائص المتقابلات بذاتها وتفرق بينهما بذاتها أيضًا، فالبرزخ لا يؤدّي وظيفة الوجهين للعملة الواحدة –كما يقال– بل يُمكن القول: أنّه يُؤدّي وظيفة المرآة الّتي تُواجه كلّ ما يقابلها بما يناسبه.
الثّانية: منع البغاء
البرزخ عند ابن عربي هو الوسيط الجامع للبحرين بذاته الفاصل بينهما بحيث لا يتصل (يبغي) أحدهما على الآخر، أي أنّه يحفظ التّمايز الحاد والفرق الوجودي بين البحرين، واللّذان يُشيران -من النّاحية التّأويليّة عند ابن عربي- إلى بحري الوجود والعدم ([47]). إذ عنده «ما من متقابلين إلّا بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر الّذي به يقع التّمييز، فهو الحال الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم، فإنّ نسبته إلى الوجود وجدت فيه رائحة لكونه ثابتًا، وإنّ نسبته إلى العدم صدقت؛ لأنّه لا وجود له، ثمّ إنّ هذا البرزخ الّذي هو الممكن بين الوجود والعدم سبب نسبة الثّبوت إليه مع نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته» ([48]).
الثّالثة: التعدّد الفائق
إنّ توحيده للمتقابلات بذاته لا تكون بطريقة صناعيّة تمزج بينهما كما يمزج اللّون الرّمادي بين الأبيض والأسود، بل يفعل ذلك بذاته فهو الأبيض بذاته، وهو عينه الأسود بذاته «فما من متقابلين إلّا بينهما برزخ لا يبغيان، أي لا يوصف أحدهما بوصف الآخر، الّذي به يقع التميز … فهو كالحدّ الفاصل بين الوجود والعدم، فهو لا موجود ولا معدوم، فإنّ نسبته إلى الوجود وجدت فيه منه رائحة لكونه ثابتًا، وإنّ نسبته إلى العدم صدقت لأنّه لا وجود له» ([49]).

المثال الّذي يضربه ابن عربي لتوضيح هذه الخاصيّة هو مثال (الحقيقية الإنسانيّة) في الإنسان، فهذه الحقيقة واحدة بذاتها في بني آدم كلهم إلّا أنّ معطياتها تختلف من إنسان لآخر، حتّى ليوصف أحدهم بناءً عليها بأنّه كامل في الوقتِ الّذي قد يوصف غيره بأنّه كالأنعام أو أضلّ سبيلا. الفارق بين الاثنين أنّ معطيات هذه الحقيقة في أحدهم تختلف عن معطياتها في الآخر تبعًا لطبيعة الشّخص نفسه، إنّ مثل الإنسانيّة هنا كمثل الطّاقة الكهربائيّة الّتي هي واحدة في ذاتها ولكن آثارها مختلفة تبعًا لنوع الجهاز الّذي تحلّ فيه، فآثارها في المكواة مثلًا حيثُ تتحوّل إلى طاقة حراريّة تختلف عن آثارها في المصباح الّذي تتحوّل فيه إلى طاقة ضوئيّة؛ ولكن الطّاقة الأصليّة واحدة في ذاتها. وذات الأمر ينطبق – كما يقول ابن عربي- على البياض أيضًا، فهو واحد بذاته ولكنّه يظهر في كلّ أبيض بوجه يختلف عن الآخر ([50]).
إنّ هذه الحقائق البرزخيّة الوحيدة في ذاتها لا يُمكن أن تكون موجودات حسيّة ماديّة عينيّة، وإنّما هي أمور تعلم بالعقل ولا يُمكن مشاهدتها بالعين أو إدراكها بالحواس، ولهذا يصف ابن عربي البرزخ بأنه: يُعقل ولا يشهد ويُعلم ولا يدرك؛ أي: أنّ البرزخ هو حضرة تتوسّط بين حضرتين بالمعنى العقلي لا بالمعنى المادّي المحسوس، وهذه هي طبيعته الخاصّة.
الرّابعة: الواصل الفاصل
من خصائص البرزخ أنّ وظيفته تكمن في الفصل بين الأمرين، والتوسّط بينهما في الوقتِ نفسه، فهو يؤدّي وظيفتي الوصل والفصل في آن، وبهذا الفكر تكون طبيعة البرزخ الوجوديّة طبيعة غير محسوسة أو ملموسة لحواسنا، بل هي طبيعة معقولة.
هذا المعنى لمعقوليّة البرزخ تفسّر الطريقة الّتي بواسطتها استطاعت رؤية ابن عربي أن تتجاوز إشكاليّة التّداخل بين الكثرة بالمعنى الحسّي، على سبيل المثال فإنّ العقل البشري يمكنه أن يتخيّل النّيران كما يمكنه أن يتخيّل البحار، وطبيعة الخيال هنا لكونها معقولة فإنّها لا تتناقض مع العالم المحسوس أو لا تُؤثّر فيه، بمعنى أنّ الشّخص المتخيل لا يحترق بالنّار ولا يغرق بالبحار، فحيّز التخيّل واحد، والأمور المتخيّلة متناقضة، ولا تأثير لشيء في آخر، ولو كانت الصّور الخياليّة ذات طبيعة محسوسة وليست معقولة لكانت النّتائج المترتّبة على ذلك ممّا يصعب تصوّره، إذن ما دامت الطّبيعة البرزخيّة معقولة فبعدها الوجودي ينفي أي كثرة حقيقيّة بالمعنى المادّي العيني المحسوس.
تحليلنا المُقارن بين برزخ ابن عربي والواقع الثّالث في التّضامر كالآتي:
أوّلًا: مقولة إنّ البرزخ يجمع بين الطّرفين النّقيضين بذاته، بحيث لا يرى كلّ طرف منها حكم الآخر، تتضاهى مع أخذنا بمبدأ التّتام القاضي بأنّ الطّرفين المتناقضين ضمن الاحتمالات الممكنة (أقصى اليمين وأقصى اليسار) لا يلتقيان، إن حضر أحدهما غاب الآخر. وإن أردنا أن نحصل على قيمة تكامليّة فعلينا التّنازل عن الوقوف في أحد الطّرفين، علينا أن نتحرّك خطوة إلى العالم المتوسّط أو البيني أو الثّالث.
(8-3-1) ما يترتّب على هذه الخطوة بدلالة المُقابلة مع الطّرف الآخر احتمالان: إمّا أنّ الطرف الآخر لا يخطو خطوته بدوره، وهنا فإنّ الأوّل يتفهّم الثّاني دون أن يتفهّم الثّاني الأوّل، وإمّا أن يخطو الثّاني خطوته، فيلتقي الطّرفان فيتحوّل الأمر من التّفهم إلى الفهم، كلّ منهما يفهم نفسه بنفسه وفي الوقتِ نفسه يفهم نفسه بالآخر؛ لأنّه حينئذٍ يكون لكلّ منها حالة واحدة ذات وجهين متتامين.
(8-3-2) وَفقًا للفقرة السّابقة، فإنّ التّتام يحدث في حالتين: حالة الانفصال ونسمّيه (تتام المنفصلات) وحالة اللّاانفصال ونسّميه (تتام اللامنفصلات). الحالة الأولى تحدث حين نقرأ النّظرة الأحاديّة ولا مثيلها بدلالة النّقيض، والنّتيجة تكون مقترنة بالتفهّم، أمّا الثّانية فتحدث القضايا الّتي لا تتّسم بالقطع أو الجزم الأحادي، وتمتلك أدنى درجات الاحتمال أو النّسبانويّة، والنّتيجة تكون مقترنة بالفهم.
ثانيًا: يرى ابن عربي أنّ البرزخ غير متكثر بذاته؛ لأنّه (إذا قابل البرزخ الطّرفين بوجهين مختلفين لتطلب ذلك وجود وسيط رابط بين وجهي البرزخ، أي برزخًا بينهما، وهذا البرزخ بدوره يحتاج إلى برزخ بداخله إلى ما لا نهاية له، وهو أمر بخلاف ما عليه الواقع) بينما نرى أن الأبستطولوجيا (متكثرة لا متكثرة – نسبانويًّا) بدلالة الذّات، ولنا في افتراض أنّ التكثر احتمال ممكن حجّتان: أولهما: أنّ مجرّد وجود القابليّة الذّاتيّة على مواجهة المختلفات بأوجه مختلفة هي: دلالة ذاتيّة على احتمال التكثر. فمثلًا: H2O هو H2O في الماء والثّلج والبخار، وهنا صحيح أنّ الذّات واحدة وهي H2O وهي تقف على مسافة واحدة من تلك الحالات الثّلاثة؛ ولكن لمجرد ظهور ثلاث حالات فهذا يعني أنّ تلك الذّات قابلة للتكثّر نسبة لعنصر خارجي يواجهها، وهو في هذا المثال، شدّة الأواصر الكيمائيّة. وثانيهما: أنّنا نفترض أنّ اللّانهاية جزء لا يتجزّأ من الوجود، وليس علينا استثناؤها لأنّها موجودة كالجاذبيّة شئنا ذلك أم أبينا، ومن هنا فلا مشكلة عندنا أن تضمن البرزخ برزخًا إلى ما لا نهاية.
ثالثًا: يرى ابن عربي أنّ البرزخ حقيقة معقولة ومعقولة فقط، على حين ترى الأبستطولوجيا أو الحقل المتضامر حقيقة (معقولة لا معقولة – نسبانويًّا)، وما نعنيه بـ (لا معقولة) أي أنّها يُمكن أن تكون ذات طابع أنطولوجي وليس أبستمولوجيًّا فقط. حجّتنا بشأن هذه الإمكانيّة العديد من الظّواهر الكوانتمية الّتي كان يعتقد أنّها لا يُمكن أن تحدث إلّا في الخيال؛ ولكن وفي ميكانيكا الكم فإنّ احتمال وجود الجسيم في أكثر من موضع ليس أمرًا عقليًّا فحسب، بل فيه شقّ لا عقلي (أنطولوجي)، وهناك الجسيمات الافتراضيّة الّتي تقفز من العدم الأبستمولوجي إلى الوجود الأنطولوجي لتُحدث تأثيرًا ما ثمّ تختفي بسرعة خاطفة؛ مع أنّها عقليّة لا ماديّة ولكن عقليّتها لم تمنع من وجود تأثيرها المادي، الأمر الّذي حمل (جون بولنجهورن) على القول: «الأبستمولوجيا هي الّتي تصوغ الأنطولوجيا» ([51]). وما يعنيه ذلك في أطروحتنا أنّ الحقل المتضامر ليس من جنس المثال أو المعقول فحسب بل هو متراكب من المعقول ولا مثيله.
رابعًا: قضيّة اللّابغاء جدّ مهمّة في رؤيتنا؛ وذلك لأنّها تناظر ما نقول به من وجود ما نسمّيه (فجوة) قد يصحّ تشبيهها بالدّائرة الفارغة بين النّماذج المعرفيّة الرئيسة الثّلاثة، وكما في الصّيغة:
(الدّين O الفلسفة O العلم O الدّين)
فما يناقشه الدّين من قضايا أبستمولوجيّة أو أنطولوجيّة، لا تماثل ما تُناقشه الفلسفة في القضايا النّظيرة، والعلم أيضًا؛ وذلك لأنّ مرجعيّة الدّين المعرفيّة هي الوحي، وأمّا الفلسفة فتتمسّك بالعقل، في حين مرجعيّة العلم التّجربة أو الرّصد؛ لذا ووفَقًا لهذهِ الدّلالة يُمكن القول: لا يُعرف الدّين إلّا بالدّين، ولا تُعرف الفلسفة إلّا بالفلسفة ولا يُعرف العلم إلّا بالعلم، وهذا يتوافق مع مفهوم اللابغاء.
لكنّ لما كنّا نفترض وجود الحقل المتضامر أو الأبستطولوجيا، فهذا الحقل أشبه ما يكون بالنّقطة المركزيّة داخل تلك الدّوائر، وهذه النّقطة تعمل عمل المرآة العاكسة؛ ولكنّها ليست مرآة سكونيّة بل مرآة تفاعليّة. ففي توسّطها بين الدّين والفلسفة، تُتيحُ فضاءً معرفيًّا ليرى النّموذج المعرفي الدّيني نفسه بنفسه في مرآة الفلسفة، وفي المقابل تجعل النّموذج المعرفي الفلسفي يرى نفسه بنفسه في مرآة الدّين. وذات الأمر ينطبق على العلاقة بين كلّ من الدّين والفلسفة مع العلم، فهي تجعل العلم يرى نفسه بنفسه في مرآة الدّين تارّة وفي مرآة الفلسفة تارّة أخرى.
إنّ ما يُحقّق هذا التَمرّي التّفاعلي هو الحقل المتضامر أو الأبستطولوجيا، إذ بخواصه الّتي تحدّثنا عنها، يجعل بالإمكان للأبستمولوجيا الدّينيّة أن تفيد بوجهٍ لا مباشر من الأبستمولوجيا الفلسفيّة والعلميّة، والأمر ذاته للأنطولوجيا الدّينية وتكاملها مع الأنطلوجيتين الأخرتين والعكس بالعكس صحيح، فالفجوة المتمثّلة باللابغاء تضمر لا مثيلها المتمثّلة بالقفزة، والأداة الّتي تساعد على ذلك هي الأبستطولوجيا.
خامسًا: وأمّا كلّ من خاصيّة التعدّد الفائق والفصل واللافصل، فهي من الخواص الّتي يتّصف بها هذا الحقل أو البعد أو الواقع المتضامر.
(9) هنا ان نوضح الآن وبدقّة أكبر منظورنا لطبيعة العلاقة التّضامريّة للمفاهيم الرّئيسة الثلاثة: الأنطولوجيا والأبستمولوجيا والأبستطولوجيا. ولفعل ذلك سننطلق من لفظة الوجود. فحين نطلق لفظة الوجود فإنّ نقطة الانطلاق في فهم هذا المفهوم تبدأ في التّضامر من المُظهر، والمادّة المحسوسة هي أوّل ما نقابله في طريق الفهم المقصود، فالمادّة هي الوجود؛ ولكن الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد، فهناك مستوى آخر للوجود يُمكن تعقّله ولا يُمكن لمسه وهو كما يعرضه لنا أفلاطون وأعني به (عالم المُثل)، فهو وجود مفارق لا تستطيع حواسنا أو تقنياتنا أن تتواصل معه تواصلًا مباشرًا، وعلينا أن نتقبّله على ما هو عليه، وجود لا مباشر. والسّؤال: هل هذا الوجود حقيقي، أي واقع في الخارج المفارق حقًّا، أم أنّ العقل يفترض وجوده، ويعكس عليه صبغة حسيّة خاصّة به، ولا حقيقة له في الواقع الخارجي؟
لن نحصل من الفلاسفة –ولا حتّى من الفيزيائيّين-على إجابة وحيدة، فبعضهم سيقول إنّ له وجودًا حقيقيًّا في الخارج، يدعمهم المنظور الدّيني. وبعضهم الآخر سيُنكر أيّ وجود حقيقي له في الخارج، بل هو مجرد مفهوم كلّي يفرضه العقل على الواقع ليس أكثر. وهذا يعني أنّ فهم الوجود على أنّه مادي فحسب ليس قطعيًّا بل يلتحق به لزومًا بُعد لا يستبعد أنيكون وجودًا عقليًّا (أبستمولوجي)، ومن هنا فنحن نرى بأنّ من المجانب للإنصاف أن يُقال:
الوجود = البعد المادّي المحسوس فقط.
وليس من الإنصاف أيضًا أن يُقال:
الوجود = البعد المادّي + البعد اللّامادّي
لأنّ البعد اللّامادّي (المثالي) غير مقطوع به كوجود خارجي من الجميع.
فهذا يوصلنا إلى المعادلة:
الوجود = قطعيّة البعد المادّي + احتماليّة البعد اللّامادّي.
لكن -ومن جانب آخر- هناك من يشكّك في الوجود المادّي أصلًا كفلاسفة المثاليّة الذّاتيّة -باركلي على سبيل المثال-أو القائلين بوحدة الوجود من الّذين يرون الوجود الحقيقي هو لله تعالى وحده، وما الواقع الخارجي إلّا وجود إضافي، قابل للزّوال في أيّ لحظة يشاء فيها الحقّ تعالى أن يفنيه أو يعدمه، فالمفارق هو الأصل والحسّي هو النّموذج العارض. يقتضي هذا الفهم إعادة صياغة المعادلة كالصّيغة الآتية:
الوجود = احتماليّة البعد المادّي + احتماليّة البعد اللّامادّي.
فإن تفهّمنا أنّ البعد المادّي أقرب إلى الأنطولوجيا منه إلى الأبستمولوجيا، كأن تكون النّسبة (75/ 25%)، فإنّ المتوقّع أن يترتّب على الفرع الثّاني هو العكس؛ بأن يكون أقرب إلى البعد الأبستمولوجي منه إلى البعد الأنطولوجي بنسبة احتماليّة (25/75%). وما يترتّب على ذلك هو أنّ مفهوم الوجود لا يُمكن أن يكون خالصًا من الأبستمولوجيا 100% إلّا بدلالة مُحدّدة ([52])، وكما في المعادلة الآتية:
الأنطولوجيا = البعد المادّي فقط ← المذهب المادّي.
وفي المقابل، لا يُمكن أن تكون الأبستمولوجيا خالصة 100% إلّا بدلالة مُحدّدة. أي:
الأبستمولوجيا = البعد العقلي فقط ←المذهب المثالي.
فإذا لم تُذكر الدّلالة المحدّدة تصريحًا أو تلويحًا أو تكون واضحة في السّياق؛ فإنّنا نعتقدُ أنّ الأدقّ أن تكون المعادلة الكاشفة عن معنى الوجود هي:
الوجود = الأبستطولوجيا.
والأبستطولوجيا = (25% أبستمولوجيا مُظهرة × 75% أنطولوجيا مضمرة) + (75% أنطولوجيا مٌظهرة × 25% أبستمولوجيا مضمرة)
ما يعني أنّ هناك تكافئًا لا متماثل في هذه المعادلة، وهي تستتبع –بالضّرورة- افتراض الصّيغ الآتية:
الأبستمولوجيا = الأبستطولوجيا –الأنطولوجيا.
الأنطولوجيا = الأبستطولوجيا – الأبستمولوجيا.
(9-1) وَفقًا للتصوّر الّذي ينبني على ثلاثيّة: الأبستمولوجيا والأنطولوجيا الأبستطولوجيا، كيف يُمكن أن نفهم طبيعة العلاقة بين الذّات والموضوع؟
في الحقيقة ووَفقًا لمنظورنا فإنّ تلك العلاقة تتلخّص في الصّيغة (تعازل لا تعازل – نسبويًّا) بدلالةٍ مُحدّدة، وما يعنيه ذلك هو أن تتمظهر تلك العلاقة وَفْقَ القيم الثّلاث وكما مبين في الآتي:
* حالة الأنطولوجيا: وفيها يُمكن أن تكون وأن تكون فقط متعازلة إذا اقترنت بدلالةٍ مُحدّدة، ومثالها طبيعة العالم قبل وجود الإنسان. فما موجود هو الأنطولوجيا بدلالة عدم وجود الإنسان.
* حالة الأبستمولوجيا: وفيها يُمكن أن تكون وأن تكون فقط لا متعازلة إذا اقترنت بدلالة محدّدة، ومثالها المفهومات الكليّة العقليّة المجرّدة، أو المثاليّة المفارقة أو حتّى قوانين الطّبيعة عند بعض العلماء، إذ لما سُئِلَ عاِلم الجسيمات ما دون الذرية (ريشارد فاينمان) ([53]) ذات مرّة: هل فكرت يومًا أنّ لقوانين الفيزياء وجودًا مستقلًّا؟ أجاب: «عندما تكتشف هذه الأشياء تشعر أنّها صحيحة قبل أن تكتشفها، وبذلك تعتريك الفكرة أنّها كانت موجودة هناك بشكل ما» ([54]).
* حالة الأبستطولوجيا: وهي الحالة الثّالثة الّتي لا تتّصف بها العلاقة على أنّها متعازلة أو لا متعازلة، بل كلاهما في الوقتِ نفسه، وَفقًا لمبدأ التّتام، وهو يخضع لطبيعة النّسب الّتي وضّحناها في الفقرة (9).
(9-1-1) الحالات الثّلاث هي أجوبة نهائيّة متكافئة بدلالاتهاـ
(9-1-2) الحالات الثلاث تخضع لمبدأ التّتام.
(9-1-3) بسبب نهائيّة الحالات الثّلاث وتكافئها وتتاميتها فإنّ المذاهب المختلفة لم تنجح في أثناء معركتها الطّويلة الّتي استغرقت آلاف السّنين في تسويغ وجهة نظر وحيدة من بين وجهات النّظر المختلفة، فكُلّ منها تنطوي على الحقيقة انطواءً نسبانويًّا، وتزوّدنا بتصوّر عام ومنهج للبحث، نتعلّم بفضلها النّظر بوضوح أكبر إلى العالم.
(9-1-4) عن الطّبيعة الثّالثة كان للفيلسوف الألماني (ياسبرز) ([55]) رؤية يُمكن وسمها بالنّضوج، ذهب فيها إلى أنّ ثمّة رابطة بين الذّات والموضوع (العقل والعالم) في أعماق الشخصيّة الإنسانيّة، دعاها بـ الشّامل وذكر أنّ هذه الرّابطة سرّ مغلق علينا لا نستطيع الوصول إليه بوعينا. الرّابطة عنده هي بمنزلة الوحدة الجامعة الّتي تربط دائمًا وراء وعينا، وتنقذنا في اللّحظة الحرجة من انشقاق الشّخصيّة بين الذّاتيّة والموضوعيّة. بمعنى أنّ بين جميع التصوّرات توجد نقطة مشتركة تجعل من الموجود حقيقة خارجية عن الآنا «أنّ ما نفكر فيه هو ما نقوله، وهو دائمًا شيء آخر غيرنا، وهو ما نعلق به نحن الذّوات كما لو كنا نتشبّث بموضوع قائم بمواجهتنا … هذه السّمة الجوهريّة هي ما ندعوه: الانشقاق بين الذّات والموضوع» ([56]). فلا يُمكن أن تنفصل الذّات عن التّشارك. فإذا جرّدناها من المشاركة، أعتمت وأظلمت وانقلبت جانبًا أحاديًّا لا يُمكنه أنْ يعطي التصوّر الكلّي عن الواقع. وبتعبير صريح: إنّنا إذا عددنا أنّ هناك واقعين متقابلين وهما: الواقع الذّاتي والواقع الموضوعي، فيبدو: الشّامل الّذي اقترحه (ياسبرز) هو الواقع الثّالث المشترك أو الوسط بين الذّاتي والموضوعي والقادر على أن يرتّق الفتق بينهما كما يرى.
إن كان الفيلسوف الألماني (شوبنهاور) ([57]) يعضد الفكرة السّابقة حين يقرر أنّه «ليس هناك موضوع بلا ذات، وليس هناك ذات بلا موضوع … ويبدو واضحًا أنّ الموجود من حيثُ هو لا يُمكن أن يكون موضوعًا ولا ذاتًا، بل هو الشامل الماثل وراء الانشقاق» بين الذّات والموضوع ([58])؛ فإنّنا كما بيّنَّا إن كنّا نتّفق مع الشّامل ونطلق عليه مصطلح (الأبستطولوجي) وبما يتضمّنه من خصائص وضّحنا بعضها سلفًا؛ فإنّنا لا نتّفق مع نفيه لوجود موضوع بلا ذات، ولا ذات بلا موضوع، بل أثبتنا هذين الوجهين وكما مبيّن في الفقرة (9-1).
(9-2) كما أنّ الأبستطولوجيا تجمع في ذاتها وتفرّق بين الذّات والموضوع، وهما أمران غير متماثلين في ذاتهما، فإنّها تجمع وتفرق بين الذّات ولا مثيلها بدلالة نفسها (ذات لا ذات بدلالة الذّات)، كما تجمع وتفرق بين الموضوع ولا مثيله بدلالة نفسه (موضوع لا موضوع بدلالة الموضوع).
أمّا الحالة الأولى فيمكن قراءتها فيما ذهب إليه (ديكارت) من أنّ الفكرة تتضمن وجودًا وسيطًا ذا طبيعة مزدوجة، فهي وسيط بين فعل التّفكير وموضوعه؛ ما يؤكد لنا على أنّ الفكرة تشارك في هذا وذاك، فهي ليست الموضوع كما يقول الحسيون، وليست الفكر كما يقول (باركلي)؛ ولكنّها الوسيط بين الاثنين. النّقطة الجديرة بالاهتمام هي أنّ هذا المفهوم يعتمد اعتمادًا كليًّا على وجود الله فينا، إذ عنده “إن يقين المعرفة يعتمد على الإيمان بوجود الله ([59])؛ ما يعني أنّ الطّبيعة المزدوجة للفكرة ذات بعدين: ذاتي ولا ذاتي في الوقتِ نفسه؛ لأنّه يعدّ الله فينا وليس مفارقًا. بتعبير آخر: لمّا كان الله مفارقًا، ولمّا كان الله فينا؛ فإنّ قيام الفكرة فينا يكسبها طبيعة مزدوجة، إلهيّة بشريّة؛ ما يعني أنّها ذاتيّة لا ذاتيّة في ذات المفكر. وهذا وَفْقَ الدّلالة الدّيكارتيّة يُعطينا صورة من صور الأبستطولوجيا بدلالة الذّات.
أمّا الحالة الثّانية، فيمكن أن نستشفّ صورة من صورها ممّا ذهب إليه (جون لوك) أنّ العقل صفحة بيضاء في أصله، وأنّ المصدر المعرفي الوحيد للإنسان هو الخارج (الموضوع)، وأنّ العمليّة الفكريّة مكتسبة لا فطريّة، فهي مجرّد انعكاس وصدى للعالم الخارجي. ولكن ما إن تدخل المعلومات من الخارج إلى الذّهن حتّى يجري في الذّات ما يسمّيه التّأمّلات الدّاخليّة للنّفس، وهذه التّأمّلات تحليلات للمعارف الآتية من الخارج، فينشأ عنها ما يُسمّى بالتّصوّرات، كالشّك، والإيمان، والبرهنة، والمعرفة، والإدراك وغيرها. وصفوة القول في مذهبه: إنّ الطّبيعة المزدوجة للأفكار -أو كما وصفها لوك- بذات الوجود المتشابه؛ لكونها تجمع بين وجود الأشياء الّتي تمثّلها وبين الفكر الّذي يتصوّرها. فهي في النّهاية تارّة تمثيلًا للعالم الخارجي، وتارّة أخرى تمثيلًا لكليات ذات محتوى منطقي ([60]). تلك الطّبيعة متأتّية في الأصل من الموضوع (الخارج) ثمّ اللّاموضوع (الذّات)، ما يعني أنّها موضوعيّة لا موضوعيّة بدلالة الموضوع. ودلالة (جون لوك) هذه تعطينا تصوّر عن صورة أخرى من صور الأبستطولوجيا وهي: الّتي تكون بدلالة الموضوع.
وخلاصة ما يُمكن استخلاصه لحدّ الآن في هذه الفقرة هو:
الأبستطولوجيا = (ذات × موضوع) + (ذات × ذات) + (موضوع × موضوع)
ما يعني أن الأبستطولوجيا أو الحقل التّضامري يحتمل جميع الاحتمالات الممكنة؛ الأمر الّذي يعطيني تصوّرًا عن سبب الاختلاف الكبير أو اللّاتماثلات في تفسير هذا البعد كلّما حاول أحد ما تحليله؛ لأنّه -في الغالب وبسبب خاصية التّتام- حين يحضر في الذّهن أو المعتقد وجه كلي ليكون مظهرًا يكون بحضوره أو ظهوره هذا حاجبًا أو ساترًا أو ضامرًا لبقيّة الأوجه. أمّا نحن فنسعى جاهدين للإمساك بالوجه ولا مثليه، المظهر والمضمر معًا.
(9-2-1) وفي الحقيقة فإنّ الطّريقة الّتي نفكّر بها للإمساك بالوجه ولا مثيله، وكما بيّنتها في الفقرة السّابقة، ليس بدعًا منا، فهناك العديد من الإشارات الّتي أبداها بعض العلماء وتنمّ عن شعورهم بوجود مثل تلك الرّابطة الخفيّة بخصائصها العجيبة، وممّا يُمكن ذكره في هذا الصّدد –على سبيل المثال- نصّ جاء في رسالة كتبها ألبرت أينشتاين إلى (سولوفين) مؤرّخة في (7 ايار عام 1952) عن الرّابطة الإشكاليّة الأزليّة بين عالم الأفكار وما يُمكن أن يجرّب أو يمارس مشدّدًا فيها على عدم وجود ممرّ منطقي بين المفهومات النّظريّة وملاحظات العلماء، فأحدهما يجرّ جراًّ للتّوافق مع الآخر بأسلوب حدسي خارج حدود المنطق ([61]). أي أنّه يُشير إلى أنّ ثمّة أمرًا عصيًّا على الفهم أو التسلسل المنطقي، ولهذا وصفه بأنه حدسي، وفيه كأنّما الفكرة تلقى إلقاء إلى الذّهن إلقاءً مباشرًا. إنّنا نعتقد أنّ سبب ذلك هو التّقابل بين الذّات والموضوع تقابلًا أبستطولوجيًّا.
نظيرًا لما ذهب إليه أينشتاين قال عالم الفيزياء النّظريّة (باول ديفيز): «تظهر التّجربة مع تطوّر الفيزياء أنّ ما كان يُعتقد بأنّه قوانين مُستقلّة إنّما هي قوانين يرتبط بعضها ببعضها الآخر، ولدينا مثال جيّد على ذلك في الاكتشافات الحديثة بأنّ القوّة الذريّة الضّعيفة والقوّة الكهرطيسيّة هما في الحقيقة وجهان لقوّة كهربائيّة ضعيفة واحدة تُوصف بجملة معادلات مشتركة؛ ولذا يبدو أنّ القوّة المنفردة هي قوّة مشروطة بقوى أخرى. لكن هل من الممكن أن توجد قوّة عليا أو قانون أعلى يوحد كلّ القوانين فيكون لازمًا؟ يعتقدُ عدد من الفيزيائيّين بذلك» ([62]). وهو منظور مناسب لنوضح فيه أنّ الأبستطولوجيا تتشابه من وجه في خواصها مع جملة القوّة التتاميّة بين القوّتين الكهربائيّة والمغناطيسيّة المنتجة للقوّة الكهرطيسيّة من جهة، والقوّة الذّرية الضّعيفة من جهةٍ أخرى، فلدينا ذات وموضوع يشتركان في الإنسان؛ ومن ثمّ الإنسان بجملته المشتركة تلك يتشارك مع الموضوع الخارجي المنفصل إلى حدٍّ ما عن الذّات، ولئن كانت الفيزياء قد استقرّت على أنّ تلك الحالات أوجه متتامة لحقيقة واحدة؛ فإنّنا -وفي المستوى النّظري الفلسفي- نقول بشأن العلاقة بين الإنسان والعالم، فهي عندنا أوجه متتامة لحقيقة واحدة أطلقنا عليها لفظ الأبستطولوجيا أيضًا.
(9-3) من خواص الأبستطولوجيا أنّها تستوعب الاحتمال القائل إنّ هناك فضاءً عقليًّا خارجيًّا، تشترك العقول بالتّواصل معه والإفادة منه، وكان عالم الرّياضيّات (رودي روكر) ([63]) من القائلين بوجود نوع من الفضاء، وهو ما دعاه بـ الفضاء العقليMindscape ذاهبًا إلى أنّه مجمع الأشياء الريّاضيّة، أي: على النّحو نفسه الّذي تحتلّ فيه الأشياء الفيزيائيّة فضاءً فيزيائيًّا، وقد كتب يقول: «إنّ الشّخص الّذي يقوم ببحث رياضي يستكشف الفضاء العقلي تمامًا بمثل ما استكشف (ارمسترونغ) ([64])… الملامح الفيزيائيّة لعالمنا» ويعتقد )روكر( أنّه «بمثل اشتراكنا بالكون ذاته فإنّنا نشترك أيضًا بالفضاء العقليّ ذاته» ([65]). وقد أيد (روجر بنروز) هكذا مضمون قائلا: «إنّني أتخيّل أنّه كلّما فكر عقل العالم بفكرة اتّصل بعالم للمفهومات. وعندما يتواصل العلماء يكون ذلك ممكنًا؛ لأنّ لكُل واحد منهم طريقًا مباشرًا إلى الحقيقة، العالم الأزلي الوجود ذاته» ([66]). بحسب بعض من أهمّ علماء الرّياضيّات؛ فإنّ الأفكار لا تُخترع من العقل البشري بل تُكتشف، وهي تتمتّع بوجود مستقل يسمو على الواقع الفيزيائي الّذي يُقابل حواسنا، أي أنّها موجودة سلفًا سواء عرف البشر ذلك أم لا؛ ومع ذلك فإنّ فكرة وجود حقل متسام خاصّ بالأفكار لكثيرٍ من العلماء يبدو أكثر غموضًا من أنْ يعترفوا به ([67]). غير أنّ عددًا من العلماء –مثل عالم الرّياضيّات (كورت غودل) ([68]) – أعلنوا بالفعل أنّ المقولات الصّحيحة موجودة سلفًا «هناك في الخارج» في المجال الّذي يقع وراء إدراكنا ([69]). وإلى ذلك عبّر (باول ديفيز) ([70]) عن ذلك بالقول: «يبدو كما لو أنّ التّفكير البشري موّجه نحو حقيقة خارجيّة خالدة لها واقعيّة ذاتيّة لا تنكشف إلّا جزئيَّا لأيّ واحد منّا» ([71])، ولقد ذكر عالم الرّياضيّات (روجر بنروز) ([72]) بعد حديثه عن التّيارات الرّئيسة في فلسفة الرّياضيّات: «إننّي أميلُ وبشدّةٍ إلى وجهة النّظر الأفلاطونيّة القائلة إنّ الحقيقة الرّياضيّة مطلقة وخارجة وأزليّة، ولا تقوم على معايير من صنع الإنسان، وأنّ الأشياء الرّياضيّة أيضًا لها وجود في ذاتها خارج عن الزّمن، ولا علاقة لها بالمجتمع الإنساني ولا بالأشياء الفيزيائيّة الخاصّة، ولقد حاولتُ أنْ أجعل الدّفاع عن وجهة النّظر هذه قضيّتي …» ([73])، وفي حديثه عن مجموعة مندلبروت الرّياضيّة([74]) الّتي لها المقدرة على توليد أَشياء رياضيّة تكاد تكون خرافيّة في غناها وتنوعها وتعقيدها: «إنّ مجموعة مندلبروت ليست من اختراع العقل البشري وإنمّا هي اكتشاف، فمجموعة مندلبروت مثلها مثل قمّة إيفرست موجودة هناك فقط» ([75]).هذا وقد اتّفق الرّياضي والإعلامي (مارتن غاردنر) ([76])مع (بنروز) على هذه النّتيجة، فقال: «يرى (بنروز) كما أرى أنا، أنّه من غير المعقول أن يفترض أيّ منّا أنّ هذه البنية المدهشة والغريبة ليست أكثر (وجودًا هناك) من جبل إيفرست وخاضعة للاكتشاف بالطّريقة ذاتها الّتي تكتشف بها الغابة»([77])، وقد تقرّر لدى (جون بارو) ([78]) أنّ ظاهرة الاكتشاف المستقل دليل على وجود عنصر موضوعي مستقل عن نفسيّة الباحث ([79]).
إلى ذلك كان أفلاطون قد اعتقد بأنّ صانعًا حِرَفيًّا خيِّرا هو الآلة الصّانع قد بَنى العالم باستخدام مبادئ رياضّية قائمة على أشكال هندسيّة متناظرة، وكانت هذه المملكة المجرّدة من الأشكال الأفلاطونيّة مرتبطة مع عالم التّجربة الحسيّة اليوميّة بكيان مرهف دعاه أفلاطون «روح العالم» ([80]). وما يتحدث عنه أفلاطون هنا، هو الواقع الثّالث، بالمواصفات التّجريديّة الّتي تصوّرها، وبارتباط شفاف أو رهيف، يجعل التّواصل بين الذّات والموضوع ممكنًا. وقد شبّه الفيلسوف (والترماير شتاين) روح العالم الأفلاطونيّة بمفهوم النّظريّة الرّياضية الحديثة؛ نظرًا إلى أنّ هذا المفهوم هو الشّيء الّذي يربط تجارب العلماء الحسيّة بالمبادئ الّتي بُني عليها العالم، وهو الّذي يمنحنا الفهم ([81]).
إذن، على المستويين الفلسفي والعلمي (الرّياضي والفيزيائي) يوجد صدى واسع لفكرة وجود حقل مفاهيمي غير ذاتي تجتمع فيه القوانين والنّظريّات والمفهومات والآراء، ومنه تستقي العقول المتعمّقة ذلك النّوع من الحدس أو الاستلهام المباشر، وهو من الوضوح لدى هذه العقليّات بحيث تتبيّن بأنّه شيء أكبر من أن يكون محصورًا بذات مُستقلّة عن بقيّة الذّوات أو العالم.
(9-3-1) العقول وإن كانت تبدو مُستقلّة عن بعضها بعضًا استقلالًا مطلًقا، فهي وبدلالة أخرى مرتبطة مع بعضها بعضًا ارتباطًا غير مباشرٍ من طريق حقل أو فضاء عقلي يُحيط بها، فهي ووَفق الصّيغة التّضامريّة: (مُستقلّة لا مُستقلّة – نسبانويًّا) بدلالة الفضاء العقلي. وتصبح الصّياغة النّظيرة: (مرتبطة لا مرتبطة – نسبانويًّا) بدلالة الأبستطولوجيا.
(9-3-2) يرى بعضهم أنّ العقلَ ليس له إلّا ذاته المستقلّة، ووَفق المنظور المذكور آنفًا، نستطيع أن نستنتج أنّ ذلك صحيح نسبانويًّا بدلالته، في حين أنّ من الصّحيح النّسبانوي أيضًا أن يكون للعقل مرجعيّة لا ذاتيّة.
* * *
ممّا تقدّم يتبيّن أنّ وجود واقع كلّيّ أو شامل أو موحّد لا ذاتي ولا موضوعي، يستوعب كلّ شيء وجميع المفهومات، استيعاب المطلق للنّسب والاحتمالات غير المنتهيّة، هو أمر له جذوره –بوجهٍ أو بآخر-في النّماذج المعرفية الثّلاثة: الفلسفيّة والعلميّة والدّينيّة؛ ولهذا -وبغض النّظر عن اختلاف الآراء في طبيعته الموضوعيّة أو الميتافيزيقيّة أو الذّاتيّة- فهو يُعدّ عالمًا وسيطًا مشتركًا ومحايدًا في الوقتِ نفسه؛ كونه يُلهِم الفلاسفة من طريق تأمّلاتهم العقليّة، ويُفاجئ عقول العلماء بالحدس في أثناء تجاربهم العلميّة أو تنظيراتهم الرّياضيّة، ويتجلّى بالكشف على قلوب الصّوفيّة؛ وربّما يتنزّل منه على غير هؤلاء – كالأدباء والفنّانين وحتّى أصحاب الأساطير والحكم والأمثال الشّعبّية- وبما يتناسب وطبيعة تلقي كلّ منهم لنوع المعرفة وطبيعتها.
إيجاز ما تقدّم يتّضح من المستخلصات المبيّنة في الآتي:
(1) اللّاتماثل قاسم مشترك بين جميع أنواع الظّواهر الطّبيعيّة والمعرفيّة. فهو الحقل الّذي يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة بين المثيل ولا مثيله كالاختلاف والائتلاف المعروفة في الأشياء والأفكار، وكالتّناقض والتّعاكس والتّباين والتّناظر والتّشابه والتّقارب … إلخ. ويُسمّى بـ (المضمر).
(2) الدّلالة المحدّدة عنصر أساسي مُشترك بين المثيل ولا مثيله، يتحدّد وَفقًا لها الفرق بينهما.
(3) يتحدّد مفهوم الوجود بثلاثة أنواع من الوقائع في الأقل: الواقع الأنطولوجي والواقع الأبستمولوجي والواقع الأبستطولوجي، وهذا الأخير، أي: الواقع الثّالث، هو المضمر المشترك لهما؛ ولأنّه مضمر فهو يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة فيهما وبينهما.
(4) الدّين والفلسفة والعلم، ثلاثة نماذج معرفيّة، وهي تخضع لمقتضيات الوقائع الثّلاثة؛ وهذا يستدعي القول إنّها لا مُتماثلة وعلى هذا تضمر جميع الاحتمالات الممكنة.
(5) العلاقة بين النّماذج تخضع لمبدأ التّتاميّة كليًّا أو جزئيّا، وفي حالتي تتام المنفصلات وتتام اللّامنفصلات؛ ولذلك فالأحكام المترتّبة عليها نسبانويّة بصورة مطلقة أو شبه مطلقة.
ثمّ وما يترتّب على هذه المستخلصات هو القوانين الثلاثة المنصوص عليها في الآتي:
أوّلًا: قانون تضامر الوجود:
(إذا وجد مثيلًا مقترنًا بدلالة مُحدّدة، فإنّ ذلك الوجود يدلّ على وجود لا مثيله بالضّرورة).
ثانيًا: قانون تضامر المعرفة:
(إذا وجد مثيلًا مقترنًا بدلالة مُحدّدة؛ فإنّ معرفة شيء فيه تضمر الدّلالة على معرفة شيء نظير له في لا مثيله بالضّرورة والعكس صحيح).
ثالثًا: قانون تضامر الأجوبة:
(إذا وجدت إجابة لسُؤال مقترنة بدلالة محدّدة؛ فإنّ تلك الإجابة تضمر لا مثيله بالضّرورة).
ويمكن جمع القوانين الثلاثة في مبدأ عام للتضامر ونصه:
(كلّ شيء –حتّى التّضامر-يضمر لا مثيله بدلالة محدّدة)
في الحقيقة، وفي أثناء مرحلة الانتقال من التّساؤل إلى الاستخلاص مرورًا بالافتراضات كانت هناك الكثير من المعطيات الّتي تشكّلت ذهنيًّا في فضاء متراكب؛ ما بين الاستدلال الموضوعي -لما أفكّر فيه- والقراءة الذّاتيّة المستلّة من ذلك الاستدلال أو المسقطة عليه. وقبل المضي قدمًا في استعراض نماذج من هذه القراءات، رأيتُ أنّ من الضّروري بمكان أن اتطرّق لذكر سمتين أساسيتين من سمات التّفكير في نطاق فلسفة التّضامر وهما:
أوّلًا: تتّسم في كونها ذات نظام يُعرف فلسفيًّا بـ (النّظام الهوليسيHolistic System )، وهو النّظام الّذي تكون فيه البديهيّات والتّعريفات الأصليّة غير مفهومة إلّا بلغة القضايا الّتي تُستنبط لاحقًا، في حين أنّ الاستنباطات اللاّحقة يجبُ أن تعود على البديهيّات والتّعريفات، وهذا النّظام يجبُ إلّا يتحدد تجزيئيًّا، بل بصفته الكليّة ([82]). فمثلًا: لو أردنا شرح مفهوم المُظهر لاحتجنا لشرح مفهوم المُضمر ليتميّز الشّيء بلامثيله، ولكي نشرح المُضمر فيجب أن نوضح طبيعة علاقة التّضامر بين المُظهر والمضمر، ولفعل ذلك علينا أن نحدّد مفهوم المُظهر أوّلًا. ومثل ذلك كمثل قول القائل: «إنّنا نقبل، في آن واحد، أنّه لا يُمكن اكتشاف الفلسفة إلّا بالاعتماد على الفلاسفة، وأنّه لا يُمكن فهم الفلاسفة إلّا إذا كنّا نعرف بعض الشّيء عما هو فلسفة» ([83]).
ثانيًا: تتّسم في كونها تعتمد على قواعد التّحويل أكثر من اعتمادها على قواعد التكوين. إذ وكما هو معروف في (علم التراكيب) يوجد صنفان من القواعد: قواعد التّكوين: وهي القواعد الّتي تتحكّم في بناء القضايا ذات التكوين الصّحيح، وقواعد التّحويل: وهي الّتي تحدّد وَفقًا لما يوصف بـ (القضيّة المترتّبة على ما قبلها) أو (القضيّة الّتي تتبع ما قبلها) ([84]).
في التّضامر، يصار أكثر ما يصار إلى تحويل القضايا الّتي سبق تكوينها ضمن مجالاتها أو نطاقاتها، حيثُ تدخل في سياقات النّسق المعرفي التّضامري من أجل دراستها بالتّحليل والتّركيب، ومثال ذلك، أن تُؤخذ النّتائج المتحصّلة في الفيزياء مثلًا في جانب ما وتُحلَّل تضامريًّا، واستخلاص ما يُمكن استخلاصه من مضمراتها.
فيما يأتي نستعرض عددًا من تلك القراءات، بما تتضمّنه من سمات أشرنا لها فيما تقدم:
قراءة في النّطاق الفلكي: نسبانويّة المركزيّات
من الفرضيّات المعتمدة في الكوزمولوجيا (علم الكون) فرضيّتان علميتان:
الأولى: إنّ الكون محدود غير أنّه ليس بمحدّد.
الثانية: عدم وجود مركز وحيد للكون.
من الفرضيّة الأولى نعلم أنّ الكون متناهٍ؛ ولكن ومع تناهيه ذاك فهو بلا حدود خارجيّة، وتأتي الفرضيّة الثّانية لتُبنى على الأولى، فتذهب إلى: لأنّ الكون غير محدّد خارجيًّا، فليس له مركز وحيد. والأمر حسب المعلومات الفيزيائيّة والفلكيّة يقتضي أن يكون للكون عدد غير محدّد من النّقاط المركزيّة.
ولما كنّا نعلم من فرضيّات التّضامر، أنّ الواقعين: الأنطولوجي الأبستمولوجي متضامران، فإنّ ما نحصل عليه بدلالة الفرضيتين المذكورتين آنفًا، هو: أنّ التّفكير الإنساني في حالته الكليّة ليس له مركز وحيد أيضًا، وما نعنيه بالمركز هنا هو المرجعيّة الوحيدة المتفرّدة. بتعبير آخر: هذا يدلّ على أنّ الحقيقة الفكريّة ليس لها مرجعيّة وحيدة أيضًا؛ لأنّ البعد الأبستمولوجي يُناظر البعد الأنطولوجي تضامريًّا.
عندما نجمع الأمرين معًا، نخرج بنتيجة تقول: إنّ الحقيقة في حالتها الكليّة الأبستطولوجيّة؛ أي الحالة الّتي يستمدّ الوجود الواقعي منها وجوده، وفي الوقتِ نفسه يستمدّ الوجود المعرفي منها وجوده، هي بلا مركز وحيد وبلا مرجعيّة وحيدة، بل هي تتضمّن الكثر الكاثرة من النّقاط والمراجع، إنّها تتضمّن كلّ الاحتمالات الممكنة.
في الحقيقية التّعدديّة كانت ولا تزال حاضرة، ولا نرى أنّها ستزول يومًا، فمثلًا من النّاحية العلميّة قد فُسّر الكون على أنّه ساعة دقيقة، وفُسّر على أنّه آلة ميكانيكيّة، وفُسّر على أنّه عضاة عملاقة، وفُسّر حديثًا على أنّه عالم حاسوب حيوي، ويُمكن تفسيره بالاستناد إلى أيّ وجهة نظر وكلّ منها سوف تجد المسوّغات اللّازمة لوجودها، وسوف تزوّد المعرفة بأفكار وتفسيراتٍ وتوقّعاتٍ مُعيّنة أو مُحدّدة نسبة لطبيعتها. بالمثل، فُسّر الكون فلسفيًّا على أنّه ظل لمثال مفارق، وفُسّر على أنّه مادّي أزلي، وفُسّر على أنّه مثالي ميتافيزيقي، وفُسّر على أنّه صراع جدلي بين الذّات ونفسها وبين الذّات وغيرها، وفُسّر بغير ذلك، وجميع تلك التفسيرات وَفْقَ هذا البرهان لا يُمكن أن تكون خاطئة، وفي الوقتِ نفسه لا يُمكن أن يكون كلّ منها هو التّفسير الوحيد الصّحيح.
إن تلك التفسيرات أو بالأحرى التّأويلات أشبه ما تكون بالمرايا المختلفة الّتي ينعكس فيها شيء مطلق المعالم. كلّ مرآة يُمكن أن تعكس الصّورة الكليّة وَفْقَ علاقة تشاركيّة نسبانويّة بينها وبين الشّيء المطلق. وما ينتج عن ذلك هو: التعدّد للفلسفات، التكثّر للآراء، التنوّع للمعتقدات. وينتج أيضًا: التّضاد، التّناقض، التّعارض، التّخالف، التّنازع، التّصارع، التّدافع … إلخ. كما ينتج: التّكامل، التّتام، التّناسق، التّناظم، التّأقلم، التّكيف، التّحابب، التّكاتف … إلخ، وجميع هذا يؤول بالمنظور الجدلي على أنّه بسبب الدّيالكتيك؛ ولكنّه قد يؤول في المنظور الغائي على أنّه بسبب القصد السّابق، ويُمكن أن يؤول بآراء أخرى لا تماثلها أيضًا.
على ذلك فجميع التّفسيرات أو التّأويلات ممكنة، جميعها محتملة، وكلّ ممكن منها أو محتمل يحجب عند أهله بقيّة التّفسيرات أو الاحتمالات؛ ولمّا كان معنى المضمر –اصطلاحًا عندنا-هو الاحتمالات الممكنة المحتجبة خلف احتمال مُظهر، فهذا يعني أنّ التّكثر أو التنوّع أو التعدد بما يشتمل عليه ذلك من ثنائيات (اختلاف-ائتلاف) أو (صِدام –ئام) أو (فوضى-نظام) أو (صيرورة-سكون) … إلخ. يندرج ضمن هذا المفهوم الكلي.
من هنا نستنتج أنّه لولا أنّ الحقيقة الكلية مُتضامرة في ذاتها لم نكتشف أن كلّ نقطة في الكون تصلح أن تكون مركزًا له، ولم ندرك أنّ المعرفة لا تصلح بمرجع وحيد فقط.
معنى قولنا مُتضامرة هنا، هو أنّ تلك الحقيقة وبسبب كلانيتها فإنّ بعضها يستر كلّها، وكلّ بعض منها يُعطي صورة كليّة عن الكلّ، وهو في صورته تلك يحجب عن رؤية بقيّة الصّور. ذلك الاحتجاب للكلّ في الجزء، هو احتجاب لازم، وهو لازم لأنّ طبيعة الحقيقة الكليّة هكذا.
علينا أن نفهم هذا الاحتجاب على أنّه إضمار وليس احتجابًا تقليديًّا، والفرق بينهما هو أنّ حجب شيء عن شيء يقتضي الفصل الكلّي أو الجزئي بين الحاجب والمحجوب، على حين الإضمار لا يقتضي ذلك الفصل، بل هو يُعبّر عن التّواصل أو الامتداد بين المظهر والمضمر.
هذه القراءة توصلنا إلى المضمون القائل:
لمّا كان الكون محدودًا غير محدّد، وليس له مركز وحيد إلّا بدلالة محدّدة؛ فإنّ ذلك يضمر الدّلالة على أنّ النّظام المعرفي محدود غير محدّدٍ أيضًا، وليس له مرجعيّة وحيدة إلّا بدلالة محدّدة. الأمر الّذي يُمكن صياغته وَفْقَ القراءة التّضامريّة بالصّورة:
الأنطولوجيا ı|ı الأبستمولوجيا← التّضامر
قراءة في النّطاق البيولوجي: تشاركيّة الـجينوم
منذ العام 1886م حين نشر العالم النّمساوي (جريجوري مندل) كتابه: «أصل الأنواع والوراثة المزجيّة» طارحًا فيه نظريّته في الوراثة وخلاصتها: «إن كلّ صفة تكون لها أصل من الأب أو الأم»، وحتّى عام 2003م حين أعلن عن إتمام عمليّة رسم الخريطة الوراثيّة البشريّة ضمن المشروع الّذي عرف باسم (مشروع الجينوم البشري)، مرَّ هذا العلم بسلسلة طويلة من الأبحاث والمكتشفات، كان لها بالغ الأثر في تغيير نظرة العلماء لطبيعة الأحياء، حيثُ شرعت أمامهم بابًا لقراءة كتاب الحياة، ولئن تمكنوا أخيرًا من قراءة بعض فصوله، فإنّ فهمه واستيعابه والاستفادة القصوى من جميع معطياته يحتاجُ إلى المزيد من الوقتِ والبحث المتواصل. وفي الموجز الآتي أهمّ النّتائج الّتي خلصت لها الابحاث والتّجارب الحديثة:
فطر الخميرة (Saccharomyces cerevisiae): ثبتَ أنّ نحو (38% ) من كامل بروتينات خميرة الخباز؛ أيّ (2,300 بروتين) لها ما يُشابهها من البروتينات المعروفة لدى الثديّات؛ ما جعل من خميرة الخباز كائنًا حيًّا نموذجيًّا ملائمًا لدراسة العديد من الأمراض البشريّة ومنها السّرطان، حيثُ اكتشف العلماء لأوّل مرّة الآليات الأساسيّة الّتي تستعملها الخليّة لضبط المسارات والمتغيّرات الّتي تُؤدّي إلى انقسامها في لحظةٍ مُعيّنة بدراستهم لهذا الفطر البالغ الصّغر. يقول (هارتول- رئيس مركز هاتشنسون لأبحاث السّرطان في سياتل): «لقد فهمنا أشياء كثيرة عن الانقسام الخلوي وإصلاح الدّنا، وكلاهما له أهميّة كبرى في نشؤ السّرطان من خلال دراسة كائنات بسيطة كالخميرة»([85]).
إضافةً إلى ذلك تمكّن علماء من (معهد هيوز الطّبي) في جامعة واشنطن من الاستدلال على وظيفة البروتينات بوساطة تأثّرها ببروتينات أخرى ذات دور خلوي معروف، وقد عرف النّظام المستخدم في الدّراسة بنظام الخميرة ذي الهجين (Yeast tow hybrid system)، وفيها يُستفاد من بروتين فعّال كدليل للعثور على بروتين آخر؛ وبذلك توصّلوا إلى التعرّف إلى وظائف (957 بروتين) من بين (1004) من بروتينات خميرة الخباز بعد مقارنتها بكائناتٍ أخرى ([86]).
درسَ فريق بحثي من جامعة جون هوبكنز وجامعة فانديربالت وجامعة انديانا وشركة ايلي ليلي للصّناعات الدّوائية، خلايا الخميرة أيضًا، وأظهرت التّجارب أنّ إجراء أيّ تعديل على تلك الخلايا لمنعها من إنتاج بروتين (DAPI) سيُؤدّي إلى وَقف تصنيع الكوليسترول فيها ومن ثمّ موتها. ثمّ أجرى الباحثون تجارب لتحديد نظير بروتين (DAPI) في الخلايا البشريّة، وقد استطاعوا تحديد النّظير، ثمّ أجروا تعديلاتٍ على خلايا بشريّة أُخذت من النّسيج الكلوي، وأوضحت النّتائج أنّ وقف تصنيع النّسخة البشريّة لبروتين (DAPI) أدّى إلى أن تفقد الخلايا قدرتها على تصنيع الكوليسترول الخاصّ بها والضّروري لضمان بقائها؛ لينتهي الأمر بموتها كما في خلايا الخميرة. وَفقًا لهذه النّتائج تشكّل لدى الفريق البحثي احتمال جعل نظير بروتين (DAPI) منظّمًا عامًا لمجموعة أنزيمات (P450) في خلايا الثّدييات بوجهٍ عام ([87]).
بكتيريا القولون: ثبتَ للعلماءِ أنّ عددًا من الجينومات والتّسلسلات البشريّة مُتشابهة مع هذه البكتيريا، وقد سهّلت دراستها فهم عددٍ من العمليّات الحيويّة داخل الجسم.
دودة الرّبداء الرّشيقة: تبيّن أن ثلث بروتينات هذه الدّودة (Caenorhabditiselegans) الّتي يبلغ حجمها (1 ملم تقريبًا) لها ما يُماثلها في الثديّيات. حيثُ تستحث طفرات بمورثاتها المستقبلة للأنسولين بهدف اكتشاف علاجات جديدة لمرض السكري.
ذُبابة الفاكهة: وجد الباحثون أنّ (60%) من مورثاتِ 289 مرضٍ من الأمراض البشريّة المعروفة لها ما يكافئها في الحشرة، وأنّ 7000 أيّ قرابة (50%) من كامل بروتينات ذبابة الفاكهة تظهر تشابهًا مع بروتينات معروفة لدى الثدييات، وقد أثبت الباحثون أنّ أحد مورثات الحشرة له نظير في الإنسان هو المورث (P53) المعروف بالمورّث الكابت للأورام الذي إذا ما طفر يسمح للكليّة بأن تُصبح سرطانيّة، حيثُ يشكّل هذا المورث جزءًا من المسار الجزيئي الّذي يُجبر الخليّة الّتي عانت من خلل وراثي يتعذّر إصلاحه على قتل نفسها، ولمّا عطّلَ فريق من علماء (شركة اكسيليكسيس) من ساوث فرنسيسكو البروتين المنتج لهذا المورّث فقدت الخلايا قدرتها على التّدمير الذّاتي كما هو الحال في الإنسان تمامًا. الأمر الّذي حدا (بروبين، أحد قادة مشروع ذبابة الفاكهة من معهد هاورد هيوز الطبّي في جامعة كاليفورنيا ببركلي) إلى القول: إنّ تشابهًا من هذا النّمط يجعل من ذبابة الفاكهة نموذجًا ملائمًا لدراسة الأحداث الجزيئيّة الّتي تشكل أساس السّرطان البشري([88]).
ممّا ساعد به التعرّف إلى جينوم هذه الحشرة هو فهم عددٍ من الأمراض البشريّة، ودور المورثات المتحكّمة في عمليّات تضاعف DNA، وإصلاح أعطاب DNA، والعقاقير والسّموم أيضًا، وغيرها. وقد وُجد أن (75%) من المورّثات المسبّبة للأمراض البشريّة متطابقة شفرتها الوراثيّة مع ذبابة الفاكهة، وأنّ قرابة (50%) من تسلسلات بروتيناتها مُتناظرة مع الثديّيات، وتُستخدم حاليًّا كنموذج وراثي لعددٍ من الأمراض البشريّة مثل: أمراض الاضطرابات العصبيّة (باركنسون) و(هنتغتون) و(الزّهايمر)، فقد وجد العلماء أنّ المورثات المتعلّقة بهذه الأمراض موجودة في الذّبابة ولكنّها لا تُعاني من المرض، ويأملون في أنّهم إذا تمكّنوا من فهم سبب ذلك أن يُساعدوا الأشخاص الّذين يعانون منها. إضافةً إلى ذلك تُستخدم لدراسة الآليّات الكامنة وراء الأكسدة والمناعة والسّكري والسّرطان وغيرها ([89]).
نبات الأرابيدوبسيس (Arabidopsis Thaliana): يُساعد جينوم هذا النبات على إنتاج محاصيل معدّلة وراثيًّا، فقد أمكن تحويل أحد مورثاته إلى مصانع حيّة لإنتاج البلاستيك؛ ما يجعل من الممكن نقل هذا المورّث إلى نباتات المحاصيل والبساتين والزّينة لإنتاج البلاستك، إضافةً إلى دوره في إنتاج الغذاء والدّواء والكساء وتحسين البيئة. بل أمكن استخدام شتلات معدّلة وراثيًّا للكشف عن الألغام من طريق إفراز خلاياه للون الأحمر الّذي يدلُّ على وجود ثاني أوكسيد النّيتروجين الّذي تطلقه المتفجّرات.
الفأر: أفادت دراسة فأر المختبرات –الفأر النّرويجي (Rattusnorvegicus)- وفأر المنزل (Musmusculus) أنّ نحو (90%) من بروتيناتها تتشابه مع بروتينات الإنسان المعروفة؛ ما يجعلها الأنسب بين الحيوانات للبحوث المتعلّقة بعلاج كثيرٍ من الأمراض الّتي تُصيب الإنسان.
معَ أنّ جينوم الفأر أصغر بنحو (14%) من جينوم الإنسان؛ إلّا أنهما يشتملان على عددٍ متقارب من المورّثات، حيثُ ظهر أنّ (99%) من المورثات الموجودة لدى فأرة المنزل يوجد ما يُماثلها لدى الإنسان، ويدخل ضمن هذا التّماثل المورّثات الّتي تقود إلى ظهور الذّيل لدى الفأر ([90])؛ الأمر الّذي حدا (ريك واتشيك) -مدير مختبر جاكسون- إلى القول: «إنّ المقارنة بين المورثات البشريّة ومورثات فأر المنزل سوف تفتح عهدًا جديدًا من التحريّات العلميّة المعمّقة على الأساس الجزيئي للتطوّر الحي» ([91]).
لقد عُدَّ نشر الجينوم الكامل للفأر في عام 2009 في مجلّة (Genome Biology) إنجازًا علميًّا مبشّرًا بفهم الألغاز الوراثيّة لدى الإنسان، نتيجة لوجود المورثات المتشابهة والمرتبطة بالأمراض لدى الإنسان والفأر، وبخاصّة أنّ درجة الدّقة في التنبّؤ حسب التّطبيقات الإحصائيّة تتعدّى 90% ([92]).
الجمل العربي: أشارت الدّراسات السّعودية الصّينيّة المشتركة لجينوم الجمل العربي الّتي بدأت عام 2004 وانتهت 2010م أنّ نسبة المورثات المشتركة بين الجمل العربي والإنسان تقارب 57% من المجموع الكلّي لمورثات الجمل العربي.
الأرز: سهلت المُقابلات بين الجينومات المختلفة لأصناف الأرز التعرّف إلى التّبادلات الوراثيّة والتوصّل إلى منشأ وتطور الأصناف من النّوع الأصلي البرّي (Wild type)، فقد وُجِدَ أنّ بروتينات الأرز متشابهة بنسبة (98%) مع بروتينات الذّرة والقمح والشّعير الّتي تنتمي للفصيلة النّباتيّة نفسها، وأنّ نحو (70%) من جينوم الأرز يُماثل مورثات في نباتات وكائنات أخرى، وأنّ معظم المورثات تكون عائلات وراثيّة (نحو 15000 عائلة) ([93])؛ الأمر الّذي جعل العلماء يستغلّون جينوم الأرز كنموذج لرسم محاكاة جينومات محاصيل الغلال الأخرى.
لقد تبيّن للعلماء أنّ الاختلافات الشّكليّة الظّاهريّة بين محاصيل الغلال إلى اختلافاتٍ في عددٍ قليل من المورثات أو اختلاف الوظائف بين مورثات مُتشابهة،
أدّت دراسة جينوم الأرز إلى استنباطِ أنواعٍ جديدةٍ ذات غلّة أوفر ولديها القدرة على مُقاومة الظّروف المناخيّة القاسية، خاصّة النّباتات الغلال الّتي تنتمي للفصيلة نفسها ([94]).
قرد الشّمبانزي (Chimpanzee): يدرسُ العلماء الحالات المرضيّة الموجودة في الإنسان من طريق حالاتٍ مرضيّةٍ مُشابهة عند الشّمبانزي؛ لتشابه الصّفات الوراثيّة إلى حدٍّ كبيرٍ مع الإنسان، وقد أفادت الأبحاث العلميّة أنّ نسبة التّشابه بين جينوم الشّمبانزي والإنسان تصل إلى (94%) ولكن هناك اختلافًا كبيرًا في الشّكل والبروتينات والصّبغيات الوراثيّة غير المنتجة للبروتينات.
تأتي أهميّة الشّمبانزي من كونه قادرًا على أن يحمل فيروس نقص المناعة الإيدز، ويُمكن أن ينقله للإنسان؛ ولكنّه لا يُصاب به، ولا تصيبه أمراض مثل: مرض الرّعشة عند كبار السّن، ومرض الحصبة، والملاريا، وسرطان الجلد، … أيضًا ([95]).
التّشارك الكيمائي للمورثات: في المحصلة فإنّ أهمّ ما توصل إليه العلماء من قراءتهم لجينوم الكائنات الحية ما يأتي:
أوّلًا: إنّ للوراثة لغة واحدة بين جميع الكائنات الحيّة، وقد اكتشف ذلك لأوّل مرّة العالم (تشارجاف) أواخر عام 1928م، حيثُ ذكر أنّ جميع الكائنات الحيّة فيها التركيب الكيمائي (DNA) نفسه. وقد ثبت ذلك في 25 أبريل عام 1953م حين نشرت مجلة الطّبيعة (NATURE) البريطانيّة ورقة علمية للعالمين الأمريكي (جيمس واطسون) والبريطاني (فرانسيس كريك) يصفان فيها نموذج الـ (DNA) الّذين تمكنّا من اكتشافه، وفي 1954م عرضا نموذجًا عنه في جامعة «كامبردج» بانكلترا، وقد أثبتا أنّ الـ (DNA) له تركيبة واحدة لا يتغيّر شكلها في الكائنات الحيّة.
ثانيًا: تتكون أبجديّة هذه اللّغة من أربعة حروف، وهي:
A: الأدينين (Adenine).
G: الجوانين (Guanine).
: Cالسّيتوسين (Cyosine).
T: الثّايمين (Thymine).
ثالثًا: تُكوّن هذه الأحرف الأربعة (64) كلمة وراثيّة كلّ منها تُسمّى (كودن).
رابعًا: من هذه الكلمات الـ(64) يتكون عدد لانهائي من الجمل الوراثيّة تتمثّل في الجينومات المعبّرة عن كلّ صفات الكائن الحي؛ الأمر الّذي رسّخ حقيقة علميّة تقضي بالتّشارك الكيميائي للمورثات بين جميع الكائنات الحيّة.
الـجينوم وقوانين التّضامر: مما تقدّم نستطيع أن نستخلص ما يأتي:
لمّا كانت الكائنات الحيّة موزّعة بين مرتبتين من مراتب التّضامر وهما: الطّبيعة والإنسان.
ولمّا كانت المرتبتان متشاركتين بـ (DNA)؛ ليكون الدّلالة المحدّدة بينهما.
ولمّا تمكن العلماء من اكتشاف مجهول أحدهما من معلوم الآخر.
فإنّ ذلك يُمكن قراءته وَفْقَ قوانين التّضامر، وكما يأتي:
أمّا قانون تضامر الوجود: فمن حيثُ أن وجود خصائص أو صفات في أحد الكائنات يدلّ على وجود تلك الخصائص في الكائنات الأخرى، بعضها مظهر وبعضها الآخر مضمر. وتصريحات المختصّين بهذا الشّأن كثيرة ومنها: أنّ (جونسون، نائب رئيس الأبحاث في شركة أكسيس لصناعة الأدوية في سان فرانسيسكو) قال: «إنّ ما بين 50 – 80% من الحالاتِ تقريبًا، نُلاحظ فيها أنّ مورثات بشريّة ما، تُشبه بما فيه الكفاية نظيرتها في الدّيدان الخيطيّة أو في ذبابة الفاكهة، بحيث يُتيح لك هذا التّشابه دراسة وظائف هذه المورثات» ([96])؛ الأمر الّذي رسخ في الأبحاث العلميّة المجينيّة المبدأ القائل: «إنّ الدّراسات المجينيّة المقارنة هي المفتاح لفهم المجين البشري» ([97]).
أمّا قانون تضامر المعرفة: فهو ينطبق على مسار العلماء في مُحاولتهم للوصول إلى مجهول كائن حيّ من معلوم كائن حي آخر بالاستناد إلى دلالة مُحدّدة مشتركة.
من الجدير بالذّكر هنا هو أنّ الدّقة في النّتائج العمليّة مقترنة بقدر دقّة الدّلالة المحدّدة، فمثلًا: عندما اكتشف العلماء أنّ بروتين (DAPI) هو المسؤول عن تصنيع الكوليسترول في فطر الخميرة، جعلوا ذلك البروتين دلالة محدّدة لهم، وأخذوا يبحثون عن نظيره في الخلايا البشريّة، وبالتّأكيد فإنّ القانون الأوّل يدلّ على وجوده، ثمّ لما وجدوه، كانت توقّعاتهم أنّ النّتائج ستكون مشابهة لخميرة الفطر، وبالفعل حصل كما توقّعوا، وكشف معلوم بروتين الفطر مجهول بروتين الإنسان؛ الأمر الّذي شكّل لدى العلماء تصوّرًا عن إمكانيّة وجود هذا التّأثير في جميع خلايا الثدييات بوجهٍ عام؛ ولذا شكّلوا –بالفعل- فريق بحثٍ متخصّص للتحقّق من ذلك.
مثال آخر: عندما أنجزت شركة «سيليراجينوميكس» الجينوم الكامل للفأرة (MusMusculus) في شهر فبراير عام 2001م، وبمقارنة الجينوم البشري بمورث الفأر اتّضح أنّ هناك تشابهًا قويًّا بين صبغيّات الإنسان وصبغيّات الفئران؛ ما ساعد على اكتشاف وظيفة (40%) من المورثات البشريّة الّتي لم يكن يُعرف عنها شيء سابقًا. إضافةً إلى أنّها ساعدت على تأكيد وظيفة مورثات أخرى كان يعتقد أنّها معروفة ([98])، وأظهرت الدّراسات على عددٍ من الجينومات أنّ هناك تشابهًا بينها وبين الجينوم البشري؛ ما يعني أنّه يُمكن الاستفادة منها في علاج الأمراض الخاصّة بالبشر، والأمثلة على ذلك عديدة ومنوّعة وقد سقناها فيما تقدّم.
بالنّتيجة؛ فنحن نخلص إلى صياغة هذه الحقيقة العلميّة بالصّيغة:
كلّ كائن حي يضمر لا مثيله من الكائنات الحيّة بدلالة (DNA).
أو
أ ı||ı ب ←(DNA) حيثُ إنّ:
(أ): الكائن الحيّ الأوّل.
(ب): الكائن الحيّ الثّاني.
(ı||ı): يرمز للتّضامر المشترك أو (ذاتي لا ذاتي) ([99]).
إنّ الـ DNA في الكائنات الحيّة، يوضّح مفهوم التّضامر ويُثبتهُ في الوقتِ نفسه؛ وذلك أنّ فكرة التّضامر تريد أن تقول: إنّ وراء الاختلافاتِ والتّمايزات المظهرة تُوجد وحدة مضمرة، وأنّ السّبيل لمعرفة تلك الوحدة المضمرة هو العثور على الدّلالة المحدّدة بين تلك المظهرات، ولما بتنا نعرفُ أنّ ما من كائن حي إلّا ويشترك مع غيره من الكائناتِ الأخرى بالشّفرة الجينيّة ذاتها، وما الاختلافات إلّا في ترتيب تلك المورثات، أو فعاليّة بعضها وعطالة بعضها الآخر؛ فهذا يدلُّ على أنّ كائنًا -ما كان الكائن هو- يحتوي على المورثات الّتي تظهر للكائنات الأخرى، أي: مضمرة، وهذا الإضمار ليس بالقوّة فقط -كما ذكر أرسطو- بل هو إضمار مادّي فعليّ أو حسّي. يُؤكّدُ هذا على أنّ البحث العلمي المنهجي في هذا المضمار يتطابق مع ما تنصّ عليه قوانين التّضامر ويتّسق معها.
حسب التّضامر الذّاتي فإنّ الـ DNA يفترض أن يضمر لا مثيله، وذلك وَفْقَ الصّيغة:
ı DNA| لا DNA
ونحن لا نستطيع أن نعرف لا مثيل الـ DNA ما لم نضع الدّلالة المحدّدة، أو هناك الطّريقة الأخرى وهي أن نعلم بوجود اللّامثيل أصلًا، وقتئذٍ تسهل القراءة ويسهل معها معرفة الدّلالة أيضًا.
من الجيّد أن نعلم هنا أنّه اكتشف بالفعل كائنات حيّة بكتيريّة ذات DNA يختلف تمامًا عن DNA جميع الكائنات الحيّة في الأرض، وكان فريق من علماء ناسا بقيادة الأستاذة في علم الأحياء الفلكيّة (فليسيا وولفسيمون) قد تمكّن من العثور على بكتيريا من نوع (جي أف إي جاي -1). الجديد في هذه البكتيريا أنّ شريط DNA استغنى عن عنصر الفسفور واستبدله بعنصر الزّرنيخ؛ الأمر الّذي لم يسبق له مثيل بين الكائنات الحيّة على الارض.
لذا يُمكن صياغة العلاقة السّابقة بالصّورة:
ı DNA| لا DNA ← العناصر السّتة.
وستكون النّتيجة هو الـ DNA الجديد. أكثر من ذلك، إنّ العلاقة -وكما وهو واضح- لا تستبعد وجود أكثر من DNA، يُمكن أن يكون أيّ عنصر آخر مستبدل فيه.
قراءة في النّطاق الفيسيولوجي: المخّ الجديد
من الدّراسة المستفيضة الّتي عرضها (ريتشارد ريستاك) في كتابه (المخّ الجديد) نستطيع أن نستَل الأفكار الآتية:
(1) يرى (ريستاك) أنّ من الحقيقة القول إنّنا: «نولد ولدينا القدرة على ترميز أصوات أيّ لغة في العالم» ([100])؛ وذلك استنادًا إلى عددٍ من التّجارب في هذا المضمار، ومن تلك التّجربة الّتي جُهِّزَ بها رأس رضيع بغطاء يحتوي على عشرين مجسًّا لقياس النّشاط الكهربائي للمخ، والّذي يفترض أن يتأثّر مع اللّغة المألوفة له، وقد لوحظ أنّ النّشاط الكهربائي للمخّ يتأثّر مع أصوات اللّغة الّتي يسمعها الطّفل، وحتّى للغات الّتي لا يتحدّثها الوالدان ولم يسمعها الأطفال من قبل أيضًا. ثمّ -ومع إجراء التّجربة على أطفال أكبر سنًّا- لُوحظ أنّ تلك القدرة على التأثّر باللّغات الأخرى تقلّ تدريجيًّا ما عدا اللّغة الّتي اعتادوا سماعها في حياتهم اليوميّة. ولقد توصّلت الباحثة (بات كول Pat Kuhl)([101]) إلى أنّ الرّضعَ اليابانيّين –على سبيل المثال- يستطيعون أن يُميّزوا بسهولة بين حرفي
(R , k) في اللّغة الإنكليزيّة ذات اللّكنة الأمريكيّة، مثلما نجد في كلمتي (Rook , Look) على حين أنّ الرّاشد الياباني يجد صعوبة في التّمييز بينهما، وذلك لعدم وجود (L) في اللّغة اليابانيّة، ويفقد الأطفال تلك القدرة بعد السّنة الأولى من الميلاد، حيثُ وجد أنّه عند قياس موجات المخّ أنّ الموجه المقاسة لم تستمر طويلًا عندما تبع صوت (R) بالحرف (L) ويعود ذلك إلى أنّ المخّ يقتصر على معالجة اللّغة الّتي يتحدّثها الوالدان ومع غياب التعرّض المستمرّ للغة أخرى، يفقد الأطفال القدرة على ملاحظة تلك الفروق الصّوتية الواضحة بين اللّغة الأصليّة واللّغات الأخرى. يرى (جيمس ماكليلاند James McClelland) ([102]) أنّ الرّاشدين اليابانيّين يستطيعون استرداد تلك القدرة، ويتطلّب ذلك التعرّض المستمرّ والكثيف من قبل المستمع للأصوات المميّزة للغة الأخرى؛ فقد أثبتت التّجارب ذلك وبعد ثلاث جلسات، استغرقت كلّ جلسة من 20 – 25 دقيقة على مدار ثلاثة أيّام. فقد نشّط التّدريب عددًا من تجمعات الخلايا العصبيّة، وصاحب ذلك تزايد تدريجي في الوصلات الّتي تربط بينها، وتحدث عمليّة مشابهة لما سبق عند التعرّف إلى الوجوه؛ إذ يستطيع الرّضع في عمر ستّة أشهرٍ أن يميّزوا بين الوجوه الجديدة والوجوه الّتي سبق التعرّض إليها بطريقةٍ مماثلة للرّاشدين، على حين يتفوّق الرّضع بعمر تسعة شهور على الرّاشدين في التعرّف إلى وجوه القردة الّتي لم يروها من قبل. اللّافت في هذه التّجارب، أنّ العلماء لاحظوا أنّ الأطفال بعمر ستة أشهرٍ يستغرقون وقتًا طويلًا نسبيًّا في التعرّف إلى وجه قرد جديد، بخلاف الأطفال في عمر تسعة شهور الّذين يستغرقون وقتًا أقصر، ما أوصل العلماء إلى نتيجة يُمكن تلخيصها بالقاعدة: (إذا كنت قد رأيت قردًا واحدًا، فإنّك قد رأيتها جميعًا).
استنتج العلماء أنّ عمليّة التعرّف إلى الوجوه أو اللّغة تحدث في خطوتين: الخطوة الأولى يُميّز الطّفل بسهولة وجهًا ينتمي إلى نوع آخر، ثمّ يحدث التخصّص الّذي يسمح بتمييز الوجوه داخل النّوع. معنى هذا أنّه وبزيادة التخصّص في المخّ تكون القدرة على التعرّف إلى الوجوه على أساس الخبرة، فتنضم الخلايا العصبيّة الّتي تكون مُتاحة سلفًا للتعرّف إلى مدى متّسع من الوجوه إلى الدّوائر المتخصّصة فقط في التعرّف إلى وجوه البشر. تدعم تلك الدّوائر من طريق التّكرار؛ ومن ثمّ تزداد دقّة التعرّف إلى الوجوه، وتحدث العمليّة نفسها مع اللّغة؛ حيثُ تنضم الخلايا العصبيّة الّتي كانت موجهة سلفًا للتعرّف إلى الحديث بلغاتٍ عديدةٍ إلى تلك المتخصّصة في التعرّف إلى اللّغة الأصليّة للفرد ([103]).
هذا يُعطينا تصوّرًا عن السّبب وراء الصّعوبة في تعلّم لغة جديدة، إذ «يُمكن تفسير هذه الصّعوبة عصبيًّا كما يأتي: تدخل أصوات اللّغة الثّانية في منافسة مباشرة مع أصوات اللّغة الأصليّة الّتي رمزت في دوائر مخّك عبر عددٍ من السّنوات؛ ولكي تكتسب طلاقة في اللّغة الجديدة؛ على مخّك أن ينشأ دوائر جديدة، ورغم أن تكوّن دوائر جديدة في أيّ مرحلة من مراحل الحياة فإنّ صعوبة ذلك تزداد مع التقدّم في العمر» ([104]).
ما نخلص إليه من هذه التّجارب والملاحظات: أنّ الأصل في المخ أنّه يولد كمادّة خام، قابلة للتقولب في أيّ قالب مطلوب، ولاحقًا يأتي التخصّص، وإن أتى التخصّص فإنّه يحجب ما يتضمّنه من قابليّة اتّساعيّة؛ ولكنّه وفي الوقت نفسه لا يمسخها بأن يمنع الاستفادة من الحالة الخاميّة الّتي اضمرت بسبب تمظهر التخصّص، وهو الأمر الّذي يؤكّد عليه ريستاك حين يذهب إلى أنّ ما يحدث عندما ترغب في تعلّم مهارة جديدة، أو الاستفادة من معرفة جديدة، فإنّ أداء التّمارين القائمة على التّكرار يترتّب عليه إنشاء دوائر متخصّصة في مخّك وتقوية ملامحها، وفي الوقتِ نفسه يُمكن –طبقًا لماكليلاند-استرداد القدرة المضمرة بالمران والخبرة ([105]).
إذن، جميع اللّغات والقدرات التّعرفيّة، تأتي مع جميعنا، وجميعها قابلة للتخصّص والتّطوير والتّعديل والاسترداد، وما يترتّب على هذا المضمون بالتّناظر مع المنظور الفلسفي التّضامري هو الاستنتاجات الآتية:
* إنّ الأصل هو الوحدة (الحالة الخامية) القابلة للتعدّد (المتخصّص).
* ما هو مظهر (متخصّص) يضمر لا مثيله القابل للظّهور.
* أي لغة أو وجه يضمر عدد غير محدّد من الاحتمالات الممكنة الّتي لا تُماثله.
طبقًا لهذا النّموذج يمكننا أن نقول: إنّ هناك تناظرًا بين الحالة الخاميّة للمخّ والأبستطولوجيا؛ لأنّ قابليّة التخصّص تُكافئ قابليّة اللّاتخصص في كليهما، وما يرجح التخصّص هو العوامل الخارجيّة. أي أنّ الأبستطولوجيا بدلالة الفسيولوجيا الدّماغيّة هي الحالة الخاميّة.
(2) عندما يُطرح سؤال من قبيل: هل الأبطال يُولدون (جينات فطريّة) أم يصنعون (مهارات مكتسبة)؟ فإنّ القراءة التّضامريّة تنطلق في التّفكيك والتّحليل بالصّورة القائلة: ما دمنا مترددين بين أمرين غير مجزومين؛ فإنّ الحقيقة الّتي قد اصطلح عليها اسم (الحقيقة النّقيّة) تحتملهما معًا، وذلك وَفْقَ قاعدة (بأن لأنّه كان)، فإنّ هذين الأمرين يكونان نظائر للحالة البرزخيّة الّتي وضّحناها في مفهوم الأبستطولوجيا. بتعبيرٍ أيسر: نعدهما في التّضامر وجهين لحقيقةٍ واحدة.
إزاء ذلك يُمكننا وضع أيّ من الصّياغتين الآتيتين:
الأبطال (يولدون لا يولدون -نسبانويًّا).
الابطال (يصنعون لا يصنعون – نسبانويًّا).
في الحالة الأولى: يُولدون بدلالة الجينات ولا يُولدون بدلالة الاكتساب.
وفي الحالة الثّانية: يصنعون بدلالة الاكتساب ولا يصنعون بدلالة الجينات.
وهكذا، فأيّ من الفرضيتين تُؤدّي الغرض من عدّ الاحتمالين قائمين، وَفقًا لدلالة كلّ منهما.
كان العلم يُركّز فيما مضى –ولا يزال بعضهم متمسّك بذلك المنظور التّقليدي- على أساس فكرة وحيدة وهي أنّ الأبطال يولدون لا يصنعون، وذلك تماشيًا مع نظريّة التطوّر. أمّا الدّراسات الحديثة فقد توقّفت عن ذلك الاندفاع الأحادي الاتّجاه، وبدلًا من ذلك تردّدت بين الأمرين، أنّ التّجارب بينت أنّه «لا يوجد حلّ قاطع لمشكلة الوراثة، والبيئة، فالجينات لا تُمارس تأثيرها إلّا في بيئة معيّنة. ومهما كان إسهام الوراثة قويًّا، تظل البيئة هي المتحكّمة في نمو الموهبة وتطوّرها. وعلى الجانب الآخر، هناك إسهام عظيم الأهمية للوراثة لا يُمكن تجاهله مهما كان ضئيلًا» ([106]).
إلى ذلك فإنّ التّساؤل حول الإسهام الوراثي في مقابل الإسهام البيئي حول العبقريّة، ذهب (أنديرس إركسون Anders Ericsson) وهو عالم نفس من جامعة ولاية فلوريدا قضى العشرين سنة الماضية في دراسة العباقرة والموهوبين في مجالات الغوص، التّرفيه، والآداب. أكّد -بقناعة تامّة- عدم وجود مكوّنات وراثيّة تميّز العباقرة، حيثُ يكمن جوهر التميّز-من وجهة نظره-في أن تمتدّ بقدراتك إلى أقصى حدودها وأن تزيد من تحكّمك في أدائك ([107]).
مال (ريستاك) إلى أنّ الوراثة قد لا تُسهم «في النّبوغ ذاته، وإنّما تسهم في قدرة المتميّزين على الإطالة من ساعات التّدريب. بعبارة أخرى: ربما تتضمّن الوراثة ما أطلق عليه علماء النّفس «هوس التفوّق««A rage to master الّذي يعبّر عن قدرة العباقرة والموهوبين على تكريس كلّ ساعات يقظتهم –تقريبًا- للسّعي نحو إتقان تخصّصهم، وطبقا لتلك النّظرية يُمكن لمحترفي لعبة الشّطرنج أن يصلوا إلى درجات الاحتراف نفسها في مجالات أخرى: كالتّنس، والغولف، لو كرسوا جهدهم في سبيل احتراف إحدى تلك الرّياضات بدلًا من الشطرنج» ([108]).
لقد قدّم عالم النّفس (ألفريد بينيه) برهانًا شهيرًا على: «أنّ بإمكان أيّ شخص أن يصبحَ موهوبًا» وذلك عندما قابلَ أداء اثنين من الموهوبين في مجال الرّياضيّات، مع ثلاثة طلّاب جامعيّين، وأربعة من الصّرافين في أحد المحلات الشّهيرة في باريس، فوجد أنّه مع تفوّق الموهوبين بسهولة على الطلّاب الجامعيّين، فإنّ الحال لم يكن كذلك مع موظّفي الصّرافة الّذين كان أداؤهم متفوّقًا على أداء الطلاب الموهوبين، وخاصّة عندما تضمّنت المقابلة عمليّات ضرب بأسرع ما يُمكن لأعداد كبيرةٍ مثل: 7286 – 5397 =؟» ([109]). فإذا ما علمنا أنّ خبرة الصّرافين كانت متأتية من العمل المهني طوال 14 عامًا تضمّنت معدّلات عالية من استخدام الحساب في قياس أطوال الأقمشة وأوزان الأطعمة وترقيم الفقرات وغيرها؛ فإنّ ما يترتّب على ذلك هو معرفتنا أنّ عامل الخبرة المكتسب رجح كفّتهم على كفّة الموهوبين. على هذا فإنّك إذا أردت الوصول إلى إنجاز مستوى متميّز من الأداء في مجال ما؛ يجبُ عليك أن تقاوم ذلك الميل الطّبيعي الّذي يدفعك للوصول إلى أداءٍ آلي بأقصى سرعة ممكنة. فمهما كان الإسهام النّسبي لكلّ من الفطرة والعمل الجاد في النّبوغ فإنّ الأداء المتميّز يقوم بشكل نهائي على المطاوعة الوراثية للمخ. وقد استخلص (ريستاك) ممّا سبق قانونًا يسيرًا وسهل التّطبيق هو: «اختر مجالًا يروقك للعمل والنّشاط، ثمّ اعمل بجدٍّ ونشاط كي تصل إلى إعادة تنظيم كبرى دوائر مخك» ([110]).
في الحقيقية ذات المضمون يُمكن أن ينطبق عن السّؤال بشأن التّساؤل عن الذّكاء وهل يتحدّد عند الميلاد؟ أي: هل نرث مستوى ذكائنا ولا نستطيع أن نتعدّاه كثيرًا، أم لا؟ فقد تبين أنّه و«لحسن الحظّ أنّ ذكاء كلّ منا –حتّى لو لم نولد عباقرة-مرنٌ وقابلٌ للتّغيير. إنّ تكوين الدّوائر العصبيّة للمخّ يتأثّر بمجموع خبراتنا، فكلّما كانت تلك الخبرات أكثر تنوّعًا وغنىً وتحديًّا، ازداد غنى الدّوائر العصبيّة» ([111]).
على هذا نتّفق مع المنظور الّذي يرى أنّ من الأفضل أن تكون نظرتنا للذّكاء مثل نظرتنا للعبقريّة والأداء المتميّز باعتباره وراثيًّا جزئيًّا، ومكتسبًا جزئيًّا أيضًا، بما يسمح بالتّغير. لمّا كان هناك عددٌ من الجينات تُسهم في صياغة بنية المخّ ووظيفته، فإنّ فكرة وجود جين منفرد خاص بالذّكاء أصبحت غير مرجحة إلى حدٍّ بعيد، الصّحيح هو أنّ عددًا من الجينات تجتمع لتُسهم في صياغة ذكاء الفرد وتحديد نمط ذلك الذّكاء، فضلًا عن ذلك فإنّنا نستطيع بجهودنا أن نعدّل من بنية فهمنا، وأن نحسّن جوانب ذكائنا، حتّى ولو لم تزد الدّرجة الكليّة الّتي نحصل عليها في اختبارات الذّكاء المقننة. «وبدلًا من الخضوع بقوى حتميّة فإنّنا نحتفظ بالتحكّم اللّازم لتمكين أمخاخنا من أن تُؤدّي وظيفتها على أحسن ما يُمكن، ويعود الفضل في ذلك إلى مطاوعة المخ» ([112]). وهذا يعني أنّنا يجب أن نتفهم «أنّ للمخّ حدودًا معيّنة يجب علينا قبولها» ([113]).
ما نخلص إليه هنا، هو: أنّ النّتائج العلميّة في هذا المضمار أتت مضاهية إن لم أقل مكافئة لما يتنبأ به المنظور التّضامري من ضرورة اللّاقطع بـ (إما – أو) إلّا إن اقترن ذلك القطع بدلالاتٍ محدّدة مخصّصة. فلا نستطيع أن نقول جينات فقط، ولا نستطيع أن نقول مهارات مكتسبة فقط، بل الاثنين معًا نسبانويًّا. إنّ هذا اللّاقطع يجعلنا نتوقّف مليًّا إزاء الغالبيّة العظمى من التّعميمات غير المقترنة بدلالاتٍ محدّدة لنعيد النّظر إليها، وإنّنا إن فعلنا، فما يترجح وَفْقَ تصورات التّضامر أنّنا سنكتشف كثيرًا من الأخطاء في استبعاد الوجه الآخر من الاحتمالات، وأنّ الصّورة ستكون أمثل في حال أخذ التّكامل بنظر الاعتبار.
(3) بحسب الاختبارات «يستطيع المخّ أن يتعامل مع أكثر من شيء واحد في الوقتِ نفسه على الرّغم من صعوبة ذلك، وإن لم يكن ذلك صحيحًا لما استطعنا أن نسير ونحن نمضغ اللّبان في الوقتِ نفسه» ([114])؛ إذ من الملاحظ أنّ مُعظم النّاس، وحتّى وهم يؤدّون ما نطلق عليه الآن “فكرة التعدّد الأدائي” كانوا يحتفظون بإحساس قوي بالانسجام والوحدة. وقد وضع العلماء مبدأ أسموه (مبدأ الجغرافيّة المخيّة) الّذي مؤداه أنّ: «المخ يعمل بشكل أكفأ عندما تنشط مناطق مختلفة منه بدلًا من المناطق نفسها، ولعّل ذلك هو السّبب في أنّ التّخطيط بالقلم أثناء الحديث في الهاتف لا يمثّل مشكلة لدى غالبيّة النّاس؛ لأنّ كلًّا من الحديث والّرسم يعتمد على مناطق مختلفة من المخ؛ ولكن الحال يختلف إذا تزامن الحديث في التليفون مع كتابة ملاحظة مُعيّنة، فقد يؤدّي إلى إجهاد المخ لأنّ الحديث والكتابة يشتركان في بعض دوائر المخ» ([115]).
إنّ هذا المضمون هو البُعد الفسيولوجي لمفهوم الدّلالة المحدّدة، إذ كما يصعب على المخّ أن يستمع لأمرين مختلفين في الوقتِ نفسه ويقع في ارتباك لأنّ الأمرين يتعلقان بمنطقة واحدة، فكذلك الأفكار والأحكام والمنظورات، يحصل فيها تناقض إن كانت متعلقة بالدّلالة المحدّدة ذاتها. فمثلًا: ميكانيكا الكم تصف الطّبيعة، وأقول ميكانيكا نيوتن تصف الطّبيعة، وأنا أعلم أنّهما ميكانيكيّتان لا متماثلتان، فإنّ هذا يعني أنّ كلامي متناقض مع نفسه؛ إذ إمّا هذه تصف الطّبيعة أو تلك؛ ولكن عندما أقول: إنّ ميكانيكا الكم تصف الطّبيعة في مستوى الجسيمات ما دون الذريّة على حين ميكانيكا نيوتن تصف الطّبيعة في المستوى ما فوق الذريّة، فعند هذا ندرك أنّه لا تناقض في الأمر، وهكذا عندما يشترك أمران في منطقةٍ واحدة فإمّا أن يتطابقا وإمّا يتناقضا؛ ولكن إن اشترك كلّ منهما في تلك المنطقة بنسبة مُعيّنة أو بجانب معيّن فإنّه اشتراط إمّا التّطابق وإمّا التّناقض يرتفع.
ما أقوله هنا: إنّ اشتراط الدّلالات المحدّدة لكبح جماحِ التّعميمات، أمرٌ يتوافق تمامًا مع مبدأ الجغرافيّة المخيّة.
قراءة في النّطاق العصبي: الأنطولوجيا ذات الأبعاد
الواقع الثّالث أو الحقل المتضامر (الأبستطولوجيا) يُمكن أن يلمح في مختلف أنواع النّظريّات أو القراءات أو الأفكار التّشاركية أو العابرة للمنظور الأحادي الاتّجاه، ويأتي قانونا عالم الأعصاب النّمساوي (فيكتور ايميل فرانكل) في الأنثروبولوجيا والأنطولوجيا في هذا السّياق ([116]). فقد اقترح ما يأتي:
القانون الأوّل للأنطولوجيا ذات الأبعاد: «إنّ الظّاهرة الواحدة تُسقِط عن بُعدها الأصلي صورًا مختلفة على أبعاد أدنى عن البعد الأصلي، وعلى نحو تبدو معه الصّور المختلفة مناقضة لبعضها».
فلنتخيّل أسطوانة، ولتكن كوبًا، تسقط ظلالًا عن جسمها ثلاثي الأبعاد. في الحالة الأولى ستعكس دائرة، وفي الثّانية ستعكس مستطيلًا. هاتان الصّورتان (الدّائرة والمستطيل) متناقضتان. هناك ما هو أهم، فالكوب وعاء مفتوح وهذا يتناقض مع الدّائرة والمستطيل اللّذين هما شكلان مغلقان، وهذا تناقض آخر.

القانون الثّاني للأنطولوجيا ذات الابعاد: «إنّ الظّاهرات المختلفة الّتي تسقط على أبعادها الأصليّة صورًا على أبعاد أدنى من البعد الأصلي، تظهر على نحو تبدو معه الصّور مختلطة».
لنتخيّل أسطوانة، وجسم مخروطي، وجسم كروي. إنّ الظّلال السّاقطة على سطح أفقي تظهرهم في صورة ثلاثة دوائر يُمكن أن تحلّ أي منهم محلّ الآخر، فلا يُمكن أن نستدلّ من الظلّ على الشّكل الّذي أسقطه، ما الّذي فوقه، ما إن كان أسطوانة أو مخروط أو كرة.
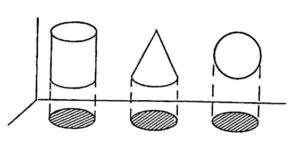
وَفقًا للقانون الأوّل ينتقد ((فرانكل)) النزعات الأحاديّة في التّفسير، فيذهب إلى أنّنا لو أسقطنا نزعات متفرّدة على الإنسان كأن يكون البعد البيولوجي فقط أو البعد السيكولوجي؛ فإنّنا سنحصل على نتائج متناقضة؛ لأنّه في إحدى الحالتين ينتج لدينا كائن بيولوجي، وفي الحالة الأخرى ميكانزيم سيكولوجي؛ ولكن تلك الجوانب الجسميّة والعقليّة للوجود الإنساني الّتي قد تبدو مناقضة إحداها للأخرى إذا تمّت رؤيتها في ضوء الأنثروبولوجيا ذات الأبعاد لا تعود مناقضة لوحدانية الإنسان، فهل التّناقض بين الدّائرة والمستطيل يناقض حقيقة أنّ كليهما انعكاس الجسم الأسطواني نفسه؟ وَفقًا لهذا المنظور يقرأ ((فرانكل)) الكائن الإنساني على أنّه «وحدة برغم تعددية الجسم والعقل»، ووحدته تلك لا يُمكن أن توجد في البعد البيولوجي مفردا أو السيكولوجي متفرّدا، وإنّما يجبُ البحث عنها في البعد المعنوي Noological وهو البعد الّذي انعكست عنه الصّورة الإنسانيّة منذ البداية.
من هنا شدّد على أنّ الخطر هو في محاولة الخبير –وليكن في مجال البيولوجيا-أن يفهم ويفسّر الكينونة الإنسانيّة بالكامل في إطار البيولوجيا. ويصح الأمر أيضًا لعلم النّفس وعلم الاجتماع؛ ففي اللّحظة الّتي يبدأ منها الادّعاء بالكليّة تصبح البيولوجيا نزعة بيولوجيّة، ويصبح علم النّفس نزعة سيكولوجيّة، ويصبح علم الاجتماع نزعة سوسيولوجيّة، وفي تلك اللّحظة يتحوّل العلم إلى أيديولوجيّة، فما يجبُ أن نرثي له في الواقع ليس هو أنّ العلماء يتخصّصون؛ ولكن بالأحرى إنّ المتخصّصين يعمّمون. وقد نَعَتَ حالة أولئك الّذين لا يستطيعون مقاومة إغراء إطلاق عبارات بولغ في تعميمها على أساس مكتشفات بوصف (التّعميم الفظيع). هو يشرح فكرته هذه بسهولة فيقول: «لقد صادفتني مرّة فقرة تضطلع بتعريف الإنسان على أنّه «ليس سوى ميكانيزم بيولوجي معقّد تتم تقويته من طريق نظام احتراق يغذّي آلات حاسبة لها طاقات هائلة لتخزين معلومات شفرية» وأنا بوصفي متخصّصٌ في الأعصاب أؤيد استخدام نموذج الآلة الحاسبة (الكومبيوتر) للنّشاط الّذي يقوم به الجهاز العصبي المركزي. فاستخدام هذا التّشبيه مشروع تمامًا. على أن تكون العبارة من وجهة نظر معيّنة صادقة: الإنسان كومبيوتر؛ ولكن في الوقتِ نفسه يُعدّ أكثر بكثير جدًّا من مجرّد كومبيوتر. فالعبارة خاطئة فقط من حيثُ إنّها تعرّف الإنسان على أنّه: ليس سوى كومبيوتر» ([117]).
وفقًا لذات القانون الأوّل واجه (فرانكل) مشكلة (الحتميّة –حريّة الاختيار) بالمنهج الّذي واجه به مشكلة (العقل – الجسد). فقد بيّن أنّه كما أنّ فتحة الكوب تختفي بالضّرورة على البعدين الأفقي والرأسي؛ فبالمثل الإنسان أيضًا إذا أُسقِطَ على أبعادٍ أدنى من بعده الأصلي يظهر كنظامٍ مغلق؛ وليكن انعكاسات فسيولوجيّة أو ردود فعل واستجابات نفسيّة تجاه مثيرات. فنظريّات الدّافعيّة-الّتي لا تزال تدين بالولاء لمبدأ الهوميوستاز-تتعامل مع الإنسان كما لو كان نظامًا مغلقًا. وهذا يعني إغفال الانفتاحيّة الأساسيّة للوجود الإنساني وإهمالها، تلك الّتي وضّحها على وجه الخصوص عالم البيولوجيا (بورتمان) وعالم الاجتماع (جيلين)، من أنّ الإنسان منفتح على العالم ويُمكن القول إنّه بفضل خاصيّة التّسامي على الذّات فإنّ وجود الإنسان يعني دائمًا الوجود المتوجّه نحو شيءٍ ما أو شخص آخر غير ذاته. إنّ هذا التوجّه يختفي في حالة الاقتصار على البيولوجيا أو السيكولوجيا؛ ولكن في ضوء الأنثروبولوجيا ذات الأبعاد نستطيع في الأقل–كما يرى (فرانكل)-أن نفهم لماذا يجب أن يحدث ذلك؟ والآن، فإنّ انغلاقية الإنسان الواضحة في الأبعاد البيولوجيّة والسّيكولوجيّة لم تعد تناقض إنسانيّة الإنسان، فالانغلاقيّة في بعد أدنى لا تتعارض إطلاقًا مع الانفتاحيّة في بعدٍ أعلى، سواء انفتاح الكوب الأسطواني، أم انفتاح الكينونة الإنسانيّة.
في السّياق ذاته يتواصل (فرانكل) في بيان قانونه الثّاني للأنطولوجيا ذات الأبعاد على الإنسان، فيستعين بالصّورة الثّانية ويذهب إلى أنّنا نحتاج فقط إلى استبدال الدّوائر الثّلاث المختلفة بأنواع العصاب؛ وذلك لأنّ الأعصبة مختلطة وملتبسة. فالعصاب قد يكون نفسي المنشأ، أو جسمي، وقد يكون معنويًّا، وهو الّذي ينشأ عن الصّراعات الخلقيّة أو ما أسمّيه بالإحباط الوجودي، أو الفراغ الوجودي.
بحسب (فرانكل) فإنّه كلّما كانت العوامل الاتيولوجية Etology (أي: العوامل المسبّبة للمرض) متعدّدة الأبعاد، صارت الأعراض مختلطة وملتبسة، وكما لم نتمكّن من أن نستدل من الظّلال الدائريّة عمّا إذا كان الشّكل الّذي فوقها أسطوانة أو مخروط أو كرة؛ فإنّنا لا نستطيع أن نستنتج ما كان زيادة إفراز الغدة الدرقيّة، أو مخاوف الخصاء، أو الفراغ الوجودي هو سبب العصاب. في الأقل لا نستطيع أن نعرف ذلك ما دمنا اقتصرنا البحث في البعد السيكولوجي. إنّ ايتولوجية الأعصبة المتعدّدة الأبعاد تتطلب وَفْقَ المنظور الفرانكلي ما يسمّيه (التّشخيص ذو الأبعاد Dimensional Diagnosis)؛ وهذا يؤول بالنّتيجة إلى مضمون ثوري -في حينه في الأقل-هو أنّ العلاج يجب أن يُوجّه على نحو متعدّد الأبعاد، حيثُ يُمكن أن يكون العلاج بالحقن أو الصّدمات الكهربائيّة أو العقاقير وفي بعض الحالات الاستثنائيّة قد تكون إجراء جراحة مخيّة، أو العلاج النّفسي أو العلاج بالمعنى، فلا يتوقّف الأمر على نوع من العلاج وإنكار مصداقيّة أنواع العلاج الأخرى، بل يجب الأخذ في الاعتبار أنّنا لا نتعامل مع مجرّد أمراض ولكنّنا نتعامل مع كائنات إنسانيّة، وبحسب (فرانكل) فإنّ «كون الإنسان إنسانًا يعني العيش في مجال التوتّر القائم بين الواقع وبين المثاليّات الّتي يتمّ العمل على تحقيقها» ([118]).
إنّ ممّا يُمكن قراءته أو ملاحظته بشأن المنظور الفرانكتلي اللاأحادي هو النّقاط الآتية:
(1) توظيفه التصوّر الهندسي بما يتضمّنه ذلك التصوّر من قضايا تتعامل على وجهٍ طيّع مع الأبعاد في تحليل الأنطولوجيا والأنثروبولوجيا، واستنتاجه من تلك المقاربة مفهومات تناظريّة بينهما بطريقةٍ تحقق الحالة الإكماليّة بينهما، وهو ما تحدّث عنه بلا مواربة حين قال: «حاولت شخصيًّا أن أقوم بالواجب في وقت واحد نحو الفروق الانطولوجيّة والوحدة الأنثروبولوجيّة من طريق ما اسميه: الأنثروبولوجيا والانطولوجيا ذاتا اللأبعاد. هذا المدخل يستفيد من التصوّر الهندسي للأبعاد كمثال الفروق الكيفيّة الّتي لا تحطّم وحدة البنية» ([119]). هذا -كما هو واضح- تطبيق دقيق لقوانين التّضامر الثّلاثة. فأمّا القانون الأوّل؛ فمن حيثُ أنّ وجود الأبعاد في الهندسة يضمر الدّلالة على وجود الأبعاد في الأنطولوجيا والأنثروبولوجيا. أمّا القانون الثّاني؛ فمن حيثُ أنّ معلوم ما يترتّب على الأبعاد في التصوّر الهندسي كشف (لفرانكل) ما تضمره الأبعاد الانطولوجية والأنثروبولوجية. على حين تمثّل القانون الثّالث في أنّ (فرانكل) غادر فضاء التّشخيص الأحادي والعلاج القطعي إلى فضاء متعدّد للأبعاد إمّا في التّشخيص أو العلاج؛ ما يعني أنّه بات يعي أنّ إجابة المريض تحمل في طيّاتها مضمرات لأكثر من بُعد؛ أي أنّه يتحصّل أكثر إجابة للسّؤال الواحد.
(2) التّضامر يبدو واضحًا في آراء (فرانكل) الجامعة للوحدة والتعدّد في آن، إذ ما التّضامر إلّا تلازمات ممكنة بين لا متماثلات، وكل تلازم ممكن مقترن بدلالته المحدّدة. نقول ذلك ونحن نقتبس عن (فرانكل) قوله: إذا كان (توماس الاكويني) يقول: «الإنسان وحدة متعدّدة الأوجه». وإذا كان تعريف الفن هو «الوحدة في التعدد» فإنّني أُعرّف الإنسان على أنّه «وحدة برغم التعدّد» ([120])؛ إذ ممّا يتّضح من هذا الاقتباس أن كلّ من (الاكويني) و(الفن) و(فرانكل) يمثل إنعكاسًا أدنى للحقيقة العليا الجامعة للوحدة والتعدّد، كما ينصّ قانونه الثّاني.
(2-1) إنّ تلك الحقيقة يُمكن أن تكون بذاتها متعدّدة الأوجه كما يرى (الاكويني)، فأنّا أمثّل وجهًا من الإنسان، وغيري يمثّل وجهًا آخر من الإنسان، ومفهوم الإنسان ومع أنّه واحد في ذاته إلّا أنّه متعدّد الأوجه في مصاديقه. في الوقتِ الّذي تنقلب فيه الآية في منظور الفن، فإنّ التعدّد هو الحقيقة الخارجيّة، والفنّان يستحضر عناصر الوحدة في عمله الفني، فيكشف عن أنّ ذلك التعدّد ليس إلّا تعدّدًا في الوحدة، أو بتعبيرٍ آخر: وحدة متعدّدة. فالحياة –مثلًا- يُمكن أن تلمس في الأشجار وفي الأنهار وفي الطّفولة وفي الأمطار وفي حنان الأمومة، فهذه تمظهرات متعدّدة مختلفة عن بعضها؛ ولكنّها تنضوي على المعنى نفسه. على حين يأتي منظور (فرانكل) ليخبرنا أنّ التعدّد هو الأصل الباعث لزومًا للوحدة المضمرة؛ مع أنّني أختلف عن غيري من النّاس، وأن كلّ واحد منّا يشعر باستقلاليته عن غيره، وأنّني في الشّكل والمضمون لا أماثل البقيّة؛ إلّا أنّنا جميعًا –ومع ذلك كلّه- نشعر بأنّنا نشترك في الخصائص الأصليّة ذاتها فيزيولوجيًّا وسيكولوجيًّا وجميع الأبعاد الأخرى؛ فالوحدة بين بعضنا بعضًا موجودة على الرّغم من التعدّد وجودًا تلازميًّا، وهذا كما بيّنا ينسجم مع مفهوم التّضامر الّذي يستوعب مثل هذه التلازمات بين اللامتماثلات.
(2-2) ومن جانب آخر، فإن تلك الآراء الثّلاثة بشأن طبيعة العلاقة بين (الوحدة والتعدّد) ما هي إلّا احتمالات ممكنة، بل ومستفادة من طبيعة الواقع الثّالث (الأبستطولوجيا)، وما اختلفت في الطّرح بين (الاكويني) و(الفن) و(فرانكل)، وربّما ما غيّرهم إلّا بسبب اختلاف الدّلالات المحدّدة، إذ كلّ وجهة نظر ترتكز إلى دلالة خاصة لتتشكّل، وكل منها تعطينا تصوّرًا آخر عن ممكنات ذلك الحقل المتضامر.
(3) عندما تختلف الدّلالة يختلف المنظور، وعندما يختلف المنظور يختلف السّؤال، وعندما نحصل على إجابة جديدة، ولمّا كانت دلالة (فرانكل) مختلفة لكونها كانت ذات أبعاد، فقد انتقل سؤال (فرانكل) عن الإنسان من مستوى الماهيّة إلى مستوى الآينية، وقد عبر عن ذلك الانتقال بوجهٍ سلسٍ حين قال: «قبل أن نجيب عن تساؤل كانط ما الإنسان؟ يجبُ أن نلتفت إلى السّؤال: أين الإنسان؟ وفي أيّ بعد يُمكن أن توجد إنسانيّة الكائن الإنساني؟ فإذا اعتمدنا النّزعة الاختزاليّة وأصدرنا حكمًا سابقًا بأنّ الإنسان ما هو إلّا حيوان فلن نكتشف شيئًا آخر، وفي هذا شبه الطّرفة الّتي تحكى عن حاخام احتكم إليه رجلان يعتقد أحدهما أنّ قطّة جاره سَرقت منه خمسة أرطال من الزّبد والتهمتها، والآخر يردّ بأنّ القطّة لم تأبه للزبد في حياتها، فوزن الحاخام القطّة ولدهشته وجدها تزن خمسة أرطال بالضّبط. فقال: لدينا الزّبد الآن؛ ولكن أين القطة؟ حسنًا، فأين الإنسان إذن عندما يقتصر بحثنا عن البعد البيولوجي ويكبّل بالإسقاطات البيولوجية؟» ([121]). ما يقوله (فرانكل) هنا هو: هناك شيء وهناك معنى لهذا الشّيء، فإن ظهر أنّ الشّيء قابل للتجزئة فإنّ المعنى يتسامى عن ذلك، ما يكشف عن اجتماع لا متماثلين اجتماع تلازم؛ أيّ وبتعبير التّضامر: وجود الشّيء يضمر وجود لا مثيله وهو المعنى وجودًا تلازميًّا لا فكاك منه.
(3-1) الحقيقة قد تكون وجهة نظر (فرانكل) هنا قيّمة، وقيّمة جدًّا بدلالاتها؛ ولكنّني -ووفقًا لمبادئ التّضامر- أعتقدُ أنّها -وفي تفصيله منها- وقعت لا إراديًّا في قصور ذاتي يصعب حتّى على التّضامر –أحيانًا-الإفلات من الوقوع فيه؛ وذلك أنّ (فرانكل) نفى إمكانيّة تكبيل الإنسان كحقيقية أنطولوجيّة ببعد وحيد وليكن البيولوجيا مثلًا، فهذا التّكبيل يختزل الحقيقة في إطار أحادي هي في حقيقتها أشمل وأوسع منع بكثير. وبدلًا من ذلك ينبغي -كما يرى- أن نعي تمامًا أنّ تلك الحقيقة قابلة للتعدّد، ويُمكن قراءاتها بأكثر من وجهة، وهذا إن تأمّلنا فيه، نلمح أنّه ينقل الفكرة من النّقيض الأُحادي إلى النّقيض التعدّدي، فالأوّل يقتصر على الاختزال، على حين يقتصر الثّاني على اللاختزال، أمّا التّضامر فيتّسع فضاؤه ليشمل كلّ منهما نسبانويًّا وذلك وَفْقَ الصّيغة (اختزال لا اختزال – نسبانويًّا). ما يعنيه ذلك هو: أنّنا نتفهّم أن يكون المنظور للإنسان منظورًا بيولوجيًّا فقط، أو سيكولوجيًّا فحسب؛ ولكن شريطة أن يقترن المنظورين بدلالته. بمعنى: يُمكن للمتخصّص في البيولوجيا أن يقول مثلًا: الإنسان ليس أكثر من بيولوجيا؛ ولكن عليه أن يلحق بتعميم هذه اللّاحقة القائلة مثلًا: بدلالة البيولوجيا أو من حيثُ البيولوجيا، ويُمكن للسيكولوجي أن يقول: ليس الإنسان سيكولوجيًّا أكثر من سيكولوجيا. هذا ما نعبّر عنه بـ (الإطلاق النسبانوي)، فلا يمتنع في التّضامر اختزال بحدّ ذاته بل ما يمتنع هو عدم اقترانه بدلالةٍ محدّدة تجعل من أطلقه نسبانويًّا.
(4) يرى (فرانكل) أنّ من المشكلاتِ الّتي تواجه العمل العلمي أنّ «العلم لا يستطيع التّعامل مع الحقيقة في تعدديّة أبعادها؛ ولكن يجب أن يتعامل مع الحقيقة كما لو كانت ذات بُعد موحد» ([122])، وهي رؤيّة حصيفة، ولكن السّؤال: هل العلم كمنهج لا يستطيع التّعامل مع الحقيقة في تعدّد أبعادها، أم النّزعة العلميّة الرّازحة تحت ثقل القصور المعرفي الذّاتي؟ يبدو لي عندما أقرأ مواقف العلماء بين الفيزياء الكلاسيكيّة والفيزياء الحديثة أنّ هناك نزعةً تُحاول التشبّث في تكييف العلم مع ما تنزع إليه، لا أن تنفتح مع الإمكانيّة الاتّساعيّة فيه.
(5) رأيتُ من اللّطيف أن نختم مع (فرانكل) في المضمون العميق لهذه القصّة الّتي سردها: «هاجم صعلوك صاحبة متجر، وفي غمرة فزعها صرخت: «فرانز» وهو زوجها، وكان هناك ستار يفصل شطري المتجر، فتوقع الصّعلوك أن فرانز سيقفزُ من خلف السّتار ليقبض عليه، فهرب؛ ولأنّها كانت تصرخ سمعها الجيران فقبضوا على الصّعلوك. هذه نتيجة منطقيّة لأحداث طبيعيّة؛ ولكن الحقيقة أنّ (فرانز) كان قد مات قبل أسابيع، وأنّ زوجته كانت تُرسل صلاتها إلى السّماء تتوسّل زوجها أن يتوسّط إلى الله من أجل حمايتها لأنّها تشعر بالوحدة. السّؤال الّذي تعرّض له (فرانكل) هو: سبب حماية هذه المرأة ونجاتها؟ هل السّبب هو الالتباس
الّذي وقع فيه الصّعلوك، أم أنّ السّماء استجابت للدّعاء؟
يرى (فرانكل): أنّ الحقيقة سوف تختزل في رغبتنا نحن حول أيّ من التّفسيرين هو الحقيقة. ثمّ يعقب قائلًا، وما أدقّ ما قال: «أمّا عنّي أنا فاعتقد أنّه لو كانت هنا كمثل هذه السّماء، ولو كانت تستجيب للدّعاء، فإنّها سوف تخفي ذلك وراء نتيجة منطقيّة لحقائق طبيعيّة» ([123])، وواضح من وجهة نظره، أنّنا لسنا في حاجة إلى إفتراض التّناقض، ما دُمنا قادرين على تصور إمكانيّة تراكب المظهر والمضمر في بنية حدث واحد. لسنا في حاجة للاختزال في نظرة اجتزائيّة ثمّ تعميمها وكأنّ لا تصوّر آخر يصلح أن يكون بديلًا عنها.
قراءة في النّطاق السّيكولوجي: الوعي واللّاوعي
(1) ممّا هو متقرّر لدى علماء النّفس أنّ الإدراك الإنساني ينشئ عن طبيعة مزدوجة في الذّهن، أحد شرطيها يُسمّى الوعي والشّطر الآخر يُسمّى اللّاوعي، أو كما يطلق عليهما (كارل غوستاف (يونغ)) (الواعية/ الخافية) ([124]). الأمر الّذي يسمح بعقد التّساويات المبيّنة في الآتي:
الوعي أو الواعية في علم النّفس = المُظهر في التّضامر
اللاوعي أو الخافية في علم النّفس = المُضمر في التّضامر
ولمّا كنّا نعلم بعضًا من خصائص المضمر وبعضها من خصائص اللّاوعي، فهذا يعني إمكانيّة استخدام قانون التّضامر الثّاني لاستكشاف مجهول أحدهما من معلوم الآخر. وكما سيتبيّن.
(2) إنّ النّظر بشكل مجرّد إلى ثنائيّة: (وعي/ لا وعي) تُعطينا دلالة أوليّة مفادها: التّقابل بين التعين وسلبه، أو الوجود ونفيه؛ ولكن علم النّفس، إنّ للوعي واللّاوعي معانٍ متميّزة، تتجاوز ما تتضمّنه الثّنائيّة المجرّدة، الوعي: هو ما يُكوَن لدى الإنسان من أفكار وذكريات وخيال ومفهومات عن الحياة والطّبيعة ([125]). أمّا اللّاوعي: فهو وَفْقَ النّظريّة الفرويديّة ([126])، محتويات ذهنيّة تقمعها التربية منذ الطّفولة، فتُدفَن تحت حاجز الكبت الّذي يمنعها من الوصول إلى الوعي. تستمرّ هذه المحتويات في التّأثير في الوعي، وهي قابلة لأنّ تشكل جزءًا منه ([127])، وهو حسب (يونغ) يتضمّن أكثر من المحتويات المكبوتة، كالمواد الّتي تبلغ الشّدة الّتي تمكّنها من عبور عتبة الوعي، والمواد الّتي لم تعد محفوظة بتوتّر نفسي كافٍ في الوعي أيضًا؛ إذ تنزلق إلى ما تحت عتبته، والمواد الّتي نشأت وستبلغ عتبة الوعي لاحقًا، والمواد الّتي تجعل اللّاوعي منشغل دائمًا في خلط محتوياته وتجميعها وإعادة تجميعها ([128]).
ما يتبيّن من ذلك: أنّ الوعي شيء له مضمونه الخاص، واللّاوعي شيء آخر له مضمونه الخاص أيضًا. ليس اللّاوعي هو نفي الوعي بمعنى سلبه أو عدميّته، بل بمعنى الوجود المغاير له، ولعلّ مقولة (يونغ) من أنّ «كلّ ما يحدث في الواعية يُمكنه أن يحدث في الخافية في شروط معيّنة» ([129])، هي أبلغ تعبير عن الفاعليّة الإيجابيّة اللّامتماثلة لكلّ من الوعي واللّاوعي.
لقد رأيتُ أن أستفيد من مفهوم (لا) الإيجابي ضمن هذا التصوّر، لآتي بتعميمٍ يكون أشمل من النّفي أو النّهي أو التّعاكس، حين استخدمتُ هذه اللا في مفهوم (اللامثيل) ليكون تعبيرًا عن الوجه الآخر المحتمل الّذي نعرف بعضه ولا نزال نستكشف في بعضه الآخر.
(2-1) ما أقوله هنا -ولسوف أتطرّق إليه في أكثر من مكان في هذا الكتاب-هو أنّنا حين نقول مثلًا:
(أ) تضمر (لا أ) أو (الكتاب يضمر لا كتاب) أو (1 يضمر لا 1) أو ما شابه ذلك، فإنّنا جميع الأمثلة، نقرأ ما هو مقترن بـ (لا) كقراءتنا لمفهوم (اللاوعي). أنّه ليس المعاكس بل اللامثيل الإيجابي، ذلك الّذي يتضمّن جميع الاحتمالات الممكنة، كما يتضمنها مفهوم اللاوعي.
لنتصوّر مشهدًا ليليًّا لا يرى فيه شيء البتة، ولنتصوّر أنّ لدينا مصباحًا يدويًّا (لايت)، يُنير لنا مساحة محدودة من ذلك الظّلام المعتم، فوفقًا للقراءة النفسيّة، إنّ كلّ ما يظهر في ضوء المصباح يُماثل الواعي، وكل ما يقبع في الظّلام فيما وراء ذلك فهو يُماثل اللاوعي (الخافية)؛ ولكن ومع أنّ هذا الّذي في الظّلام حقيقي وفعّال إلّا أنّه غير مشعور به. فإذا انتقل الضّوء من موقعه الأوّل، غاصت المحتويات الّتي كانت واعية، وجاءت محتويات جديدة إلى الرّقعة المنيرة، ليتحوّل بعض الوعي إلى لا وعي ويتحوّل بعض اللّاوعي إلى وعي. وفي جميع الأحوال فإنّ المحتويات الّتي تتلاشى في الظّلمة تظلّ فاعلة وتشعرنا بنفسها ([130]). فنحنُ إذن، إزاء شيئين لا متماثلين بدلالة المضمون، وإن كنّا نصف الوعي واللاوعي بأنّهما شيئان، فلا يعني أنّهما متمايزان عن بعضهما بعضًا بحدٍّ فاصل بينهما؛ مع أنّ مواصفات الوعي تختلف عن مواصفات اللاوعي كما بيّن فرويد و((يونغ)) وغيرهما. في الحقيقة نميلُ إلى وصف ذلك بالتّتام النّاتج عن الأصل المتضامر.
(2-3) ما ذهب إليه (يونغ) من أنّ ما يحدث في الوعي يُمكن أن يحدث في اللاوعي بشروط معيّنة، يُشير إلى نقطتين مُهمّتين:
الأولى: التّناظر بين الشّروط المعيّنة في علم النّفس والدّلالة المحدّدة في التّضامر.
الثّانية: لعلّ العلاقة بين الأنطولوجيا والأبستمولوجيا كالعلاقة بين الوعي واللاوعي –مع الفارق- ولعلّنا نكتشف أنّ هناك حقلًا مشتركًا بين الوعي واللاوعي نظيرًا للأبستطولوجيا.
(3) في دراسة (ليونغ)، حاول فيها أن يُعطي تصوّره عن اللّاوعي (الخافية) وطبيعة محتوياته، يذهبُ فيها إلى أنّ محتويات اللّاوعي تراكم في بنيتها النّماذج البدْئية Archetypes للمجتمع البدائي، بل تمتدّ تلك الجذور حتّى تشمل جميع أشياء الطّبيعة من حيوان ونبات، وأنهار وجبال، وهلم جرّا، وهي في الوقتِ نفسه صور وعواطف موروثة مع بنية الدّماغ. فمن جهة تلك المحتويات البدئيّة تصل النّفس بالطّبيعة (الأرض والعالم)، ونحن نرى التأثير النّفسي للأرض وقوانينها على أوضح ما يكون في هذه الصّورة البدئية. على حين من جهة أخرى لدينا الدّماغ وتواصله معها ([131]).
وها نحن نجد أنفسنا أمام ثنائية في النفس جامعة لأصلين متراكبين: ذاتي ذي توجه داخلي متمثل بمعطيات الدماغ وذاتي ذي توجه خارجي متمثل بالمعطيات البدئية. وأي طبيعة بمثل هذا التراكب نصفها بالمتضامرة، لكونها جامعة للوجه ولا مثيلة.
(4) هناك نظريّة نفسية تبدأ من مسلّمة أنّ النّفس البشريّة هي نفسها في كلّ مكان، وأنّه يُمكن تفسيرها تبعًا لذلك على النّحو نفسه بصرف النّظر عن الظّروف المحيطة. يُذكّرنا هذا بالمنظور العلمي الّذي يتعامل مع الطّبيعة على أنّها واحدة في كلّ مكان، فما يُمكن استنتاجه هنا، يُمكن استنتاجه في أيّ جزء من أجزاء الكون؛ ولكن -وفي علم النّفس- يربك ذلك الفرض وجود ما لا يكاد يحصى من الفروقات النفسيّة الفرديّة –كما يؤكد (يونغ) ([132])– الأمر الّذي يعطينا قراءة تضامريّة عن أنّ ثمة خروقات فرديّة في الحقل العلمي، ولعلّنا نسجّل من بينها، المتفرّدة الأولى الّتي توّلد منها الكون بحسب نظريّة الانفجار العظيم، وتلك المتفردات الّتي تعرف باسم (الثقوب السّوداء)، وهناك مثلًا الّتناظر الفائق، وغيرها. فما يبدو لنا هنا، أنّ هناك معطياتٍ متناظرة بين حقلين لا متماثلين: النّفس والفيزياء؛ الأمر الّذي يفتح الباب إزاء استخدام قوانين التّضامر لاستكشاف ما يُمكن استكشافه من مضمرات متكاملة فيهما.
من جانب آخر، يُمكن صياغة علاقة تضامر بين مفهوم واحدية طبيعة النّفس البشريّة وبين ما يُسمّى بالحوض الجيني المشترك بين الكائنات (DNA) ([133])؛ إذ لمّا كان ذلك الجينوم ومع أنّه مشترك بين الكائنات الحيّة؛ فإنّه لم يلغِ التفرّد النّسبانوي بين الكائنات، فإنّ الأصل المشترك لا يعني التّطابق بل إمكانيّة التّكامل، وما دامت إمكانيّة فهي ليست قطعيّة بل احتماليّة، أي تصلح في حالات بنسبة 100% وتصلح في حالات أخرى بنسب متفاوتة، إضافةً إلى أنّها لا تصلح في حالاتٍ أخرى بنسبة 100% أيضًا، فالأصل المشترك يعني التفرّد القابل للتّشارك. ومن هنا يُمكن القول إنّ (يونغ) لم يجانب الصّواب عندما لم ينخدع بواحدية النّفس البشريّة على حساب الفروقات النّفسيّة الفرديّة، مثلما أنّه لم ينخدع بالوقوف عند شطر الفروقات الفرديّة من دون الأخذ بواحدية النّفس البشريّة في كلّ مكان.
لمّا كنّا نتحدّث عن علاقة تضامر بين الجينوم والنّفس البشريّة، ولمّا كنّا نعلم أنّ العلماء قد اكتشفوا نوعًا مميّزًا أو خاصًّا من الجينوم، يكاد يكون ليس من كوكب الأرض كما ذكر بعض العلماء؛ فإنّ ذلك ووفقًا لقانون التّضامر الثّاني، يضمر الدّلالة على إمكانيّة وجود طبيعة نفسيّة متميّزة جدًّا، تكاد تكون مباينة لطبيعة النّفس البشريّة المعروفة؛ مع أنّها متكيّفة مع الواقع تكيّفًا يكاد يكون تامًّا. ولربما يُمكن أن تكون نفوس الأنبياء والأولياء والباراسايكولوجيين وذوي المواهب غير التقليديّة من هذا الصّنف الطّافر.
(4-1) يذهبُ (يونغ) في تحليله إلى أنّ مصدر فكرة المساواة بين نفوس النّاس التي تفترض أنّ ما يسرّني لا بدّ وأن يسرّ كلّ شخص سواي، هي ليست أكثر من البقيّة الباقية ممّا يصفه باللّيل البدئي، ليل الخافية (اللاوعي) عندما لم يكن ثمّة فرق ظاهر بين (أنا) و (أنت)، وعندما كان كلّ أحد يفكر ويشعر ويتصرّف بالطّريقة نفسها، ويشدّد على أنّ هذا الرّجع البدئي ما زال حيًّا فينا نحن أيضًا، بدليل أنّنا سرعان ما نتّخذ موقفًا عدوانيًّا عندما لا يشاطرنا شخص معتقداتنا! نشعر بإهانة عندما يجد شخص فكرتنا عن الجمال باعثة على المقت. وما زلنا نضطهد كلّ من يفكّر تفكيرًا مختلفًا عنًّا، وما زلنا نُحاول أن نفرض آراءنا على غيرنا، وأن نهدي الكفار المساكين إلى الإيمان الصّحيح لكي ننقذهم من نار جهنم الّتي لا ريب تتربّص بهم، وما زلنا جميعًا نخاف خوفًا لا حدود له من الوقوف وحدنا مع معتقداتنا. وما يُفكر فيه (يونغ) أنّ المساواة النّفسيّة بين جميع النّاس مسلمة مستمّدة أصلًا من غياب الفرد عن الشّعور بنفسه، في ذلك العالم الضّارب في أعماق الزّمان حيثُ لم يكن ثمّة واعية فردية، بل نفس واعية جامعة فقط ظهر منها تدريجيًّا واعية فرديّة في المستويات العليا من التطوّر ([134]).
ويخلص (يونغ) إلى أنّه إذا كان الوعي يدفع باتّجاه التفرّد، فإنّ اللاواعي يسحب باتّجاه اللاتفرد. في الحقيقة، إنّ الإنجاز المتفرّد إذا ما شعر المجموع أنّه يعود إليه بالنّفع على قدم المساواة فإنّه يتقبّله ويحتضنه وليظهر بمظهر المنجز الجماعي. أمّا الإنجاز المتفرّد الّذي يعود بالنّفع على القلة أو الاحاد، فإنه يبقى مبعدا، وكأنه لا قيمة له.
وهنا عليّ قول الآتي: في المرحلة البدئية –كما يصفها (يونغ)- حيثُ كان اللاوعي هو الطّاغي، وحيثُ المشاعية هي السّائدة، وحيثُ المساواة الجماعيّة كانت حقيقة أوّليّة، هل خاصيّة التفرّد كانت موجودة أم لا؟ إن كانت موجودة فلماذا لم تكن ظاهرة؟ وان كانت غير موجودة فمن أين أتت إذن؟ وفقًا للتّضامر، خاصيّة الوعي واللاوعي وجهان متتامان لحقيقة واحدة، وهذا يعني إن كان أحد الوجهين مظهرا فإنّ الآخر سيكون مضمرًا له. اليوم مثلًا وفي مجتمعات الملكيّة الخاصّة أو الفرديّة، نعلم أنّ تلك النّفوس تضمر لا مثيلها، تضمر تلك الحالة المشاعيّة. وبتعبيرٍ آخر: ليس الأصل البدئي هو اللّاوعي ونشأ منه الوعي كما يرى (يونغ) –إلّا بدلالته- بل الأصل البدئي هو الحالة المتضامرة للوعي واللاوعي الّتي لا نستطيع أن نتصوّرها إلّا إن فصلنا بينهما ولو نظريًّا، وهو ما يُمكن صياغته بالصّيغة: (الوعي لا الوعي – نسبانويًّا).
(5) من كبرى النّظريّات في علم النّفس نظريتان لا متماثلتان، إحداهما تفسّر عالم الظّاهرات النفسيّة في صيغة الكبت الجنسي، والأخرى تفسّرها بالكبح السّلطوي. وكان من نتيجة هذا التّضاد بين النظريّتين أن تمسكت كلّ منهما أشدّ التمسّك بمبدئها وأبدت ميلًا واضحًا إلى إقامة نفسها مصدرًا وحيدًا للخلاص ولا شيء غيرها. لكن ومع أنّ أتباع هاتين النظريتين يبذلون أقصى ما في وسعهم في تجاهل وجود إحداهما للأخرى؛ فإنّ هذه المواقف المتطرّفة لا تفعل شيئًا من أجل حل التّناقض القائم بينهما؛ ومع ذلك فالجواب -كما يراه (يونغ) ونتفّق معه- جد يسير، وهو: أنّ كلتا النّظريتين صحيحة بمقدار ما تصف كلّ منهما السيكولوجيا الّتي تشابه أتباع كلّ منهما ([135]). أو بحسب تعبيراتنا، كلتا النّظريتين صحيحة نسبانويًّا؛ لأنّ كلّ منهما مقترنة بدلالة محدّدة خاصّة بها تدعمها دعمًا تامًّا.
وَفقًا للتضامر، فإنّ التّفسيرَ الّذي يستندُ إلى الغريزةِ الجنسيّة والتّفسيرَ الّذي يستندُ إلى غريزةِ السّلطة هما تفسيران مُتتامان؛ ولهذا فإنّ الفريق الّذي يعتقد بأحدهما لا يستطيع أن يرى الوجه الآخر. على حين الحقيقة كما تقرّرت لدى (يونغ)، وكما تتقرّر في التّضامر أنّهما وجهان لحقيقةٍ واحدة.
(6) يقول (يونغ): «بعد أن انفقتُ السّنين الطّوال في الأبحاث النّفسيّة، تشكّل تدريجيًّا في نفسي شيء، كما قد تشكّل في أذهان غيري من الباحثين، وهو: البديهية الأساسيّة الّتي تُفيد أنّ ظاهرة نفسيّة ما يجب إلّا يُنظر اليها أبدًا من جانبٍ واحدٍ فقط، وإنّما من الجانب الآخر أيضًا. فقد أظهرت الخبرة أنّ لكلّ شيء جانبين في الأقل، وأحيانا جوانب كثيرة» ([136]). وكما هو واضح هنا، فإنّ البديهيّة النّفسيّة اليونغيّة تأتي في سياق تأكيد مبدأ التّضامر، وما يضمنه من توقّع وجود الاحتمالات اللامتماثلة دائمًا.
(7) ممّا يتحدّث عنه (يونغ) فرضيّة نفسيّة معتبرة، نصّها: «أن كلّ ظاهرة نفسيّة إنّما يعوضها ضدها، وَفْقَ مقولة: الأطراف تَتَماس» ([137])، ومعنى هذا هو أنّ القانون السّيكولوجي يرتكزُ على مبدأ التّعويض بالضّد الدّاخلي، كما يوضح (يونغ) في محلٍّ آخر. وانطلاقًا من هذه الفرضيّة يذهب ليرجح فكرة غريبة وهي أنّ مرض الفصام هو في سياق المعافاة، أو أنّ ما يحدث الانقسام يخلق الاتّحاد في نهاية المطاف. ونحن لو افترضنا أنّ القراءة السّطحيّة لهذا المنظور تندرج ضمن جدليّة هيغليّة أو ديالكتيكيّة، فسيكون هذا هو الحدّ الأدنى المقبول من التّضامر؛ إذ هي رؤية تُعطينا انطباعًا أنّ الحالة النّفسيّة لا تفارق لا مثيلها، ووجود أو رؤية وجهة منها ينذر أو ينبئ بوجود الوجه الآخر وجودًا تلازميًّا كما هو مقرّر في التّضامر.
(8) في موقف منسجم مع الاحتماليّة التّأويلانويّة في التّضامر لكلّ شيء حتّى بشأن تلك الّتي تتعلّق بالظّواهر الطّبيعيّة وَفْقَ دلالاتها، يأتي (يونغ) ليعطينا مُقابلة (نفسيّة – طبيعيّة) بين تفسير الأحلام وتفسير الظّواهر الطّبيعيّة؛ إذ يذهب إلى التّشديد على أنّه مقتنع «بأنّه لا يوجد منهج لتفسير الأحلام يركن إليه ركونًا مطلقًا. حتّى الثّقة المطلقة في تفسير الحوادث الطّبيعيّة لا نجدها إلّا في أضيق الحدود؛ أي عندما لا يأتي من التّفسير أكثر ممّا نضع فيه. كلّ محاولة لتفسير الطّبيعة فهي مخاطرة. نحن نعلم أنّ فرويد ألّف كتابًا في تفسير الأحلام؛ ولكن تفسيره ليس إلّا مثالًا على ما قلناه للتو: لا يأتي منه أكثر ممّا تسمح نظريّته بأن تضعه في الحلم» ([138]).
إنّ هذا تقييم جدير بالتوقّف عنده والإفادة من عمقه، إذ ما يخبرنا به (يونغ) هنا أنّ النّظريّات النّفسيّة والطّبيعيّة قد تُعطينا أجوبة؛ ولكن تلك الأجوبة ليست مجرّدة، أو شفّافة أو ناطقة عن الحقيقة كما هي، أو كما نُريد أن نتصوّر، بل هي تُعطينا من الحقيقة بالطّريقة الّتي تضفيه هي نفسها على الحقيقة من صبغة أو انطباع، وما ينتج عن ذلك، أنّ ما نعرفه ليس بريئًا منّا براءة مطلقة كما يرى بعضهم.
قراءة في النّطاق الفلسفي: تفنيديّة (بوبر)
يرى (بوبر) أنّ التّخمينات التأمليّة المتعلّقة بالعالم حين لا ينطبق عليها مبدأ إمكان التفنيد-Falsifiability تكوّن نظريّات ميتافيزيقيّة ([139])، ويعتقد أنّ هذا المبدأ يزوّدنا بمعيارٍ نستطيع بواسطته تمييز القضايا العلميّة من القضايا غير العلميّة، فالقضايا العلميّة هي القضايا ممكنة التّكذيب، والثّانية لا يُمكن تكذيبها، أمّا القضايا الّتي لا ينطبق عليها مبدأ التّفنيد هذا فهي قضايا ميتافيزيقية ([140]).
إذ مِنَ المعرو ف أنّ النّظريّة تُسمّى (علميّة): إذا كانت هناك إمكانيّة لإثباتها تجريبيًّا أو اختبارها أو قياسها بوجهٍ عمليّ. ومِنَ المعروفِ أيضًا، أنّه كلّ ما كثُرت التّطبيقات والتّجارب المؤيّدة لها، كان ذلك أدعى لقوّةِ النّظريّةِ ورسوخها. فالمذهب المعروف هو: اللّجوء إلى أدلّة الاثبات أو التّحقّق للنّظرية. وما ذهب إليه (بوبر)، أن ّأدلّة الاثبات أو التّحقّق لا تكفي لإثباتِ نظريّةٍ ما، بل لابُدّ من أن تكون قابلة للتّفنيد والدّحض؛ لأنّها إنْ لم تكن خاضعة لهذا المبدأ، فستكون مُتعالية أو ميتافيزيقيّة وليس تعلميّة. فمثلا: يأتي أحدهم ويضعُ تعميمًا نظريًّا يقول فيه: إنّ جميع الكائنات الحيّة تُحرّكُ فكّها الأسفل عند الأكل. وَفْقً المبدأ التّحقيق والاثبات، يحتاجُ صاحب هذه النظريّة إلى أنْ يذكر أنواع الحيوانات الّتي تفعل ذلك، وكلّ ماذكرَ كائنًا جديدًا كان ذلك إثباتًا قويًّا لنظريّته. لكن اعتراض (بوبر)، أنّه مهما فكّرَ ذلك الرّجل في إثباتاتٍ فسيحصل عليها؛ ولكنه لو فكّرَ فيما يُمكن أن يَدحض نظريّته، وقال: هل تُوجد حيوانات لا تُحرّك فكّها الأسفل عند الأكل؟ ثُمّ أخذ يبحث فيذلك، سيجد أنّ التّمساح –مثلًا-يدحض تعميمه، وهنا عليه تقييد التّعميم الّذي أتى به. في الحقيقةِ، العُمق في منظور (بوبر) يتمحور حول المضمون الآتي: لو أن ّنظريّة ذلك الرّجل لا تحتمل أن ْيُسأل السّؤال المفنّد لها، فلن تكون نظريّةً علميّة.
(1) تضامريا (بوبر) أصاب بالقوّة الّتي لم يصب فيها، وبتعبيرٍ آخر: إنّ إصابة (بوبر) في منظور هِهذا: هي إصابة نسبانويّة وليست مُطلقة، كما سأُبيّن الآن: أمّا إصابته، فالبحث في التّفنيد يُقوي النّظرية فعلًا، ويضعها في الحيّز المناسب لها، ويحجم إطلاقها، ويُقولبها في النّسبانويّة الّتي تُناسبها؛ ولكن ما آخذهُ عليه بشأنها: هو تَعميمه لمبدأ التّفنيد، بحيث يبدو لنا وكأنّه كافيً الوحده ولا حاجة مَعه لمبدأ التّحقيق، فهذا وقوع في التّعميم الّذي أنكره على القائلين بمبدأ التّحقيق. والأصوبُ عندي: أنّ النّظريّة تحتاج إلى مبدأ التّحقيق حاجتها إلى التّفنيد، ولاغنى عنهما معًا، ومهما أتت بهما؛ فإنّها تكون أقوى وأقوى، ولا ينبغي الاقتصار على أحدهما قدر ما بالإمكان فعل ذلك.
فإنْ شئت قُلْ: التّحقيق ولامثيله. وإنْ شئت قُلْ: التّفنيد ولامثيله. وإنْ شئت قُلْ: (تحقيق لاتحقيق). وإنْ شئت قُلْ: (تفنيد لاتفنيد).
لا فرق بين هذه الصّيغ، إذ نُثبت فيها الوجه ولامثيله، وليس كما قد يتوهم بعضهم من أنّ هذه الصّيغ ينفي بعضها بعضًا، بل نقول: إنّ الحقيقة كما تحتاجُ إلى الموجب تحتاجُ إلى السّالب، وقولنا: (موجب لا موجب) هو إثبات للموجب وللسّالب ولجميع الاحتمالات الممكنة الأخرى كما نُكرّر ذلك دائمًا.
(2) فإذا كانت القضيّة العلميّة يشترط فيها إمكانيّة التّكذيب؛ فهذا يعني أنّ كلّ قضيّة علميّة يُعتقد بمصداقيّتها تضمر إمكانيّة تكذيبًا. أي: أن كلّ قضيّة علميّة تضمر لا مثيلها بدلالة التّكذيب.
بتعبيرٍ آخر: لنثبت مصداقيّة قضيّة يجبُ أن نفترض –حسب (بوبر)-أنّ تلك المصداقيّة قابلة للتّكذيب، وهذا الافتراض ما هو إلّا تعبير عن أنّ تلك المصداقيّة تُثبت في وجودها وجود لا مثيلها، وذلك اللامثيل مستتر وراء المصداقيّة المظهرة، ولو لم يكن مضمرًا لما استلزم البحث عنه.
إنّ ما يذهب إليه (بوبر) يدلّ على ضرورة وجود المضمر، بل يبرهن عن وجود التّضامر، إذ التّضامر عندنا ليس إلّا البحث عن الاحتمالات الممكنة المستترة الّتي لا تماثل المظهر.
ومع ما يبرهن عليه مبدأ (بوبر) هذا؛ إلّا أنّنا لا نرى تلك البرهنة إلّا واحدًا من الاحتمالاتِ الممكنة الّتي يقول بها التّضامر. وهذا المعنى يُمكن صياغته بالشّكل:
القضيّة العلميّة الصّادقة تضمر لا مثيلها
= القضيّة العلميّة الصّادقة تضمر الاحتمالات الممكنة
= القضيّة العلميّة الصّادقة تضمر إمكانيّة تكذيبها (مبدأ بوبر) + 1
(3) إذا كنّا نتّفق مع (بوبر) فيما يذهب إليه من أن إمكانيّة التكذيب هي معيار لتمييز ما هو علمي ممّا هو ميتافيزيقي؛ فإنّنا نختلفُ معه في عدّ هذا النّموذج هو المعيار الوحيد، إذ نعتقد بوجود معايير أخرى، وفي مقدّمها معيار التّحقيق.
(4) إنّ اشتراط (بوبر) لإمكانيّة التّكذيب في الفرز بين القضايا، يجيبُ بمعنى ما عن تساؤل طُرح حول الفائدة من افتراض التّضامر للوجه الّذي لا يُماثل المظهر؛ إذ ووفقًا لهذا المبدأ، فإنّ وجود احتمال التّكذيب ضمن الاحتمالات الممكنة في علاقات التّضامر، تميّز القضيّة العلميّة من الميتافيزيقيّة.
قراءة في النّطاق الدّيني: قرآنيّات
في القرآن الكريم كثيرٌ من الآيات القرآنيّة الّتي يُمكن أن نلمح فيها الحضور لمفهوم التّضامر، وبما يتضمّنه من كثافة معرفيّة، وفيما يأتي الإشارة إلى بعضها:
(1) قال تعالى: {وَلَاتَحْسَبَنَّ الَّذِين َقُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْل ٍوَأَنَّ اللَّهَ لَايُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ} ([141])، وقال تعالى: {وَلَاتَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْأ َحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَاتَشْعُرُونَ} ([142])
تنبأ الآيتان أنّ من يُقتل في سبيل الله، ليس بميتٍ بل هو حيّ يرزق، وهي تنهى عن حسبانه ميتًا أو حتّى القول إنّه ميّت مع أنّ الواقع الملموس قاطع بأنّ الشّخص الّذي قُتل هو ميّت فعلًا!
ما لدينا هُنا، مظهر يضمر لا مثيله، مظهر يقول: إنّ هذا الشّخص ميّت؛ ولكن -ولأنّه قُتل في سبيل الله- أي: وفْقًا لهذه الدّلالة فهذا الموت يخفي حقيقة الحياة المليئة بالسّعادة النقيّة من كلّ خوف أو حزن، بل والواعية بالاستبشار بمن سيلحق بهم من المؤمنين.
إنّنا إن قرأنا هذا النّص في سياق دلالة وحيدة، وهو الواقع المادّي الملموس، فسنعلم بداهة أنّ هناك تناقض بين النّص والواقع؛ ولكن إن أخذنا في الحسبان أنّ القرآن الكريم ينبئ بطبيعتين للحياة وليس طبيعة وحيدة؛ الطّبيعة الأولى: هي تلك المقترنة بالجانب المادّي الّتي يُمكننا نحن البشر أن نشعر بها لأنّنا على تماس مباشر معها. أمّا الطّبيعة الثانية للحياة: فهي الطّبيعة اللّامادية أيّ الّتي تُماثل الحياة الماديّة جملة وتفصيلا، الّتي تسمّى: الحياة الروحية، ولكون هذه الطّبيعة لا تماثل الأولى؛ فإنّ من المنطقي تفهّم أنّنا إذا كنّا نشعر بالحياة الماديّة فنحنُ لا نستطيع أن نشعر بالحياة اللّامادي؛ ولكي نتعامل مع شيء لا نشعر به، ولا نستطيع أن نخضعه للرّصد والاختبار، فعلينا الايمان به كما نُخبر عنه.
الآن، إذا كانت لدينا طبيعتان للحياة –بحسب القرآن الكريم- فإنّ صياغة مفهوم الآية بالوجه:
إنّ الّذين قُتلوا في سبيل الله ليسوا بأمواتٍ بل أحياء بدلالةِ الطّبيعة الرّوحيّة، فسيكون ذلك منطقيًّا، ولن يكون هناك أيّ تناقض بين النّص والواقع. ما نصل إليه من هذا المضمون، أنّ هذه الآيات عن مستوين لا متماثلين: مظهر ومضمر، وأنّ المضمر هنا هو الوجه الآخر المكمل للحقيقة الوجوديّة للحياة.
ولو أنّنا أردنا التوسّع قليلًا في استخدام الفهم التّضامر بواسطة ادراكنا لخاصية اللاتماثل في التّضامر لأمكن أن نتوقّع بعض التّفصيلات المجهولة عن الطّبيعة الثّانية للحياة، وكما في المُقابلة الآتية:
إذا كانت الطّبيعة الماديّة مقيّدة بقوانين الجاذبية –مثلًا- فإنّ ذلك يضمر الدّلالة على أنّ الطّبيعة اللّامادية (الرّوحيّة) ليست مقيّدة بتلك القوانين.
إذا كانت الطّبيعة الماديّة مقيّدة بحواس معدودة ومحدودة نستشعر من طريقها الواقع المحيط؛ فإنّ ذلك يُضمر الدّلالة على أنّ الطّبيعة الرّوحيّة ليست مقيّدة بذلك العدد من الحواس ولا بتلك المحدوديّة لها، فقد يُمكن أنّنا نستطيع الرّؤية من دون بصر، أو أن نرى أبعاد لا تستطيع حتّى أحدث تقنياتنا الحالية استشعارها.
إذا كانت الطّبيعة الماديّة تشعرنا بأنّنا نملك نوعًا من الاستقلاليّة الكيانيّة فإنّ ذلك يضمر الدّلالة على أنّ الطّبيعة الرّوحيّة قد تكون لا استقلاليّة إلى حدٍّ كبير بحيث أعي بما أفكّر فيه وما يفكّر فيه غيري على حدّ سواء.
على هذه الشّاكلة يُمكن الاسترسال لتوقّع أيّ احتمال لا تماثلي بين الطّبيعتين، ولن نملك الجزم بصحّة هذه التوقّعات إلّا فلسفيًّا وَفْقَ القواعد النّظريّة الّتي نقولها، وإن كنّا لا نستبعد مطابقة هذه التوقّعات أو بعضها للحقيقة كما نتصوّرها.
(2) انطلاقًا من هذه الطّبيعة الثّنائيّة للوجود، نستطيع أن نلمح المقصود بثنائيّة الفعل في الآية الكريمة: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ([143]).
فهاهنا فعل القتل المظهر هو للمؤمنين؛ ولكن هذا الفعل ليس قائمًا بذاته بل بغيره، بالفعل الإلهي المكوّن للجانب المضمر. وذات المضمون يُقال على فعل الرّمي، سواء أقبضة رمل كانت أم حصى، فالفاعل المظهر هو النّبي -صلّى الله تعالى عليه وسلّم-، وأمّا الفاعل المضمر فهو الله تعالى؛ وبذا نُثبت الوجهين، وكلّ وجه بدلالته، فنقول: بدلالة المظهر المؤمنين قتلوا والنّبي رمى، وبدلالة المضمر الله تعالى من قتل ورمى. فلا يتعطّل أحدهما، ولا يتناقضان مع بعضهما؛ ولكننا ومع هذه المقدّمة نستطيع أن نصل إلى قاعدة مفادها: أنّ الفعل أيّ فعل، متراكب من قوّتين: ماديّة ولا ماديّة (إلهية)، أو كما نعبّر عنه في اصطلاح التّضامر (مادّي لا مادّي – نسبانويًّا).
(3) وفي جانب آخر، نقرأ قوله تعالى: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} ([144]) وقوله تعالى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} ([145]) وهنا نلاحظ خطاب المفرد، فالمتكلم واحد؛ ولكن في آيات أخرى يقول تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْر َوَإِنَّ الَهُ لَحَافِظُونَ} ([146])، أو قوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ} ([147]). وهنا يكون الخطاب الجمع (نحن) وليس المفرد (أنا).
لعله من نافلة القول إنّ الغالبيّة العظمى من العلماء يعزون استخدام صيغة (نحن) من الله تعالى إلى فكرة أنّ عادة كانت الملوك إِذا فعلوا شيئًا، قال أحدهم: نحن فعلنا، يريد نفسه وأتباعه، ثمّ صار هذا عادة للملِك في خطابه، وإِنا نفرد بفعل الشّيء، فخوطبت العرب بما تعقل من كلامها؛ مع أنّ هناك من يقرأ هذه التّفرقة وَفْقَ مقولته بالعلاقة بين أحدية الذّات وكثرة الصّفات، كالشّيخ ابن عربي، الّذي ذهب إلى أنّ من وقف مع الكثرة، كان مع الأسماء الإلهيّة، ومن وقف مع الأحدية، كان مع الحق، من حيثُ ذاته الغنية عن العالمين، وهو يضرب لذلك مثلًا بالشّخص الّذي تتكثّر ظلاله بعددِ ما يُقابله من الأنوار، أو تظهر له صور كثيرة بعدد المرايا الّتي يُواجهها، فهو في هذه الحالة واحد في ذاته متكثر من حيثُ تجليه في صوره وظلاله ([148]).
وفقًا لهذا المنظور، فإن تحدّث تعالى عن ذاته الأحدية قال: (أنا الله) وإن تحدّث عن شيء من تجليّاته، فهو يخاطبها من حيثُ كثرة صفاته، وهنا يستخدم صيغة (نحن)؛ لأنّه لا فرق حقيقي بين (أنا ونحن) عند الله من حيثُ الأصل، وإنّما التمييز من حيثُ جهة مواجهة المخاطب، إذ ما يقتضيه الخطاب حين يواجه الذّات الأحدية لا يماثل ما يقتضيه الخطاب حين يواجه الصّفات وتجلياتها.
وأنا هنا لن أجادل في العلّة وراء هذين الخطابين، سواء أبسببِ التّعظيم كان -كما يقول أغلب المفسّرين- أم بسبب ما ذهب إليه الشّيخ ابن عربي أو لأيّ سبب آخر، بل سأكتفي بالوقوف عند حقيقة راسخة في الخطاب الإلهي وهي: أنّه خطاب يتضمّن ثنائيّة: (أنا – نحن). ونعلم أنّ هذين الخطابان لحقيقة واحدة هي الحقيقة الإلهيّة ذاتها. بهدف الوصول من ذلك إلى المضمون الآتي: (أنا) و(نحن) في الخطاب الإلهي مُتتامتان؛ أي إنْ كانت إحداهما مظهرة لنا فإنّ الأخرى تكون مضمرة بالضّرورة.
لو أنّني عمّمت هذه الفكرة في الموجودات لرأيت تجلّي تلك الثّنائيّة المتتامة أو المتضامرة حاضرة في كلّ شيء، فالكثرة موجودة، والوحدة في الكثرة موجودة أيضًا، فإنّ نظرنا إلى الكثرة وسرنا معها غابت عنّا الوحدة، وعندما ننطلق في رؤية الوحدة تغيب عنّا الكثرة، في وضع من التّتام المتكامل؛ الأمر الّذي قد يوصلني إلى القاعدة القائلة: إذا رأيت كثرة فتوقّع وجود الوحدة وراءها، والعكس صحيح، وإذا أردت أن أضرب مثالًا متطّرفًا نوعًا ما، فسأقول: نحنُ نعلم وجه الكثرة في اللّغات، فهل نتوقّع وجود وحدة لتلك الكثرة؟ وفقًا لما سبق أن قرأنا وافترضنا، فإنّ الإجابة هي: نعم، توجد وحدة تنظم جميع اللّغات، ربّما هي غير مكتشفة الآن؛ ولكن عدم الاكتشاف لا يدلّ على عدم الوجود كما هو معروف، وقد يأتي اليوم الّذي نقع فيه على ذلك الأصل الموحّد لما قد يُسمّى (اللّغة الأم) أو (لغة اللّغات).
(4) إلى ذلك فإنّ لدينا آية تكشف عن تضامر من النّوع اللاذاتي بين كلّ من مرتبة الطّبيعة ومرتبة الإنسان، وهي قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ولَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ} ([149]).
عندما نقرأ هذه الآية الكريمة وَفْقَ المنظور التّضامري، فإنّ صورة تلك القراءة هي: أنّ هناك علاقة تضامر لا ذاتي بين الكائنات الحيّة والإنسان بدلالة مفهوم الأمميّة. هذه الفكرة تتطلّب دراسة مفردة لمفهوم الأمّة سواء في مرتبة الطّبيعة أم مرتبة الإنسان، لنوازن بعد ذلك بين ما هو مظهر في أحدهما لنتوقّع النّظير مضمرًا في المرتبة الأخرى. فعلى سبيل المثال: نحن نعلم مفهوم الأمّة يتضمّن جماعة من النّاس يعيشون في وطن واحد، وتجمعهم رغبة في الحياة المشتركة تدعمه وحدة التّاريخ أو اللّغة أو الدّين أو الاقتصاد أو ذلك جميعًا. فهل يوجد في الكائنات الحيّة الأخرى مثل هذه المقوّمات المشكلة لمفهوم الأمّة؟ أم أنّ مفهوم الأمّة لا يتضح على ما هو عليه إلّا بعد أن نستحضر الحدّ الأدنى من شروطه الّتي تنطبق على الكائنات الحيّة وعلينا بالقدر ذاته. مثلًا: قضيّة التّاريخ المشترك، عنصر أساسي من عنصر مفهوم الأمّة عند البشر، فهل هو أساسي في الكائنات الحيّة كمجتمعات؟
إنّ الإجابة عن هذا التساؤل، ووفقًا لقانون التّضامر الثّاني تكون معكوسه؛ ما يعني هو إمّا أن نتنازل عن قضيّة ادراج التّاريخ المشترك في مفهوم الأمّة عند البشر، وإمّا أن نكتشف أنّ ذلك التّاريخ المشترك عنصر أساسي لدى الكائنات الحيّة الأخرى. فذلك ممّا يُمكن أن يُستنبط بدلالة الآية القرآنيّة، ووفْق سياق القراءة التّضامريّة.
(5) في جانب العلاقة بين مرتبتي القرآن الكريم والتكنولوجيا، بإمكان أن نستخدم أدوات التّضامر لنتوقّع اكتشاف عددٍ من التقنيّات الّتي لم تُكتشف بعد، أو حتّى إمكانيّة ترجيح بعض جوانب الأجوبة على الأخرى، وذلك بالاستناد إلى دلالة محدّدة هي المعجزات بوجهٍ خاص أو الإمكانات الرّوحيّة بوجهٍ عام. المعتمد في هذه العمليّة هو: قانون التّضامر الأوّل؛ إذ ينبئ هذا القانون على أنّ ما يُوجد في أحد مرتبتين لا متماثلتين يُمكن أن يُوجد نظير له في المرتبة الأخرى.
نحن نعلم، ووفقًا للقرآن الكريم، أنّ هناك كثيرًا من المعجزات الّتي حدثت لأنبياء ويليها الكرامات للأولياء. هذه الوقائع كانت -بحسب الفهم الدّيني-خاصّة لأشخاص بعينهم، ومحدّدة لظروف بعينها، ولو أنّا أعدنا قراءة هذه الشّروط وَفْقَ مبدأ اللّاتماثل، لأمكننا القول: إنّ ما لا يُماثلها في مرتبة أخرى -وهي مرتبة التكنولوجيا هنا- يهو التعميم بحيث ُمكن أن يحدث لأي شخص كان، وإنّها لن تكون مقيّدة بظرفٍ محدّد لا في الزّمان ولا في المكان، إلّا بالقدر التّقني الكفيل بتكوينها وتفعيلها.
على سبيل المثال، جاء في القرآن الكريم: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِوَأُ وتِينَا مِنْ كُلِّشَيْء ٍإِنَّ هَذَا لَهُوَا لْفَضْل ُالْمُبِينُ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَت ْنَمْلَةٌيَا أَيُّهَا النَّمْل ُادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَايَحْطِمَنَّكُ مْسُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} ([150]). فهنا يتبيّن أنّ هناك حالة إعجازيّة يستطيع من طريقها النّبي سليمان أن يفهم منطق الطّير والنّمل وأن يتحكّم فيها أيضًا كجنود له، وهذا يضمر الدّلالة على أنّ ما كان خاص بنبي بدلالة قوّة روحيّة معيّنة؛ يُمكن أن يكون عامّة لأيّ إنسان من بدلالة قوّة ماديّة أو تقنية تكنولوجيّة ستكتشف مستقبلًا. ما نقوله هنا: تضامريًّا الآية تنبئ أنّ النّاس سيكتشفون التقنية التكنولوجيّة الّتي سيتمكّنون فيها من فهم الطّير والنّمل بل وجميع الكائنات الحيّة الأخرى، ولعلّ الأغرب أنّهم سيتمكّنون من التّواصل مع تلك الكائنات بأن يجعلها تفهمهم من طريق تلك التقنية؛ ما يمكنهم من تسخيرها بوجهٍ أكثر سلاسة ومرونة.
في مثال آخر، قال تعالى: {قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} ([151])، في هذه الواقعة، كانت النّار تحرق الخشب ولا تحرق النّبي إبراهيم ولا ملابسه؛ ما يعني أنّه تم التحكّم بخصائصها، لتحرق أشياء ولا تحرق أخرى، وهذا يضمر الدّلالة على أنّ العلم سيصل يومًا إلى اكتشاف التقنية الّتي يُسيطر فيها على النّار بحيث يبرمجها لتحرق أو تسخن أشياء كأن تكون أوعية الطّعام ولا تمس ما عدا ذلك بأيّ طاقة حراريّة. على هذه الشّاكلة يُمكن أن نقرأ تضامريًّا جميع الآيات الّتي تتضمّن خوارق لم يكتشف العلم نظيرًا لها لحدّ الآن، وإن كان قد قطع شوطًا كبيرًا جدًّا في هذا المجال، فخوارق مثل: الهواتف السّماوية التي كان يسمع فيها شخصًا آخر عن بعد بلا واسطة ماديّة معلومة، قد اكشفت بالفعل التقنيات النّظيرة لها بأجهزة الهواتف المعروفة عندنا الآن. وخوارق تُروى عن الطّيران، وجدت نظيرها أيضًا، وهكذا.
كما أشرنا؛ فبعض الآيات يُمكن نتيجة قراءتها تضامريًّا أن ترجح لنا بعض الأجوبة المحتملة، إنْ لم تكن متنبئة بها بصورة دقيقة. فمثلًا، لا يزال العلم غير جازم بقضيّة: هل يُمكن نقل الأشياء الماديّة عن بعد كما تُنقلُ المعلومات حاليًّا أم لا؟ الآية القرآنية القائلة على لسان سليمان: {قالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ. قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ. قَال َالَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِه ِقَبْلَ أَنْ يرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِيأَ أَشْكُرُأَ مْأَكْفُرُوَ مَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ} ([152])، تقولُ إنّ هذا حصل في المستوى الرّوحي، أي تمّ نقل عرش من مكان إلى مكان بسرعة. تُشير بعض التّأويلات إلى أنّها أسرع من سرعة الضّوء، وهذا يضمر الدّلالة إلى أنّ هذه الإمكانيّة يُمكن أن يتحقّق نظيرها التكنولوجي يومًا ما، فتنقل الأشياء -وحتّى البشر- من مكانٍ إلى آخر بأسرع من لمح البصر. هذا يعني: أنّها ترجح الإجابة عن سؤال لم يزل العلم غير قادر على الجزم بشأنه.
(6) يزخرُ القرآن الكريم بالنّماذج الّتي يُمكن أن تُقرأ تضامريًّا، مثل: نظريّة الآيات، وخلاصتها: إنّ الكلمات الإلهيّة نموذجين في الأقل: معرفيّة ووجوديّة، فأمّا المعرفيّة في النّص القرآني نفسه، يقول تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ} ([153]). أمّا الوجوديّة فهي كلّ ما في الكون؛ إذ تُشير النّصوص إلى أنّ اللّيل والنّهار آيات {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّشَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا }([154])والجنّات في الأرض آيات {لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُو الَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَب ٌّغَفُورٌ}([155])وناقة صالح آية {وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَ أْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ }([156])ومريم وابنها آية {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ }([157])، وعلى الجملة فكلّ شيء يدخلُ في حيّز الوجود أو المعرفة هو آية، يقول تعالى جامعًا لذلك كلّه: {وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِه ِيُؤْمِنُونَ} ([158]).
إنّ هذا المقاربة تُعطينا تصورًا عن التّوازي بين مرتبتي النّص والواقع، وهو توازي بين أمرين لا مُتماثلين، وكل لا متماثلين يُمكن أن يتضامرا بدلالةٍ محدّدة كما ينصّ على ذلك مبدأ التّضامر. هنا لو أخذنا مثلًا قضيّة المحكم والمتشابه في الآيات النّصيّة الّتي ذكرها القرآن في الآية: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنّ َأُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَر ُمُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِين َفِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُإِ لَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ}([159])؛ فإنّنا بفضل قانون التّضامر الثّاني نستطيع أن نتوقّع أن هذا يُضمر الدّلالة على أنّ الآيات الوجوديّة منها المحكم ومنها المتشابه، وبالمعرفة بما تعنيه الأحكام والتّشابه سواء في المستوى النّصي المعرفي أم المستوى الواقعي الوجودي؛ نستطيع أن نستنتجَ النّظائر المتقابلة بين آيات القرآن وآيات الكون.
(6-1) لو أنّنا افترضنا أنّ واحدًا من معاني المحكم والمتشابه هو الوضوح والإبهام، أي: النّص الواضح بنفسه، كقوله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُ كَفِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} ([160])، والنّص الّذي لا نستطيع أن نفهمه أو نتّفق على فهمه فهمًا قاطعًا، مثل: {حم.عسق} ([161])؛ فإنّ ذلك يضمر الدّلالة على أنّ الكون فيه ما هو واضح ويمكن أن يكتشف وفيه ما هو مبهم ويصعب أن يكتشف أو يجزم بتفسيره. بل أكثر من هذا يُمكن أن تنبئ هذه العلاقة عن أنّ العلمَ لن يصل في يوم من الأيّام إلى حلّ جميع ألغاز الكون وتفسير الطّبيعة بنسبة مئة بالمئة؛ لأنّ النّظير فيه مُتشابه. وفي المقابل، لو توصّل العلم –فعلً-ا لهذا المستوى وتمكّن من أن يُفسّر كلّ شيء؛ فإنّ هذا سينبئ أن إبهام المتشابه سيرتفع عند الجميع وأنّ اجماعًا بهذا الشّأن سيتحقّق.
(6-2) إن علمنا أنّ هناك شيئًا آخر في ذكر في القرآن غير الآيات وهو الحكمة لقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا} ([162])؛ فإنّ هذا يضمر الدّلالة على أنّ الكون يتضمن ما هو أكثر من الآيات المظهرة. هناك شيء آخر نظير للحكمة، وتتحدّد معرفتها بذلك الشّيء من طريق معرفتنا بمفهوم الحكمة في هذه الآية، وكتعميمٍ يُمكننا افتراض أنّ الحكمة هي الوجه الآخر المضمر للكتاب المظهر، فإن انطلقنا في الفهم المادّي كنظير لهذه الأمر فهذا يفترض أنّ علينا أن نفترض أنّ للطّبيعة وجهين لا مُتماثلين، أي فيها قوى مظهرة معلومة وفيها قوى لم تزلْ مجهولة، وبتعبيرٍ أصرح: إنْ رسخ –الآن- لدى العلماء أنّ قوى الطّبيعة أربعة هي: الجاذبيّة والكهرومغناطيسيّة والنّوويّة القويّة والضّعيفة؛ فإنّ ما يترتّب على الفهم السّابق أنّ هناك قوىً أخرى تختلف في طبيعتها الماديّة عن تلك القوى، ولعلّ الخصائص الّتي يتوقّعها العلماء لكلّ من المادّة المظلمة والطّاقة المظلمة تكون من هذا القبيل. والخلاصة هنا: إنّ هناك مادّةً أو قوى أخرى متوقّعة أو غير متوقّعة، هي للمادّة المعروفة بمنزلة نظير الحكمة للكتاب.
(6-3) في ذات المسار لو أخذنا مثلًا قضيّة النّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؛ لترتّب على هذا توقّع لناسخ ومنسوخ نظير في الكون، ولو أخذنا قضيّة التفسير والتأويل أيضًا؛ فسيمكننا أن نجد النّظير لها في فهم الكون وبالعكس، ويُمكن أن نستمرّ مع جميع العلوم والخصائص الّتي تختصّ في القرآن لنتلمس النّظير الكوني لها، ومن هذه العملية التّقابليّة التّضامريّة، سنتمكّن من رؤية قوانين التّضامر فاعلة وبوجهٍ منقطع النّظير في هذا المساق.
[1]– الميتافيزيقيا: عند أرسطو علم ما بعد الطّبيعة، وعند الكندي علم الرّبوبية، وعند الفارابي «العلم بالموجود بما هو موجود» وعند ابن سينا هو العلم الإلهي. انظر: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، (بالألفاظ العربيّة والفرنسيّة والإنجليزيّة واللّاتينيّة)، دار الكتاب اللّبناني، ومكتبة المدرسة، بيروت، 1982، ج2ص300.
الميتافيزياء: هو الميتافيزيقيا سابقًا، وأمّا الآن فقد أصبحت تعني: نظريّات حول نظريّات الفيزياء، فهي تُناقش قوانين حول القوانين وليس حول ما وراء عالمنا الرّاهن. انظر: بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص29.
الغيب: «هوما لا يُمكن أن يدركه الحسّ لكن يعلم بالعقل إمّا بالدليل القاطع وإمّا بالخبر الصّادق». الشّيخ ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج3 ص397.
ديناميكي: قسم من علم الميكانيكا، يبحثُ في الحركات الماديّة من جهة علاقتها بالقوى الّتي تحدثها. انظر: المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، ج1ص574.
[2]– كشف لوباتفسكي (1793م-1856م)، أن الهندسة الإقليدية تصح في السطوح المستوية فقط، وأما في السطوح المقعرة فإن الأمر يختلف تماما، فمجموع زوايا المثلث – مثلا- تصبح أقل من (180درجة) كما هو ثابت في هندسة إقليدس، وأيضا تخالف المسلمة الخامسة في الهندسة الإقليدية التيالّتي تنص على أنه “من نقطة خارج مستقيم يمر مستقيم وحيد يوازي المستقيم الأوّل” وفي هذه الهندسة “من نقطة خارج مستقيم يمر عدة مستقيمات متوازية”. ثمّ وفي القرن ذاته تم اكتشاف الهندسة الريمانية، نسبة إلىإلى الرياضي الألماني ريمان (1826م-1866م)، الخاصة بالسطوح المحدبة فيها تكون زوايا المثلث أكثر من (180درجة)، ومن نقطة خارج مستقيم لا يمر أي مستقيم مواز له، وكل مستقيم منته لأنه دائري في السطح الكروي، بخلاف مسلمة هندسة إقليدس التيالّتي تقول بان الخط المستقيم لا نهاية له. وهكذا بقية المسلمات التيالّتي تزلزل اليقين بها. انظر: نبيل مسيعد، فلسفة الرّياضيّات، ص6.
[3]– الهندسة المطلقة: هي الهندسة على النظام البديهي الّذي لا يفترض مسلمة التوازي أو أي من بدائلها. تم استخدام هذا المصطلح من قبل العالم “يانوسبوياي” ويطلق عليها أحياناً اسم الهندسة الحيادية. حيثُ أنها حيادية تجاه مسلمة التوازي.
الهندسة المتقطعة: هي فرع من الهندسة الرياضية الّذي يدرس الأجسام وخصائصها في الفضاء المتقطع. وهي دراسة لا تعتمد على افتراض استمرارية الأجسام.
الهندسة التحليلية: وتدعى أيضًا الهندسة الإحداثية أو التنسيقية وسابقا الهندسة الديكارتية، هي فرع من المعرفة الرياضية الّذي تم من خلاله الربط بين فرعي الهندسة والجبر.
الهندسة الرياضية الحاسوبية: هي فرع من المعلوماتية الّتي تختص بدراسة الخوارزميات الّتي من الممكن تمثيلها هندسياً.
الهندسة التفاضلية: هي الحقل الّذي يتعامل مع دالة قابلة للمفاضلة على متعدد الشعب قابل للمفاضلة أيضًا، يظهر طبيعياً مِنْ دراسة نظريّة المعادلات التفاضلية. وللمزيد حول هذه الهندسات انظر: موسوعة ويكيبيديا، الإنترنت.
[4] – السّنخيّة: قاعدة عقليّة مفادها: أنّ للعلل معلولات تناسبها، وللمعلولات عللاً تُناسبها، فلا تصلح كلّ علّة لكلّ معلول ولا يصلح كلّ معلول لكلّ علّة، فالحرارة لا تصدر عن الثّلج، والبرودة لا تنبعث من الحرارة، والجاهل لا يكون مصدرًا للعلم والعلم لا يصدر عن جاهل؛ لأنّ فاقد الشّيء لا يُعطيه، والعطاء لا يصدر من لا شيء. انظر: محمد باقر الصّدر، فلسفتنا، المجمع العلمي للشّهيد الصّدر، 1418، ص 263.
[5]– برتراند راسل، (1872-1970م) فيلسوف ورياضي إنجليزي. اشترك مع ويتهد في تأليف «أصول الرّياضة»، يُعدّ أعظم مرجع في المنطق الرّمزي الحديث. من أهم كتبه الفلسفيّة: التصوّف والمنطق، الفلسفة الرّياضيّة، الصّدق والمعنى، المعرفة البشريّة، تاريخ الفلسفة الغربيّة. سافر إلى أمريكا حيثُ حاضر بجامعاتها. انظر: الموسوعة الفلسفيّة المختصرة، نقلها عن الإنجليزية: فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرّشيد الصّادق، راجعها وأشرف عليها: د. زكي نجيب محمود، دار العلم للملايين، بيروت، ص210 والّتي تليها.
[6]– ألفريد نورث وايتهيد، (1861-1947م)، عالم رياضي وفيلسوف إنجليزي، كتب في الجبر والمنطق وأسّس الرّياضيّات، وكذلك في فلسفة العلوم والفيزياء والميتافيزيقا والتّعليم. تلقى دراساته العليا في الرّياضيّات البحتة والرّياضيّات التّطبيقيّة في جامعة كامبردج. انظر: ماجد محمد حسن، مقال الواقعيّة الجديدة: ألفرد نورث وايتهيد، موقع الحوار المتمدّن، العدد: 891 –(1425هـ/2004م)، إنترنت.
[7]– نظريّة المجموعات: هي النّظريّة الّتي تصف المجموعات الرّياضية المؤلّفة من كائنات رياضيّة مجرّدة والعمليّات المطبقة عليها، وتشكل إحدى أهم ركائز الرّياضيّات الحديثة. انظر: موسوعة ويكيبيديا، أنترنت.
[8]– مقال علم الرّياضيّات ورحلة البحث عن الحقيقة، محمد زكريا توفيق، إنترنت، موقع الحوار المتمدّن.
[9]– الطوبولوجيا أو علم الفضاء أو علم المكان: كلمة يونانية (منtopos وتعني مكان وlogos تعني دراسة) تعني دراسة المجموعات المتغيرة الّتي لا تتغيّر طبيعة محتوياتها. يهتم الطوبولوجيا بدراسة الخصائص المكانية المنحفظة وَفْقَ التشوّهات ثنائيّة الاستمرار (الشدّ دون التّمزيق)، هذه الخصائص تعرف عادة باللّامتباينات الطوبولوجيّة، تأسّس هذا الفرع من الرّياضيّات في بدايات القرن العشرين آخذا في تطوره من عام (1925م) إلى (1975م) حيثُ شهد نضوجه وتشكّله كاختصاص متكامل. يُمكننا القول إذا أردنا التّيسير إنّ هذا العلم يهتمّ بالخصائص الرّياضيّة الّتي لا تتأثّر عند التحوّل من فضاء رياضي إلى آخر. موسوعة ويكيبيديا. إنترنت.
[10]– توماس هنري هاكسلي، عالم أحياء بريطاني (1825م ـ1895م). نشر كتابه الخاص في التطور: «مرتبة الإنسان في الطّبيعة» عام(1863م)، وعلى عكس داروين، فقد ركّز هاكسليفي كتابه هذا على نسب الإنسان. انظر: روبرت م. اغروس، جورج ن. ستانسيو، العلم في منظور جديد، ترجمة د. كمال خلايلي، سلسلة كتب ثقافيّة يصدرها المجلس الوطني للثّقافة والفنون والآداب-الكويت، عالم المعرفة، العدد 134، 1989م، ص141
[11]– المصدر نفسه، ص25.
[12]– المصدر نفسه، ص26.
[13]– تشارلزسكوت شرينغتون، (1857م-1952م) عالم بريطاني بحث في مجالات الفيزيولوجيا العصبيّة وعلم الأنسجة وعلم الأحياء الدّقيقة وعلم الأمراض. انظر: المصدر نفسه، ص137.
[14]– المصدر نفسه، ص27.
[15]– المصدر نفسه، ص30.
[16] – نسبة إلى نيكولاس كوبرنيكوس، الفلكي البولندي، (1473م–1543م)، يُعتبر أول من صاغ نظريّة مركزية الشّمس وكون الأرض جرمًا يدور في فلكها، كان أحد أعظم علماء عصره، راهبًا وعالمًا رياضياتيًّا وفلكيًّا وقانونيًّا وطبيبًّا وإداريًّا ودبلوماسيًّا وجنديًّا. انظر: منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، (موسوعة تراجم لأشهر الاعلام العرب والأجانب والقدامى والمحدثين مستقاة من موسوعة المورد)، دار العلم للملايين، بيروت، ط1، 1992، ص370-371.
[17]– د. أيوب أبو دية، العلم والفلسفة الأوروبيّة الحديثة من كوبرنيق إلى هيوم، بيروت دار الفارابي،2009م.
[18]– جوزيف جون طومسون، (1856م-1940م)، عالم إنجليزي، تخصّص في حقل الفيزياء النّظريّة. حصل على جائزة نوبل عام(1906م)، لاكتشافه الإلكترون. انظر: منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، ص277.
[19]– انظر: د. ب. جري بانوف وآخرون، أينشتاين والقضايا الفلسفيّة لفيزياء القرن العشرين، دراسات مقارنة، ترجمة ثامر الصفار، الأهالي للطّباعة والنّشر والتّوزيع، دمشق، ط1، (1410هـ/1990م)، ص30.
[20]– هذا الوصف يعني: أنّ تعميمات هذا العلم محدودة وليست مطلقة، وسيلي الحديث بالتّفصيل عن مفهوم النّسبانويّة.
[21]– أينشتاين، أفكار وآراء، دار كرون، نيويورك، (1373هـ/1954م)، ص266.
[22] – د. مصطفى النّشار، مدخل جديد إلى الفلسفة، دار قباء للطّباعة والنّشر، القاهرة، ط1، 1998، ص69 – 70.
[23] – د. مصطفى النّشار، مصدر سابق، ص69 – 70.
[24]– موسوعة ويكيبيديا، إنترنت.
[25]– عمانويل كانط، (1724م-1804م)، ألماني بروسي، من أشهر فلاسفة القرن الثّامن عشر وأكثرهم تأثيرًا في الفترة الكلاسيكيّة لنظريّة المعرفة. ومن أشهر أعماله «نقد العقل الخالص» وهو بحث في بنية العقل. أمّا عمله الثّاني الأساسي فهو «نقد العقل العملي» ركّز فيه على الأخلاقيات وكتاب «نقد الحكم» الّذي يبحث فيه بموضوعات الجمال والغائيّة. انظر: الموسوعة الفلسفيّة المختصرة، ص329 والّتي تليها.
[26]– انظر: د. جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ص30.
[27] – رينيه ديكارت، (التأمّلات، التأمّل الثّاني)، ترجمة: عثمان أمين، مكتبة الأنجلو المصريّة، ط2، 1974، ص 99.
[28] – للمزيد حول هذه المصطلحات انظر: القسم الثّاني – الفصل الأوّل– تعريفات إجرائيّة.
[29] – المنطق متعدّد القيم يتناول هذا المفهوم الذي لا يقتصر فيه الحكم المنطقي على استخدام قيمتي الصّدق والكذب المعروفتين، وإنّما تتعدّد قيم الصّدق بينهما بما يسمح باستخدام قيمة الصّدق الثّالثة، أو الرّابعة… إلخ، وصولا إلى النّسق المعرفي ذي العدد اللّامتناهي من القيم. للمزيد انظر: د. صلاح عثمان، المنطق متعدّد القيم-بين درجات الصّدق وحدود المعرفة، شركة الجلال للطّباعة، ط1، 2002، ص 19.
[30]– ولاحقًا توالى ابتكار الرّموز والعلاقات وبما يتناسب وهيكليّة بناء النّظريّة وأبعادها، وجاء ذلك متناغمًا مع تنامي مصطلحاتها وتركيب مبادئها وتفصيل قواعدها، وصياغة قوانينها، وكما سنوضّحه بالتّفصيل في مواطنه المناسبة في هذا الكتاب.
[31]– وضع أرسطوثلاثة قوانين أساسية للتفكير وهي: قانون الهوية ومعناه أن الشّيء الواحد هو ذاته بصفاته الأساسية مهما اختلفت صفاته العرضية، مثال: الإنسان هو الإنسان ورمزه رمزهأهيأ. وقانون عدم التّناقض وهو أن الشّيء الواحد لا يُمكن أن يوصف بوصف هو نقيض الصفة في نفس الوقت، مثال: الإنسان لا يُمكن أن يكون أبيضا وغير أبيض في الوقت نفسه، ورمزه: إلّا يُمكن أن تكون بولاب في وقت واحد. وقانون الوسط الممتنع أو الثّالث المرفوع وهو أن الشّيء الواحد إما أن يوصف بصفة أو نقيض الصفة ولا وسط بين النقيضين، مثال:
الإنسان إما أن يكون أبيض أو غير أبيض، ورمزه: إما أن تكون باولاب ولا ثالث لهذين الاحتمالين.
[32] – أطلس الفلسفة، ترجمة: د. جورج كتورة، المكتبة الشّرقيّة، ط11، 2003، ص35.
[33]– فيرنركارل هايزنبيرغ، فيزياء وفلسفة (ثورة في الفيزياء الحديثة)، ترجمة وتحقيق وتقديم: خالد قطب، النّاشر: المركز القومي للتّرجمة، ص 23-24.
[34]– ديفيد لندلي، مبدأ الرّيبة (أينشتين، هايزنبرج، بور والصّراع من أجل روح العلم)، ترجمة: نجيب الحصادي، دار العين للنّشر، الإسكندريّة، 2008، ص248ـ249. لقد ألحّ نيلز بور في أواخر عمره على بسط مبدأ التتامية لمختلف شؤون الحياة، وقد سأله أحدهم: ما الصّفة المتمّمة للحقيقة؟ ففكّر برهة ثمّ أجاب: إنّها الوضوح. انظر: ستيفن واينبرغ، أحلام الفيزيائيّين بالعثور على نظريّة نهائيّة جامعة شاملة، ترجمة: أدهم السّمان، دار طلاس، ط2، 2006، ص67م.
[35]– ابن عربي: الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكيّة والملكيّة، دار إحياء التّراث العربي، الطّبعة الأولى، 1998م، ج4، ص78.
[36]– انظر: يحيى محمد، منهج العلم والفهم الدّيني (العبور من العلم إلى الفهم ومن الفهم إلى العلم)، مؤسّسة الانتشار العربي، ص158ص159.
[37] – على هامش مفهوم التّتام في البنية الذريّة، فإنّه ومن إقامة علاقة تضامر عكوس بين التّتام الذري والتتام المعرفي، يُمكن التوقّع باحتمال أن يكون للبنية طبيعة ثالثة سوى الموجية والجسيميّة لم تكتشف لحدّ الآن.
[38]– مجلة ساينتفك أمريكان، مقال: بول ديراك وجمال الفيزياء، أغسطس-سبتمبر1995 / المجلد 11.
[39] – انظر: د. مصطفى النّشار، مدخل جديد إلى الفلسفة، ص52-53.
[40] – د. مصطفى النّشار، مصدر سابق، ص69 – 70.
[41] – ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج 3 ص108.
[42] – د. سعاد الحكيم، المعجم الصّوفي، دندرة للطّباعة والنّشر، بيروت، ط1، 1981، ص 192 – 194.
[43] – المصدر نفسه، ج 2 ص 391.
[44] – سورة الرّحمن، الآية: 19-20.
[45] – حاول الدّكتور أبو العلا عفيفي جاهدًا أنّ يرد مفهوم البرزخ إلى تأثير (فيلونالاسكندري)، حيثُ رأى أنّ تأثير هذا المفهوم بارز بوضوح في التّشابه في المصطلحات الّتي يستخدمها كلّ منهما. وقد ردّ الدّكتور نصر حامد أبو زيد على هذا الرّأي بقوله: إنّ أبا العلا عفيفي منطلقًا من تصوّره الأساسي لفلسفة ابن عربي قد وحّد بين مصطلحات كثيرة، وعدّها أسماء تدلّ على حقيقة واحدة. وعلى الرّغم من تنبّه أبي العلا عفيفي إلى الأصل القرآني الّذي يُمكن أن يفسّر مفهوم الكلمة والبرزخ عند ابن عربي؛ فإنّه يرجح التأثير اليهودي والمسيحي في التّأثير القرآني. والحقّ إنّ مصطلح البرزخ له أصله القرآني عند ابن عربي. انظر: أبو العلا عفيفي، الفلسفة الصّوفية عند محي الدّين بن عربي، ترجمة وتحقيق: مصطفى لبيب عبد الغني، المركز القومي للتّرجمة، دار الكتب والوثائق القوميّة، القاهرة، 2009م، ص 90.وأيضًا: ص 66 هامش1. ونظريّة الإسلاميّين في الكلمة، أبو العلا عفيفي، بحث مستخرج من مجلة كليّة الأدب، المجلد الثّاني، العدد الأوّل، 35،48،55،56، مطبعة المعهد العلمي الفربسي للآثار الشرقيّة، 1934م. وفلسفة التّأويل (دراسة في تأويل القرآن عند محي الدّين بن عربي)، نصر حامد أبو زيد، المركز الثّقافي العربي، 2003م، ص 38 –39.
[46] – ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج 3 ص 518.
[47] – د. سعاد الحكيم، المعجم الصّوفي، ص 186. وانظر: الفتوحات المكيّة، سفر 1 فقرة 482.
[48] – ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج3 ص 47.
[49] – المصدر نفسه، ج 3 ص 47.
[50] – ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج 3ص 518.
[51] – جونبو لنجهورن، محاضرة في مؤتمر أينشتاين والله والزّمن، مركز إيانرامزي، جامعة أكسفورد، 2005.
[52]– النّسب الواردة في هذه الفقرة هي تقريبيّة، القصد منها توضيح الأكثريّة والأقليّة؛ لذا اقتضى التنويه.
[53]– ريتشارد فيلبس فاينمان، (1918م–1988م)، فيزيائي أمريكي معروف بإسهاماته في نظريّة الكم، وفيزياء الميوعة الفائقة وفيزياء الجسيمات، وبسبب إسهاماته في الكهروديناميكا الكميّة حصل على جائزة نوب لعام (1965م)، وساعد فاينمان في بناء القنبلة الذريّة في أثناء مشروع مانهاتن. انظر: بول ديفيز، الأوتار الفائقة، ص177.
[54]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ترجمة: د. سعد الدّين خرفان، وائل بشير الأتاسي، دار علاء الدّين، دمشق، ط1، 2001، ص157.
[55]– كارل ياسبرز، (1883م-1969م)، أحد فلاسفة ألمانيا المعدودين في القرن العشرين. ينتمي إلى التّيار المؤمن في الفلسفة الوجودية الثّالثة، وهي خط الوسط الّذي يجمع بين العقل والإيمان، والعلم والدّين. انظر: معجم أعلام المورد، منير البعلبكي، ص502-503.
[56]– د. محمد فتحي الشنيطي، المعرفة، دار الثّقافة للطّباعة والنّشر، القاهرة، ط5، 1981م، ص225 – 226.
[57]– آرثر شوبنهاور، (1788م-1860م)، فيلسوف ألماني، وتعلم في برلينوبينا، أخفق في أن يكون أستاذًا، فعاش يفكر. وله تأثير في الفلسفة وعلم النّفس إذ جعل الإرادة محور البحث. أهم كتبه: العالم إرادة وفكرة. انظر: معجم أعلام المورد، منير البعلبكي، ص264.
[58]– د. محمد فتحي الشّنيطي، المعرفة، ص 227.
[59] – د. يوسف حامد الشّين، الفلسفة المثاليّة – قراءة جديدة لنشأتها وتطوّرها وغايتها، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط1، 1998، ص400.
[60] – انظر: د. يوسف حامد الشّين، الفلسفة المثاليّة، ص402-407.
[61]– المصدر نفسه، ص83.
[62]– المصدر نفسه، ص176.
[63]– رودي روكر، فيلسوف وعالم الرّياضيّات وكومبيوتر الأميركي، عمل أستاذًا في جامعة ولاية نيويورك (1972م-1978م). انترنت.
[64]– نيل الدن أرمسترونج، (1930م) طيار أميركي ورائد الفضاء السّابق، وأستاذ جامعي. كان أوّل شخص يضع قدميه على سطح القمر. انظر: ويكيبيديا، انترنت.
[65]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص155.
[66]– المصدر والصّفحة نفسها.
[67]– المصدر نفسه، ص153.
[68]– كورت غودل، (1906م-1978م)، منطقي ورياضياتي وفيلسوف. ولد في برون في مورافيا فيما كان يُعرف باسم نمسا -المجر. صاحب (برهان غودل) الّذي ينصّ على أنّه: تُوجد، في نطاق أيما نظام رياضي منطقي صارم، مسائل لا يُمكن إثباتها أو نقضها على أساس من بديهيّات ذلك النظام، وإذاً فمن غير المؤكد إلّا تؤدي بديهيّات علم الحساب الأساسيّة إلى نشوء بعض التّناقضات، ولقد كان لهذا البرهان أثر عظيم في تقدّم المنطق الرّياضي. انظر: موسوعة المورد، منير البعلبكي، ص303.
[69]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص153.
[70]– بول ديفيز، فيزيائي نظري، أشرف في بداية السّبعينيّات على دراسات تبحث تخليق الطّاقة من العدم، انجز ما يزيد على المئة بحث، أعدّ لسنين عديدة برنامجًا لحساب هيئة الإذاعة البريطانيّة، ألّف العديد من الكتب، مثل: عوالم متعدّدة، عقل الله، عالم الصّدفة وغيرها. انظر: د. محمد باسل الطائي، دقيق الكلام، الرّؤية الاسلاميّة لفلسفة الطّبيعة، عالم الكتب الحديثة، أربد، الأردن، ط1، (2010م)، ص143.
[71]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص153.
[72]– روجر بنروز، (1931م)، فيزيائي رياضي بريطاني، حائز على مقعد روز بول للرّياضيّات في جامعة أكسفورد. اكتسب روجر بنروز شهرة واسعة نتيجة أعماله في النّسبيّة العامّة وعلم الكون، وهو أحد المساهمين مع ستيفن هوكينغ في صياغة نظريّة الثّقوب السّوداء، يتميّز بنروز كذلك بأنّه فيلسوف مؤيّد للمدرسة الواقعيّة في الرّياضيّات وهو كثيرًا ما أبدع أفكارًا خلاقة في الرّياضيّات من أهمها: مسألة التبليط الدّوري وغير الدّوري. انظر: روجر بنروز، العقل والحاسوب وقوانين الفيزياء، ص7.
[73]– روجر بنروز، العقل والحاسوب وقوانين الفيزياء، تصدير بقلم مارتن غارنر، ترجمة محمد وائل الأتاسي ود. بسام المعصراني، بالتّعاون مع المعهد العالي للعلوم التّطبيقيّة والتّكنلوجيّة، سلسلة الثّقافة المميّزة، العدد 13، دار طلاس للدّراسات والتّرجمة والنشر، دمشق، ط1، (1419هـ/1998م)، ص155.
[74]– مجموعة ماندلبرو: هي إحدى الأشكال الكسريّة المشهورة بشكل واسع حتّى خارج مجال علماء الرّياضيّات لتداخلها مع ما يدعى الفنّ الكسري حيثُ تعمد لتقديم صور فنيّة تتميّز بالجمال والتجريديّة. ما يميّز مجموعة ماندلبرو هو البنية المعقّدة الّتي تقدّمها على رغم بساطة تعريفها. انظر: موسوعة ويكيبيديا، إنترنت.
[75]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص154
[76]– مارتن غاردنر، (1914م-2010م)، أمريكي، كتب وشارك في تأليف ما لا يقلّ عن 800 كتاب في ميادين علميّة متعدّدة منها العلوم والفلسفة والمنطق واشتهر بالخصوص بكتبه في الرّياضيّات وفي الألعاب الفكريّة وقد ترجمت معظم مؤلّفاته إلى لغاتٍ عديدة. انظر: إنترنت.
[77]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص154
[78]– جون ديفيد بارو، (1952م)، أستاذ باحث في علوم الرّياضيّات في جامعة كامبريدج. انظر: -ويكيبيديا، إنترنت.
[79]– بول ديفيز، الله والعقل والكون، ص155
[80]– المصدر نفسه، ص82 – 83.
[81]– المصدر نفسه، ص83.
[82]– د. صلاح عثمان، النّموذج العلمي بين الخيال والواقع، المعارف، الإسكندريّة، ص62.
[83]– فريناند آلكييه، معنى الفلسفة، ترجمة: حافظ الجمالي، منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 1999، ص15
[84]– للمزيد انظر: أ. هـ. بيسون& د. ج. أوكنر، مقدّمة في المنطق الرّمزي، ترجمة: عبد الفتّاح ديدي، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، ص115.
[85]– مقال: مقدّمة عن الجينوم، أ.د ماهر محمد شحاته، مجلة العلوم والتّقنية، مجلّة فصليّة تصدرها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتّقنية، 2010، ال عدد97، ص12.
[86]– المصدر نفسه، ص 10.
[87]– المصدر نفسه، ص 10.
[88]– مقال: ذبابة الفاكهة، د. سحر أحمد الخواص، المصدر نفسه، ص19.
[89]– المقال والمصدر نفسه، ص19.
[90]– مقال: جينوم الفأر، المصدر نفسه، ص24.
[91]– المصدر السّابق، ص25.
[92]– المصدر السّابق، ص25.
[93]– مقال: جينوم الأرز، المصدر نفسه، ص22.
[94]– المقال والمصدر نفسه ص22.
[95]– مقال: جينوم قرد الشّمبانزي، د. محمد بن عوض الجوهي، المصدر نفسه، ص31.
[96]– مقدّمة عن الجينوم، أ.د ماهر محمد شحاته، المصدر نفسه، ص10.
[97]– المصدر والصفحة نفسها.
[98]– المصدر نفسه، ص10
[99]– للتّفاصيل أكثر انظر: القسم الثّاني – الفصل الثّالث – أنواع التّضامر -التّضامر المشترك.
[100]– ريتشارد ريستاك، المخّ الجديد (كيف يعيد العصر الجديد صياغة العقل)، ترجمة: عزّة هاشم أحمد، مراجعة وتقديم: فيصل عبد القادر يونس، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، القاهرة، 2010، ص20.
[101]– وهي باحثة من قسم علوم الحديث والسّمع بجامعة واشنطن.
[102]– أستاذ الكومبيوتر وعلم النّفس بجامعة كارنجي ميلون بالولايات المتّحدة الأمريكيّة.
[103]– ريتشارد ريستاك، المخّ الجديد، ص20-22.
[104]– المصدر نفسه، ص20.
[105]– المصدر نفسه، ص22 – 23.
[106]– المصدر نفسه، ص38.
[107]– المصدر نفسه، ص29.
[108]– المصدر نفسه، ص38
[109]– المصدر نفسه، ص35.
[110]– المصدر نفسه، ص39.
[111]– المصدر نفسه، ص43
[112]– المصدر نفسه، ص44-45.
[113]– المصدر نفسه، ص70
[114]– المصدر نفسه، ص71
[115]– المصدر نفسه، ص72 -73.
[116]– بشأن هذا المبحث أنصح بقراءة (الفصل الأوّل – المضمون الميتاكلينيكي للعلاج النّفسي) لما يتضمنه من تفصيلات مُهمّة. انظر: فيكتور إيميل فرانكل، إرادة المعنى-أسس وتطبيقات العلاج بالمعنى، ترجمة: د. إيمان فوزي، دار زهراء الشّرق، القاهرة، ص21-39.
[117]– فيكتور إيميل فرانكل، إرادة المعنى-أسس وتطبيقات العلاج بالمعنى، ص28.
[118]– المصدر نفسه، ص65
[119]– المصدر نفسه، ص30
[120]– المصدر نفسه، ص30
[121]– المصدر نفسه، ص33
[122]– المصدر نفسه، ص 38
[123]– المصدر نفسه، ص39
[124]– كارل غوستاف يونغ، دور اللّاشعور ومعنى علم الّنفس للإنسان الحديث، ترجمة: نهاد خياطة، المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والنّشر والتّوزيع، بيروت، 1992، ص5.
[125]– انترنت، ويكيبيديا.
[126]– انظر: سيغموند فرويد، الأنا والهو، إشراف الدّكتور محمد عثمان نجاتي، دار الشّروق، ط4، 1982، ص26.
[127]– كارل غوستاف يونغ، جدلية الأنا واللاوعي، ترجمة نبيل محسن، دار الحوار للنّشر، سوريّة، ط1، 1997، ص11.
[128]– جدليّة الأنا واللّاوعي، ص12.
[129]– المصدر نفسه، ص12.
[130]– كارل غوستاف يونغ، دور اللّاشعور ومعنى علم النّفس للإنسان الحديث، ص40.
[131]– المصدر نفسه، ص41، 69.
[132]– المصدر نفسه، ص68.
[133]– راجع: قراءة في النّطاق البيولوجي
[134]– كارل غوستاف يونغ، دور اللّاشعور ومعنى علم النّفس للإنسان الحديث، ص70 – 71.
[135]– المصدر نفسه، ص68-69.
[136]– المصدر نفسه، ص75.
[137]– المصدر نفسه، ص76-77.
[138]– المصدر نفسه، ص88-89.
[139]– Trusted, Jennifer, Physics and Metaphysics – Theories of Space and Time, Routledge, London and New Yourk, 1994, O.IX.
[140]– Cook, John W. Wittgenstein’s Metaphysics, Cambridge University Press, New Yourk, 1994, P 264.
[141]– سورة آلعمران: الآيات 169 -171.
[142]– سورة البقرة: آية 154.
[143]– سورة الأنفال: الآيات 17.
[144]– سورة البقرة: آية 163.
[145]– سورة طه: آية 14.
[146]– سورة الحجر: آية 9.
[147]– سورة يس: آية 12.
[148]– انظر: ابن عربي، فصوص الحكم، ج1ص104. وأيضًا: المعجم الصّوفي، ص955-960.
[149]– سورة الأنعام: آية 38.
[150]– سورة النمل: الآيات 16 -18.
[151]– آية الأنبياء: آية 69.
[152]– سورة النّمل: الآيات 38 – 40.
[153]– سورة البقرة: آية 252.
[154]– سورة الإسراء: آية 12.
[155]– سورة سبأ: آية 15.
[156]– سورة هود: آية 64.
[157]– سورة المؤمنون: آية 50.
[158]– سورة الجاثية: الآيات 4 – 6.
[159]– آلعمران: آية 7.
[160]– سورة المجادلة: آية 1.
[161]– سورة الشّورى: الآيات 1، 2.
[162]– سورة الأحزاب: آية 34.